#قراءات_نقدية
دراسة نقدية لقصيدة: “عفوا … لن أبيع شرفتي” للشاعرة إيمان أحمد يوسف يوسف
“شرفة المعنى وحدود الانعتاق”
بقلم: نور الدين طاهري
تمهيد:
تحضر القصيدة بوصفها فعلا رؤيويا يستقرئ الواقع من نافذة الحلم، ويشتبك مع قضايا العصر بأدوات الشعر لا الخطابة، فتنبجس من خلالها لغة شاعرية تمازج بين التأمل العميق والرمز الشفاف، وتستثمر تفاصيل صغيرة ـ كزيارة يمامة ـ لتبني عالما مضادا لما يثقل النفس من أزمات الواقع. من خلال ذلك، ترسم الشاعرة مشهدا شعريا فريدا، تجعله نقطة انطلاق لتأملات فكرية وجمالية، تخترق اللحظة وتعيد ترتيب علاقتها بالكون، بالذات، وبالقيم.
أولا: العنوان بوصفه عتبة نصيّة:
“عفوا… لن أبيع شرفتي” عنوان يفتح النص على أفقٍ دلالي كثيفٍ ومركب، يزاوج بين نبرة اعتذارية خافتة وقرار صارم لا يقبل التفاوض، مما يُولّد توترا هادئا بين رقة العبارة وحدّتها. يتأسس هذا التوتر على جدلية داخلية بين الظاهر والمضمر: ظاهرٌ يُبدي تراجعا أو لينا، ومضمرٌ يُفصح عن موقف حاسم، قاطع، لا رجعة فيه. فالشاعرة لا تبرّر رفضها إلا من باب اللياقة الشعورية، لكنها في العمق تُعلن تمردها على عالمٍ يُريد مصادرة مكمن حريتها الأخيرة.
الشرفة هنا، ليست مجرد عنصر معماري تابع لجسد البيت، بل كيان رمزي مشحون بطاقة وجدانية وروحية عالية، تتحوّل فيه الذات من كائن مأزوم بقلق الواقع إلى كائن متصالح مع كائنات الطبيعة، منفتح على أفق الجمال، قادرة على التأمل، الحلم، وممارسة الطقوس الصامتة للتنفس والكتابة والشفاء. إنها مرآة داخلية ترى فيها الشاعرة امتدادًا لذاتها الأعمق، حتى لتبدو وكأنّ التخلي عنها يعني اقتلاعها من جذورها، أو انتحارًا معنويًا يُصيب كينونتها في الصميم.
أما فعل “البيع”، فيحمل هنا دلالة تتجاوز المعاملة الاقتصادية، ليُلامس منطقة القيم والمبادئ. هو خيانة رمزية لمقدّس صغير، لحريّة شخصية، لحلم نقيّ ما زال يتشبث بالحياة رغم كل الضوضاء التي تخترق الجدران وتُثقل الروح. وفي هذا الرفض، تُبطن الشاعرة نقدًا صامتًا لعالمٍ ماديّ، عابر، يحوّل كل شيء إلى سلعة، حتى الأمكنة التي تتنفّس فيها الأرواح. وكأنها تقول: لن أستبدل لحظة تأمل صافية، أو تغريدة طائر على حافة الضوء، بضجيج السياسة، ولا بانهيارات العالم المتسارعة نحو الهاوية.
تتشكل هنا عتبة نصيّة تنبئ بموضوع النص وتُمهّد لرحلته الداخلية، رحلة البحث عن معنى في عالمٍ يزداد فراغًا. الشرفة تصبح المعادل الرمزي للقصيدة نفسها، للمكان الذي تنبثق فيه الرؤية، ويتكوّن فيه الجمال كقيمة مضادة للخراب. لا تُباع الشرفة، لأنّها ليست مساحة عينية فقط، بل هي مساحة معنوية تؤسّس لكرامة الذات الشاعرة، وحقّها في أن تختار مشهد الحياة من موقع التأمل، لا من موقع التورط في العبث.
بهذا المعنى، يتحوّل العنوان إلى عتبة بلاغية ـ فلسفية، تضع القارئ منذ اللحظة الأولى أمام سؤال وجودي: ما الذي تبقى لنا في زمن المساومات الكبرى؟ وحين تتشبث الشاعرة بشرفتها، فهي لا تدافع فقط عن مكان، بل عن نمط رؤية، عن موقف من العالم، عن انحياز للجمال في زمن القبح، وعن إصرار على أن تظلّ الذات أمينة لما تبقى فيها من صدق وصفاء.
ثانيا: المعجم الشعري وبنية التوتر:
يتأسس البناء الشعري في النص على حركية توترية تُنبئ عن صراع داخلي لا تهدأ موجاته، بين عالمين متقابلين: عالم يضجُّ بالألم، يثقل الروح، ويشدّها إلى قاع الهمّ العام، وعالم آخر شفاف، خفيف، يمنح الذات مساحاتٍ من الترفع، والنجاة المؤقتة من صخب الخراب. هذان العالمان يُترجمان في مستوى المعجم، الذي يتحوّل إلى ساحة لتصادم القيم والدلالات، مما يُضفي على القصيدة إيقاعًا باطنيًا من المراوحة، ويُضمر موقفًا وجوديًا عميقًا من العالم.
المعجم الأول، المتصل بالصفاء والسكينة، يستدعي حقولًا دلالية مرتبطة بالبساطة، الطهر، الطمأنينة، والاندماج في دورة الطبيعة. كلمات مثل “يمامة”، “شرفة”، “ذكر”، “عصافير”، “طبق الأرز”، “القمر”، “الجنة”، ليست مجرد مفرداتٍ وصفية، بل حوامل رمزية تُؤثث فضاء الهروب، أو بالأحرى “التحرر” من عوالق العالم السفلي. إنها إشارات لكونٍ بديل، أكثر نقاءً، يتحرك فيه الزمن لا وفق قوانين الأحداث، بل وفق نسق داخلي ينبثق من تأمل الذات للطبيعة، ومن مصالحتها مع جمال بسيط، غير متكلف، لكنه عميق.
أما المعجم الثاني، فهو ينتمي إلى لغة الإدانة، إلى مفرداتٍ توثق الثقل الكوني الذي ينهال على الوجود الإنساني. “الحرائق”، “الفيضان”، “الوباء”، “سد النهضة”، “المطهر”، “الكمامة”، هي صور لعالمٍ موبوءٍ، تنبعث منه روائح القهر والهلع. لا تكتفي هذه الكلمات بتمثيل وقائع مريرة، بل تُرسّخ في النفس شعورا بالاختناق، وتغذّي حالة من الاستلاب الوجودي، حيث يتراجع المعنى أمام طغيان الكارثة، ويتحول الكائن إلى مجرد متلقٍ سلبيٍّ لجراحات تتوالى بلا أفق.
غير أن الشاعرة لا تكتفي بوصف هذا التوتر، بل تبني عليه مبدأ التوازن الخلاق. تأتي “اليمامة” – بما تحمله من دلالة رمزية – لتكون نقطة التحوّل، الكائن الطلائعي الذي يخلخل هندسة الثقل، ويمنح الشاعرة ممرًا سرّيًا للخروج من شرنقة اليومي إلى فسحة الشعر. اليمامة ليست طائرًا فقط، بل طيف مخلّص، قديس شعريٌّ صغير يحفر نفقا نحو الضوء. إنها لحظة الارتقاء، التي تسمح بإعادة تركيب الذات، بأدلجة جديدة أكثر خفّة، وأكثر انفتاحًا على أملٍ جماليّ، مهما بدا واهنا.
في هذا السياق، تتحول المفردات إلى درجات سلمٍ تصعد عليه الذات الشاعرة من العتمة إلى الضوء، من الهشيم إلى الحلم. ليست المفردات هنا محايدة، بل مشحونة بطاقة شعورية، وظيفتها خلق مزاجٍ داخلي يتحول تدريجيا من الانفعال إلى التأمل، من الحيرة إلى الرؤية، ومن التشظي إلى التماسك. فالمعجم لا يظلّ على سطح اللغة، بل يخترق الأعماق، ليصبح مرآةً لصيرورة داخلية تتقاطع فيها الفكرة، والعاطفة، والنبرة.
إنّ التوتر في بنية المعجم ليس اضطرابًا، بل شكل من أشكال انتظام التناقض، إذ يتموضع كل عنصر في مكانه بدقة، ويُسهم في رسم خريطة شعورية معقدة، تعبر من خلالها الشاعرة عن أزمتها لا بالضجيج، بل بالتماهي مع كائن بسيط، هادئ، هو “اليمامة”، التي تتحول إلى وسيط شعري بين العالمين، وإلى مفتاحٍ رمزي لفهم القصيدة بوصفها مشروع خلاص ذاتي، لا ينفصل عن الرؤية الكبرى للوجود.
ثالثا: الصورة الشعرية والتمثيل الرمزي:
تنسج القصيدة عالَمها الصوري على نحو تفاعلي بين الرمزي والتجريدي، بين الحسيّ والميتافيزيقي، لتمنح المتلقي فسحة تأويلية تتجاوز المدلول المباشر، وتغريه بالبحث عن المقاصد الكامنة خلف التشكيل البلاغي. فالصورة في هذا النص لا تُختزل في كونها زخرفاً لغوياً، بل تتخذ صفة “الوسيط الكاشف”، تنقل الذات من معطى الواقع إلى أفق الرؤيا.
“اليمامة” في هذا السياق لا تُؤخذ بحرفية الوجود البيولوجي، بل تُضمر تمثيلاً رمزياً خالصاً. هي ليست مجرد طائر يحطُّ على الشرفة، بل تجلٍّ ناعم للسلام الداخلي، لنداء الكائن الفطري الذي يشدُّ الذات نحو النقاء. إنها صوت البراءة الذي لا يزال يقاوم، صورة مطهّرة للطبيعة وقدرتها على استنقاذ الإنسان من غرقه في الأسى. كل حركة تقوم بها اليمامة، من نقر الزجاج إلى تحريك العصافير حول طبق الأرز، تصبح طقساً رمزياً يُخرج الذات من الانغلاق الوجودي إلى انفتاح روحي. وربما كانت اليمامة، في بنيتها العميقة، استعارية للقصيدة نفسها، تلك التي تزور الشاعرة صباحاً وتوقظ فيها الحسّ والوعي معاً، وتعيد ترتيب الفوضى الداخلية بنَفَسٍ شعريٍّ شفيف.
أما العصافير، فهي محيط رمزي آخر يضفي على الصورة امتدادا في المعنى. ليست العصافير هنا مكمّلات جمالية، بل تُجسّد رفقة الروح، كائنات مصغّرة لجوقة الحياة البديلة، التي تتّسم بالخفة والحرية، والتي تملك من الذكاء الوجداني ما يكفي لفهم الإنسان في لحظاته الموجعة. وعندما “اجتمعت حول طبق الأرز وطبق الماء”، فالمشهد يتخذ بعداً شعائرياً، وكأن الذات تدخل طقس مصالحة لا مع الطبيعة فقط، بل مع وجودها المنهك أيضا. هذا الجمع بين الأرز والماء يبعث على رمزية الحياة الأولى: القوت والماء، البذرة والنبع، وكأن هذه العصافير تقيم “وليمة الوجود” في أبهى تجلياتها البسيطة.
أما صورة “الشرفة”، فهي بمثابة البؤرة التشكيلية التي تنتظم حولها الصور جميعًا. الشرفة، من حيث موقعها المكاني، تمثّل منطقة وسيطة: ليست في الداخل حيث الخصوصية والانغلاق، ولا في الخارج حيث الانكشاف المطلق؛ بل في مكان بينيّ يسمح بالتأمل، بالمراقبة، بالفهم الصامت. هنا تتحوّل الشرفة إلى “مقام فلسفي”، تتقاطع فيه الذات مع العالم، لكنها لا تنخرط فيه بشكل مباشر، بل تحتفظ بمسافة نقدية وتأملية. وهذه المسافة ليست عزلة، بل شكلٌ من أشكال النجاة، وممرٌّ إلى التجاوز.
إن هذه الصور، بما تحمله من شحنات رمزية، تُغني البنية الدلالية للنص، وتجعله يتحرك في أكثر من طبقة: من التجربة الحسية اليومية إلى الاستبطان الشعري، ومن توصيف الواقع إلى تجاوزه عبر الحلم والخيال. إنّ رمزية الصور ليست استنساخًا لنماذج تقليدية، بل إعادة تفكيكها وإعادة بنائها في ضوء رؤية الذات لذاتها وللعالم. ومن هنا، لا يعود المشهد مجرد وصف للحظة شاعرية، بل يتحوّل إلى موقف وجودي يُؤسّس لرؤية شعرية ترى في الكائنات البسيطة، الهادئة، طوق نجاة ضد جلبة الخراب، وفي الشرفة أفقًا لا يُباع، لأنها آخر ما تبقّى للإنسان من مساحة حرية.
رابعا: البنية الفكرية – بين النقد الاجتماعي والملاذ الوجودي:
يتبدّى العمق الفكري للقصيدة من قدرتها على التوازي بين الحلم والاحتجاج، بين الانخراط التأملي والرفض الرمزي، إذ لا تكتفي الشاعرة بإنتاج مشهدية شاعرية تُدغدغ الحس، بل تمارس من خلال تلك المشهدية فعلاً نقديًا إيديولوجيًا يمسّ جوهر الحياة المعاصرة. فكل ما يبدو عذبًا وهادئًا في النص، يحجب خلفه شحنة فكرية ناقدة، توجه السهام إلى نمط وجودي قائم على العبث، التفاهة، والانفصال عن الطبيعة.
القصيدة تُبنى من الداخل كفعل مقاومة، لكنها مقاومة غير صاخبة، بل هادئة، ناعمة، ذات طابع تأملي. حين تسرد الشاعرة أسماء الأزمات (حرائق بيروت، فيضان السودان، الوباء، سد النهضة،…) فهي لا تفعل ذلك كصحفية توثّق المآسي، بل كشاعرة تستشعر ثقل هذا الواقع في كيانها، وتتفاعل معه بوجدانها، لا ببرودة التحليل السياسي. هذه الأزمات لا تمرّ في النص كعناوين خارجية، بل كأحمال داخلية، كجراح فردية تتوحد مع الجرح الجمعي، ما يجعل من “الشرفة” ليست فقط نقطة مراقبة، بل موقعًا للتوتر الداخلي، وساحة فكرية لبلورة موقف.
وإذا كان الواقع بكل فصوله القاتمة يفرض على الإنسان منطق الاستسلام أو الغرق، فإن الشاعرة تقترح بديلا، وهو ما يمنح القصيدة قيمتها الفلسفية. إنها تنادي بالعودة إلى الأصل، إلى بساطة الكائن، إلى الحكمة التي تسكن الأشياء الصغيرة. اليمامة ليست فقط “رمزا للسلام” كما قد يبدو في الظاهر، بل هي علامة على البديل الذي يقترحه النص: الإنصات إلى نبض الحياة الطبيعي، إيقاف دوّامة “التقدّم المدمر”، ومساءلة مآلات الحضارة الحديثة التي نجحت في تطوير التكنولوجيا، لكنها فشلت في ترسيخ معنى الإنسان.
وتتحول هذه العودة إلى الطبيعة من مجرد موقف جمالي إلى موقف أخلاقي ـ وجودي. فالقصيدة، في عمقها، لا تحتفي بالعصافير والأرز والماء لأسباب رومانسية، بل لأن هذه الكائنات والموجودات البسيطة هي التي لا تزال تحتفظ بسر الوجود، بمفتاح الصفاء. ومن خلال هذا، تصبح القصيدة دعوة للإنسان الحديث كي يعيد التفكير في أولوياته: هل التكنولوجيا تُنتج المعنى؟ هل التقدم يقود إلى السعادة؟ أم أن في أبسط المشاهد ـ كحضور يمامة على الشرفة ـ من الحكمة والبصيرة ما يكفي لتقويض كل النماذج الحضارية المبنية على الاستهلاك والعزلة والصرامة؟
وحين تقول الشاعرة في النهاية إنها “لن تبيع شرفتها”، فهي تعلن ـ من خلال صيغة الرفض ـ موقفًا مصيريًا. لا يتعلق الأمر بمكانٍ مادي، بل بموقف كينوني: رفض التفريط في المساحة الأخيرة التي تسمح لها بالتماهي مع العالم، بالتأمل، بالتفكّر، بالانتماء إلى الذات، لا إلى ما يفرضه الخارج من صخب وتعليب. هي “لن تموت قبل موتتها” لأنها اختارت أن تحيا خارج البرمجة اليومية، في مساحتها الحرة، في فسحتها الفكرية، في بُعدها الذي يؤمن بالجمال والخير والعدل. هذه القيم التي لا تعود شعارات، بل رؤوس أعمدة تؤسّس من خلالها الشاعرة جمهورية شعرية ـ أخلاقية، قريبة من تصوّر أفلاطون، حيث الحكمة تقود، والفن يوجّه، والإنسان يستعيد جوهره الأول.
بهذا، تتحول القصيدة إلى موقف، ويتحوّل الشعر إلى ملاذ لا يكتفي بتجميل الخراب، بل يعمل على تجاوزه عبر التخييل، عبر الحلم، عبر تأكيد أن النجاة لا تكمن في الفرار، بل في إعادة بناء العلاقة مع العالم على أسس جديدة. وهذه العلاقة تبدأ من الشرفة، وتمتد حتى محراب الفكر، حيث تصير القصيدة نفسها يمامة.
خامسا: اللغة وبنية الإيقاع الداخلي:
اللغة في هذه القصيدة ليست مجرّد وسيلة نقل للمعنى، بل هي الكيان الحيّ الذي يتنفس عبره النص، ويُشيّد فضاءه الوجداني والمعرفي. فهي لغة تكتب ذاتها من الداخل، لا من مرجع خارجي أو نموذج مسبق. ليست زخرفاً لفظياً ولا تعبيراً مكروراً، بل بنية متوتّرة، تشتغل على الحافة: حافة الشعر، وحافة الفكر، وحافة التجربة الذاتية. تنأى عن التكلّف، وتُراهن على البساطة اللامرئية التي تُخفي تحت سطوحها عمقا دلاليا مركّبا.
اللغة هنا منفتحة على اليومي، ولكنها لا تغرق في المباشرة؛ تلامس الأشياء كما هي، لكنها تزرع فيها أبعادًا رمزية. حين تذكر الشاعرة “رائحة المطهّر”، “الكمامة”، “الصحف”، فهي لا تصف عالمًا خارجيًا فقط، بل ترسم حدودًا للواقع المتشظّي، وتقدّم هذه المفردات كعناصر ضمن شبكة دلالية أوسع، تضع الإنسان المعاصر في مواجهة مع تعقيد عالمه. بهذا المعنى، تصبح كل كلمة “علامة”، وكل تركيب “نبضاً” من نبض القصيدة الداخلي.
الإيقاع في النص لا يعتمد على العروض الكلاسيكي، بل يتأسّس على توزيع النَفَس، وعلى إحساس داخلي بالموسيقى، نابع من التجاور بين الجمل القصيرة، والتراكيب الاسمية المكثّفة، والفعلية التي تمنح النص ديناميكية ذات منحنى تعبيري متصاعد. تتوالى الجمل كما لو أنها أمواج شعورية، تأتي وتنسحب، حاملة في كل مرة نغمة وجدانية مختلفة، فتارة تميل إلى السكينة، وتارةً إلى التوتر، وتارةً إلى التهكم الرقيق.
الوقفات الكثيرة، والنقاط والفواصل، لا تُعطّل الإيقاع، بل تُعيد تشكيله، وتمنحه بنية تأملية. كأننا بإزاء نص يتنفس: يلتقط أنفاسه، يتأمل، ثم ينطلق من جديد. هذه التقنية تُقارب البنية الموسيقية في السيمفونيات، حيث الصمت جزء من النغمة، وحيث التدرج هو أداة بناء لا محض فاصل.
ومع هذا الإيقاع الداخلي، تتولد في القصيدة حركة سردية خفية، تمنحها طابعاً شبه درامي. فليست القصيدة وقوفًا عند نقطة شعورية واحدة، بل تحوُّل داخلي مستمرّ، تتحرك فيه الذات عبر مشاهد، عبر حالات، عبر مواقف. هي قصيدة “مناجاة” لكنها أيضًا “محاججة”، قصيدة “تأمل” لكنها كذلك “احتجاج”، وهذا التداخل لا يمكن أن يُبنى إلا بلغة تستجيب لكل هذه الموجات، وتملك من المرونة ما يسمح لها بأن تكون متعدّدة الطبقات في آن واحد.
إنّ الشاعرة لا تلعب باللغة، بل تُحاورها، تُراوغها، تُطوّعها لتُحاكي توتر الوجود وتعدد التجربة. لذلك يبدو أن الشعرية هنا لا تأتي من زخرفة أو مجاز فحسب، بل من جرأة الاختزال، من قوة الصمت بين الكلمات، من صدق النبرة، من كثافة الشعور، ومن بنية لغوية تُبقي المتلقي على حافة الاكتشاف الدائم، في انتظار ما لا يُقال، بقدر ما يتلقّى ما يُقال.
خاتمة:
“عفوا… لن أبيع شرفتي” ليست قصيدة مناسبات أو بوح ذاتي عابر، بل نص رؤيوي يندرج في شعر التأمل والمقاومة الهادئة. فيه تنحاز الشاعرة إلى ما هو إنساني، بسيط، طاهر، مقابل ما هو صاخب، قاسٍ، ومجرد من المعنى.
القصيدة تقترح إعادة تعريف للانتماء، ليس إلى الوطن الجغرافي فقط، بل إلى الوطن الرمزي، حيث تكون “اليمامة” هوية، و”الشرفة” حريّة، و”القصيدة” خلاصاً. وهي بذلك تندرج في مسار شعريٍّ ملتزم، لا يرفع الشعارات، بل يفتح نوافذ الجمال في وجه القبح العالمي.
تنهي الشاعرة نصها باعتراف وجودي ـ شعري: لن أبيع شرفتي…
إنه إعلان بقاء، وتمسك بالحق في الحلم، ولو داخل مساحة لا تتجاوز حدود النافذة.
——-
المرجع :
عفوا …لن أبيع شرفتي
الشاعرة إيمان أحمد يوسف مصر
تزورني يمامةٌ
استضيفُها على شرفتي
تنقرُ الزجاجَ لتمنحَني الإشارةَ
عيُنُها تُخرجُني من صخَبي
تخترقُ الوقتَ
خلفَها الشّجرُ والسحابْ
تهمهمُ اذكروا ربَّكُم
فأشاركُها الذِّكرَ
أتركُ الجريدةَ من يدي
وفيضانَ السودانْ .حرائقَ بيروت.
مشكلاتِ الوباءْ . سدَّ النهضةِ.
حساباتِ الواقعِ
مشكلاتٍ تؤرِّقني
تشعرُ بي اليمامةُ
تأخذُني فأنجذبُ إليها
ولأصدقائِها العصافيرِ
اجتمعتْ
حول طبقِ الأُرزِ
وطبقِ الماء
رفرفَ القلبُ
ورفرفتْ الروحْ
جعلتني أبتسمْ
أحتمي .أجمعُ انقساماتي واتحدْ
أعدلُ أيديولوجياتي
أخرجتني من عنقِ الزجاجةِ
إلى مسرحِ الأمكنةِ
حضورٌ أسطوريٌّ
في الهواءِ الطلقِ
تحمِلُهُ الشمسُ
كلَّ صباحٍ
نسيجاً من رؤى الجنةِ
لوحةً لمدينةٍ فاضلَةٍ
لا تحكمُها تكنولوجيا الآلاتِ
ولا شرورُ البشرِ
طيوراً تناجي الطبيعةَ
تفتحُ الأبوابَ
لفيلمٍ سينيمائيٍّ
يحققُ سعادةَ الجموعِ
تتناسى معهُ
مشاكلَ الكرةِ الأرضيةِ
تتسامى فوقَ الأحداثِ
تُحقِّقُ نظرياتِ :
الخيرْ .العدلْ .الجمالْ
أخيرا …
أنفلتُ من الأيامِ الثقلةِ
مع جهازِ الاختبارِ الحسيِّ
أقرأُ المستقبلَ
في محرابِ الفكرِ
يشاركُني الليلُ
ويأتي القمرُ
نفكّرُ سويّا
يأسرُني .يهديني .يأمُرُني
أنْ أعتررفْ
عفوا …
مهما نختلفْ
لن أبيعَ شُرفَتي
لن أخونَ يمامتي
لن أموتَ قبلَ موتتِي
ولكم محبتي
سئمتُ الغيامةَ.القتامةَ .الصحفْ
رائحة المطَهِّرِ والكمامةْ
الصرامةَ والسخفْ
سابقى هنا …
انتظرُ الصباحَ
وصديقتي اليمامةْ
ولن أبيعَ شرفتي …!


















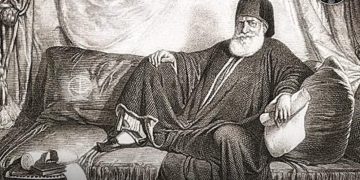




















Discussion about this post