#دراسة_نص
“صعود الذات وانغماسها في أبعاد الوجود: دراسة في الشعر الصوفي والوجداني في قصيدة ( صاعدًا لا أرتوي) ” للشاعر الحسن الكَامح
بقلم نور الدين طاهري
النص الذي بين أيدينا ينتمي إلى تيار الشعريات الصوفية ذات النزعة التأملية، حيث تتخذ الذات الشاعرة موقعا متأرجحا بين الصعود والانحدار، بين الاحتراق والتطهر، بين الظمأ والارتواء، في مشهد يزاوج بين الرؤية الكونية والقلق الذاتي، بين الانفصال عن العالم والتجذر فيه، في تداخل يذكرنا بالحلاج وابن الفارض ومواقف التصوف التي تحاول الإمساك بالمطلق عبر اللغة والإيقاع والصورة الشعرية.
لا يُقرأ هذا النص بوصفه مجرد قصيدة تحتفي بالتصعيد والارتقاء، بل هو رؤية ذاتية كونية تتشابك فيها المعاني الصوفية بالتجربة الوجودية، في تداخلٍ يجعل من الشعر أداة للبحث عن الحقيقة. هذه الرحلة، التي تخوضها الذات الشاعرة، ليست عبثية ولا خاضعة لمنطق مألوف، بل هي سيرورة تتسم بالقلق.
منذ المطلع، تتجلى ثنائية الجحيم والجنة، وكأن الذات محكومة بهذا التأرجح الذي يأخذ طابعا وجوديا يعكس مسيرة الإنسان في بحثه عن الخلاص. “صاعدا مِنْ جَحيم الذَّاتِ / إلى جِنانِ الرُّقِيِّ وَحيدًا”، هذه الثنائية لا تحصر الصعود في بعد مادي أو جسدي، بل تمنحه بعدا روحيا، إذ إن الجحيم ليس مكانا فيزيائيا، بل هو الذات نفسها، بآلامها وصراعاتها، والجنان ليست جغرافيا، بل هي رقيٌّ متعالٍ. بيد أن هذا الصعود لا يُشبع الذات، فالسعير يلتف حولها، والعطش يظل رفيقها، في إشارة إلى عطش وجودي لا يُطفأ بماء ولا بموج البحر. إنها حالة من الظمأ الذي لا يرتوي، وكأن الشاعر يستدعي صورة سيزيفية، ويحمل صخرة الأنا على كتفه، مسكونا بنار التجربة.
يتكرر الحضور البصري القوي عبر توظيف صور تخلق تناظرا بين الواقع والتجريد، فالشاعر يبحث بين الغيمات عن وجه يشبهه، يبحث بين النجوم عن ضوء ينير مساره، لكنه في النهاية لا يجد إلا نفسه، موزعا بين شعاع الشمس، مقتبسا المستحيل، في صورة تتلاقى مع الحيرة الصوفية، إذ المعرفة لا تكون إلا في ذروة التجربة، وحيث الحقيقة ليست قابلة للقبض عليها، بل تظل في حالة تملص دائم.
التوتر بين الذات والصعود يبرز في تمثل المكان، فالشاعر “نافِرٌ مِنِّي / إلى بلادِ الغيْبِ لا علمَ لي بها”، هنا تتعزز الفكرة الصوفية للرحيل عن الذات بحثا عن مطلق يتجاوزها، وكأنها رحلة الحلول في عالم لا تُدركه الحواس، لكنها في الوقت ذاته محفوفة بالمجهول، والجحيم والمجهول يتداخلان، وحيث البحث عن الظلّ المفقود يعكس تجربة روحية عميقة.
الصورة الصوفية تكتمل حين يقول: “أنا الماكِثُ / بَيْنَ الماءِ والنَّار / عَلى صِراط الأنا”، فالماء والنار كقوتين متضادتين يشكلان عالمه الداخلي، في انقسام يذكرنا بالبعد العرفاني الذي يرى في الحياة مسرحا للتجاذب بين الأضداد، لكن الأهم أن الصراط ليس خارجيا، بل هو صراط الذات نفسها، فهي التي تمشي خمسين عاما بين نفسها وبينها، دون استقرار، وكأنها محكومة بالتيه الأبدي الذي يتصاعد بها لكنه لا يوصلها إلى يقين نهائي.
هذا التوتر يظهر أكثر حين يعلن الشاعر زُهده في العلى، رغم أنه لا يكف عن التطلع إليه. “أنا الزَّاهدُ فِي زاويا العُلى / تَسْتَهْويني آياتُ اللَّه، وهنا يظهر بعد آخر، فالزهد ليس نفورا مطلقا، بل هو انجذاب مشروط، إذ إن الاستهواء لا يكون إلا لما لا يُمتلك، وكأنه يرى في العلى قمة لا يمكن له إلا أن ينظر إليها دون أن يستحوذ عليها.
مع تقدم النص، تتعزز هذه الثنائية بين الرغبة في الصعود والانفصال عن الدنايا، حيث تتحول اللغة إلى فعل مقاومة ضد الانحطاط الأرضي، “منْ مدنِ العَطَش / إلى جنانِ رَبِّي أسوقُ أمامي غَنَمَ الْحُروفِ”، فالحروف ليست مجرد أدوات لغوية، بل تتحول إلى كائنات تسير أمامه، في إشارة إلى أن الشعر نفسه أداة الصعود، وأن الكتابة ليست مجرد تعبير، بل هي سُلَّمٌ إلى المطلق.
الزمن في هذا النص لا يخضع لخطية نمطية، فالشاعر لا يستبق زمانه، ولا زمانه يسبقه، لكنه أيضا لا يتأخر، بل يسير مع ظله في تناغم غريب، وهذا الزمن الشعري لا يحاكي الزمن الواقعي، بل يصنع زمنه الخاص، والزمن يسقط حينا ويعلو حينا، وحيث “من حينٍ لِحينٍ الشَّمْسُ عَنَّا تَخْتَفِي”، وكأن الضوء نفسه ينسحب أحيانا، في إشارة إلى لحظات التجلي والاحتجاب التي يعيشها المتصوف في تجربته الروحية.
الصعود هنا ليس مجرد حركة نحو الأعلى، بل هو مجاهدة، “صاعِدًا وَحيدًا شَريدًا مُجاهِدًا فِي ذاتي”، وتتحول الذات إلى ساحة حرب، إذ لا وصول إلى العلى إلا عبر هذا الجهاد الداخلي، وفي هذا السياق، نجد أن الذات تُنادي أمها كي تفكّ قيدها، في إحالة إلى البعد النفسي العميق الذي يجعل التحرر عملية معقدة لا تكتمل إلا عبر القطيعة مع كل ما يربط الذات بقيودها القديمة.
المفارقة أن هذا الصعود لا يلغي العاصي في الشاعر، فهو في النهاية “العاصي فِي الدُّنْيا / المائلُ المُمِلُّ العاري المُعَطَّلُ”، وهي صورة تُحطم أي مثالية يمكن أن تُقرأ في النص، إذ إنه رغم هذا السعي المتواصل نحو العلى، لا تزال الذات متلبسة بنقصها وعجزها، وهذا ما يجعلها أكثر إنسانية وأقرب إلى طبيعة الإنسان الباحث عن كمال لا يدركه.
لكن هذا العاصي لا يتجه إلى الطهر كضرورة دينية، بل كخيار وجودي، “بلْ صَوْبَ ماءِ الطُّهْرِ أمْضي / وَلا غَيْرَ الطُّهْر أرْتَضي”، فهو لا يبحث عن خلاص تقليدي، بل عن شكل من الصفاء الذي يجعله يرتقي. إنه يريد أن ينجو لا لينغمس، بل لينسلخ عن المألوف، متجاوزا الزمن والتجاعيد والشيب، حيث الماضي ليس عبئا بل حلما، والبياض ليس غيابا بل امتلاء.
تنتهي الرحلة أين بدأت، بالصعود الذي لا ينتهي، بالظمأ الذي لا يُشبع، وكأن النص يعيدنا إلى نقطة البداية، والرحلة لا تكتمل، وحيث الذات تظل في حركة دائمة، في انجذاب إلى ما هو أبعد منها. هكذا، يقدم لنا الشاعر الحسن الكامح تجربة شعرية تتداخل فيها الأبعاد الصوفية، الوجودية، والفنية، في نص لا يُقرأ فقط، بل يُعاش بكل ما فيه من قلق وتوق وتوتر.
في تأمل هذا النص، نجد أنفسنا أمام تجربة شعرية مكثفة، تمتزج فيها أبعاد روحية وفكرية ولغوية، تتداخل بشكل يجعل المعنى غير ثابت، بل يتشكل ويتحول كلما أعدنا قراءته. إنها ليست مجرد قصيدة تصف حالة وجدانية، بل هي شهادة على صراع داخلي بين الذات وما هو متجاوز لها، بين الرغبة في العلو والإحساس بثقل الواقع، بين العطش المستمر والماء الذي كلما اقترب منه الشاعر بدا أبعد. إن هذه الثنائية لا تقف عند مستوى الخطاب، بل تتجذر في بنية النص ذاته، ويتخذ من المفارقة أساسا للتعبير عن حالة إنسانية قلقة، لا تعرف الاستقرار ولا تبتغي الوصول، بل تجعل من البحث غاية في ذاته، ومن الحركة المستمرة وسيلة لتجاوز الثبات.
الصعود الذي يتكرر في النص لا يعبر عن فعل فيزيائي بقدر ما هو تجسيد لحالة وجودية. فالشاعر لا يصعد نحو نقطة معينة، بل يصعد لمجرد أن الصعود هو قدره، وهو الهاجس الذي يحركه ويدفعه إلى الأمام، حتى وإن كان يعلم أن النهاية قد لا تكون مختلفة عن البداية. هذا الصعود مقترن بالعطش، وكأن الوصول إلى القمة لا يعني الشبع، بل ربما يفاقم الإحساس بالحاجة. فالشاعر يسير في طريق لا نهاية لها، محملا بحمولة ثقيلة من التساؤلات والشكوك، متنقلا بين نقيضين دائمين، بين الماء والنار، بين الرغبة في التطهر والانجذاب إلى الأرض، بين الانتماء إلى العلو والانجذاب نحو الأسفل.
اللغة التي يعتمدها الشاعر ليست مجرد وسيلة للتعبير عن هذه التجربة، بل هي جزء منها، إذ تتخذ في بعض الأحيان طابعا تصويريا يُقرّب التجربة إلى الذهن، وفي أحيان أخرى تبدو وكأنها تتجاوز المعنى المباشر، فتتحول إلى إشارات تحتاج إلى تفكيك وتأويل. هذا التداخل بين الصورة والمعنى يمنح النص بعدا رمزيا، يجعل من الكلمات ذاتها كائنات حية، تصعد وتهبط، تتغير وتتشكل، كما لو أن اللغة تعيش التجربة ذاتها التي يمر بها الشاعر.
الصراع مع الذات حاضر بقوة، حيث لا يظهر الشاعر في صورة المنتصر، بل يبدو في حالة مجاهدة دائمة، يدفع نفسه إلى أقصى الحدود، لكنه في الوقت نفسه يظل مشدودا إلى إحساس بالعجز، إلى وعي بأن هذا الصعود قد يكون بلا جدوى، لكنه رغم ذلك يستمر. هذه المجاهدة الداخلية ليست فقط رفضا للسكون، ولكنها تعبير عن موقف وجودي يرى أن الحياة لا تتحدد بوصول معين، بل في حركة لا تتوقف، وأن الاكتمال ليس غاية يمكن تحقيقها، بل هو حلم يتجدد كلما اقترب منه صاحبه.
الرمزية الصوفية في النص لا تأتي من مفردات دينية أو إشارات مباشرة، بل من طبيعة التجربة ذاتها، حيث البحث عن معنى يتجاوز المحسوس، والرغبة في الاتصال بما هو أعلى، والخروج من دائرة الذات إلى أفق أرحب، حتى وإن كان هذا الأفق نفسه غامضا وغير محدد. الشاعر هنا لا يسعى إلى فناء الذات كما في التجربة الصوفية التقليدية، بل هو ممزق بين التمسك بها والرغبة في تجاوزها، بين النزوع إلى التحليق والوعي بحدود الجسد، بين الرغبة في النقاء والشعور بالثقل الذي يجذبه نحو الأرض.
هذه الثنائية لا تبقى مجرد فكرة في النص، بل تظهر في التراكيب اللغوية، وتتجاور المفاهيم المتضادة في صور متتابعة، تعكس هذا التوتر الداخلي. فهو يصعد لكنه لا يصل، وهو في حالة عطش لكن الماء لا يرويه، وهو يتجه نحو العلو لكنه يظل مشدودا إلى الأرض. كل هذه التناقضات لا تطرح إجابة، بل تفتح مجالا للتأمل، تجعل القارئ جزءا من التجربة، ويجد نفسه متورطا في هذا البحث، متسائلا عن جدوى الصعود، عن معنى العطش الذي لا ينتهي، عن العلاقة بين الرغبة في الاكتمال والإحساس بالنقص المستمر.
في هذا السياق، لا يمكن التعامل مع النص على أنه مجرد بوح شخصي، بل هو تجربة إنسانية عابرة للزمان والمكان، تتحدث باسم كل من وجد نفسه في هذا الصراع، بين الرغبة في تجاوز حدوده والخوف من المجهول، بين البحث عن معنى والاستسلام للعدم، بين الانجذاب نحو العلى والشعور بثقل الحياة. الشاعر هنا ليس فردا، بل هو صوت ينطق بحالة عامة، يجعل من ذاته نموذجا لصراع لا يخصه وحده، بل هو صراع كل من وجد نفسه في مواجهة سؤال الوجود، وسؤال المصير، وسؤال الغاية التي قد لا يكون لها جواب.
هذه الرحلة التي يقدمها النص ليست خطية، بل هي أشبه بدائرة، إذ يبدأ الشاعر من نقطة العطش، ويعود إليها في النهاية، لكن العودة ليست إلى النقطة ذاتها، بل إلى إحساس جديد بهذا العطش، إلى وعي أعمق بأنه لن ينتهي، وبأن الصعود، مهما طال، لن يصل إلى نهاية مطلقة. وهكذا، يبقى النص مفتوحا، لا يقدم حلا، بل يضع القارئ في مواجهة إحساس متجدد بالحيرة، ويدعوه إلى التأمل، لا في معانيه فحسب، بل في معاني الحياة ذاتها، حيث كل إجابة تفتح بابا لسؤال جديد، وكل صعود يقود إلى عطش آخر، في دائرة لا تنتهي، لكنها في ذاتها قد تكون المعنى الوحيد الممكن.
—–
المرجع
صاعِدًا لا أرْتَوي
الحَسَن الكَامَح شاعر من المغرب
صاعِدًا مِنْ جَحيم الذَّاتِ
إلى جِنانِ الرُّقِيِّ وَحيدًا
والسَّعيرُ يَلُفُّني ولا أرْتَوي
لا ماءَ فِي المَدى يَرْويني
لا مَوْجَ فِي البَحْر يُطهِّرُني
صاعِدًا أحْمِلُ صَخْرَةَ الأنا
عَلى كَتِفِي وبالنَّار أكْتوي
أبْحَثُ بيْن الغَيْماتِ المُشْرقاتِ
عنْ وجْهٍ يُشْبِهُني
عَساهُ يَفُكُّ قيْدًا عُمْرًا يُلازِمُني
أبْحَثُ بَيْنَ النَّجْماتِ البَعيداتِ
عَنْ ضَوْء يُنيرُني
عَساهُ يُزيلُ الظُّلُماتِ عَنِّي
أنا المُوَزَّعُ بيْنَ أشعَّةِ الشَّمْس
أقْتَبِسُ المُسْتحيلَ
مِنْها وَلا بِشُعاع واحِدٍ أحْتَوي
أنا النَّافِرُ مِنِّي
إلى بلادِ الغيْبِ لا علمَ لي بها
بين جَحيمِ الْمَجْهولِ
كيْ أعانِقَ ظِلا
ضاعَ ذاتَ لَيالٍ مِنِّي
فاسْتوى فِي المَدى بَدْرًا وفِيَّ لمْ يسْتو
أنا الماكِثُ
بَيْنَ الماءِ والنَّار
عَلى صِراط الأنا
أمْشي خَمْسين عامًا بَيْني وبَيْني
ولا أسْتَقِرُّ إلا فِيما يُعَلِّقُني عالِيًّا
ولَوْ أنهُ بي يَوْمًا قدْ يَهْوي
أنا الزَّاهدُ فِي زاويا العُلى
تَسْتَهْويني آياتُ اللَّهِ
فِي الكِتابِ وفِي المَدى
لكنْ فِيما مَلَكَتْ نَفْسي لا أسْتَهْوي
صاعِدًا …
منْ مدنِ العَطَش
إلى جنانِ رَبِّي أسوقُ أمامي غَنَمَ الْحُروفِ
وعَلى عَرْشِها بَيْنَ الغُيوم أصْطَفِي
لا شَيْءَ يَمْنَعُني مِنْ الصُّعودِ إلى العُلى
لا شَيْءَ يَجْلُبُني لِهَذا التَّحْتِ
منْ زَرابِي مَبْثوثَةٍ عَلى جَنَباتِ الرَّوابي
والعَيْنُ إلى العُلى، تَقْتَفِي
صاعِدًا…
لا أسْتَبِقُ الزَّمانَ زَماني
وإنْ خَرَّ مِنِّي زَماني
لا أنا مُتَخَلِّفٌ للوَراءِ خَلْفَ ظِلِّي
وَلا ظِلِّي يَسْبِقُني فِي مَكاني
نَمْشي سَوِيًّا فِي طَريق العُلى
ومِنْ حينٍ لِحينٍ الشَّمْسُ عَنَّا تَخْتَفِي
صاعِدًا وَحيدًا شَريدًا مُجاهِدًا فِي ذاتي
منْ جَحيمِ الْحُروبِ والتَّعارُض
إلى جِنانِ رَبِّي لأرتْوي
فَفُكِّي قَيْدي أمِّي وَدَعيني
أسيرُ فِي اتِّجاهِ رَبِّي
عَساني أنْسى ذَنْبي
وإنْ كُنْتُ فِي دُنْيايَ بنِعْمَتهِ أنْتَشي
أنْتَشي وأنْتَشي حَدَّ إقْصاءِ ذاتي
مِنْ خَيْراتٍ عَلَى طُول طَريقِ
تَبْدو لي لَكِنِّي بِها لا أشي
لا خَيْرَ فِيَّ أنا الصَّاعِدُ
إنْ لمْ أرْكَبْ سَفِينَةَ الَّلهِ
وإلى جِنانِهِ العُلْيا أرْتَقي
لا خَيْرَ فِيَّ أنا الصَّاعِدُ
إنْ لمْ أعانِقْ سَيْفَ المُسْتحيلِ
ومَغْفِرَةَ رَبِّي أتَّقي
أنا العاصي فِي الدُّنْيا
المائلُ المُمِلُّ العاري المُعَطَّلُ
لا أبْغي شَيْئًا مِنَ الدُّنى، وبها لا أكْتَفِي
بلْ صَوْبَ ماءِ الطُّهْرِ أمْضي
وَلا غَيْرَ الطُّهْر أرْتَضي
لا مُبالِيًّا بالعُمْر يَنْقَضي
لا بِالتَّجاعيدِ تَرْكَبُ وَجْهي
والشِّيبُ يَحْتوي شِعْري
أنا الماضي المُنْقَضي بالْحُلْم أرْتَضي
أنا العاصي المُذِلُّ
المُنْهارُ بَيْنَ مَلَذَّاتِ الْحَرْف والكَلِماتِ
المُوَزَّعُ بَيْنَ الذَّاتِ والقَصيدات
المُنْغَمِسُ فِي غَياهِبِ الاهْتِزازاتِ
لا أرْضى لي بِغَيْر العُلُوِّ فِي الْخُلُواتِ
ولا أرْضَ لي تُسْقى بِحِبْر العُمْر غيْرَ بَياضٍ
يَحْمِلُني إلى الرَّمَق الأخير ثُمَّ يَلُفُّني إذْ يوْمًا سَأنْقَضي
البيضاء: 20 فبراير 2016
مقطع من قصيدة: “صاعدا لا أرتوي”
من الاهتزاز العاشر: “صاعدا لا أرتوي” سيرة متصوف 2019 عن مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والأتصال


















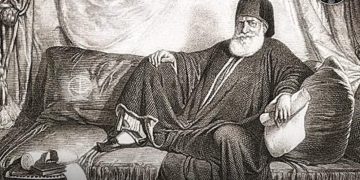




















Discussion about this post