* من رواية(ملح السّراب)/7/
مصطفى الحاج حسين.
كان (سمعو) جارنا في الزّقاق، صديق أبي يناهز الأربعين، وهو يعرف القراءة والكتابة، لذلك عرضت عليه أن يعلّمني كتابة اسمي بعد أن غدت صداقتي مع ابن عمي (سامح) مستحيلة، بسبب ماجرى من قتل أبيه بسببي، وزواج أبي من أمّه (أم عص) كما تسمّيها أمي.
وكان(سمعو) هذا عازفاً عن الزّواج مذ كان يافعاً، وهو كثير الشتم للنساء، يعدّهن مخلوقات تافهات لايستحقن سوى عود ثقاب، ولم نكن نحن الصبية نعرف سبب كرهه الشّديد لهنّ .
وكان أهالينا يحذرونا من التّوقف مع (سمعو)، فهو كما يزعمون، وسخ ونذل، ولم نكن ندري أي نذالة بقصدون، حتى أبي صديقه وشريكه في تعاطي الكحول والحشيش، ضربني بشدّة عندما أبصرني ذات مرّة أقف معه، وأمرني ألّا أعود للوقوف والحديث مع هذا الحقير .
وكثيراً ما كنت أتسأل لماذا يكثر والدي إذن من زيارته مادام يراه كذلك ؟!.. ومع كلّ هذا، ومن شدّة لهفتي للتعلّم، طلبت منه أن يعلّمني القراءة والكتابة سرّاً ودون أن يعلم أبي، فوافق (سمعو) في الحال، وطلب منّي أن أتسلّل بعد العشاء إلى داره، حتى يباشر تعليمي، وكنت أستطيع ذلك طبعاً، خاصة بعد زواج أبي من (نجوى) زوجة عمّي القتيل، أمّ (سامح)، فأبي ينام في دارها، وليس هناك غير تهديدات أمي، وعدم احتمالها لتصرفاتي.. وهذا أمر سهل.
في المساء لم أطرق باب (سمعو) كان موارباً، دفعته وخطوت نحو العتبة، وكان يقف بانتظاري مرحباً بي:
– أهلاً (رضوان)، كنت أعلم أنّه أنت.. تفضّل.
خطوت في باحة الدٌار التّرابية الواسعة، بينما كان (سمعو) يقفل الباب خلفي، تسلّل شعور بالوحشة والخوف إلى قلبي، فهذه الدّار الكبيرة ليس فيها أي دليل على الحياة، فلا شجرة ولا نبتة صغيرة فيها.
وساقني إلى غرفته، كانت واسعة مصقولة الأرضيّة بالاسمنت الأسود، جلست على حافة العتبة المرتفعة، لكنّه طلب أن أخلع حذائي وأدخل إلى الصدر لأجلس على اللبّاد.
جلس إلى جواري، بعد أن أحضر أوراقاً وقلماً أزرق من الخزانة، فقلت:
– هيّا نبتدي.
ابتسم (سمعو) فبانت أسنانه السّوداء المنخورة، وقال:
– ليس قبل أن نشرب قدحاً من الشّاي العجمي، وسيكارة على مزاجك.
قلتُ وأنا أحسُّ بالإنقباض والنّدم، لأنّي أجالس هذا الرّجل الكريه:
– لا داعي لذلك.. أنا على عجلة فأمّي تنتظرني.
مدّ يده إلى جيبه، أخرج علبة تبغه المعدنية، فتحها بأظافره وأخرج سيكارتين ثخينتين، وقال:
– طيّب… خذ اشرب هذه ومن بعدها نبدأ.
– لا.. لا أريد.. أريد فقط أن تعلّمني.
– جرّب ودخّن هذه، أنا أعرف أنّك تدخّن.
تناولت السّيكارة منه، فكشّر ضاحكاً:
– فرخ البط عوّام، أبوك لا يحبّ إلّا سكائري هذه.
– لا.. لن أشربها إذاً.. هذه السّيكارة فيها حشيش.. وقذفتها أمامه. فقال:
– طيّب جرّب.. ولن تندم.
– مستحيل.. مستحيل.
– حسناً كما تريد لا تغضب سأدخن وحدي.
أشعل السّيكارة فظهرت عيناه تلمع مرعبتين، وبعد أن سحب نفساً عميقاً، قدّم إليّ السّيكارة:
– خذ على الأقل نفثة واحدة.. هيَّا لا تخجّلني.
ولأنّي أردتُ أن أنهي هذه القصة، لنبدأ بما جئت من أجله، إقتربت من يده، ووضعت فمي على السّيكارة، غير أنّه وفي نفس اللحظة خطف قبلة من خدّي، فصعقتني المفاجأة، وشممتُ أنفاسه الكريهة:
– ماذا تفعل يا عم (سمعو) ؟؟!!.
وهممتُ بالنّهوض، ولكنه لم يتركني، دفعني بعنف فارتميت على قفايّ، وهجم كالثور الهائج فوقي.. ألقى بثقله فوق صدري، ماسكاً يديّ، في حين أحنى رأسه وبدأ يقبّلني بجنون كالمحموم:
– دعني يا عم (سمعو) أرجوك… أستحلفك بالله… أتركني.. أمّي تنتظرني.
وكان يدمدم وهو منهمك في تقبيلي، وأنفاسه المقزٌزة تثقب أنفي:
– لن أتركك تخرج من عندي ياروح أمّك، قبل أن أنال مرادي منك.
حاولت جاهداً أن أتملّص منه، رجلاي تضربان ظهره، ويدايَ تحاولان الفكاك من يديه.. فأحرّك رأسي يمنة ويسرة، كيلا بتمكّن من تقبيلي… ولمّا وجد عنادي إلى هذا الحد، نهض إلى الخزانة بسرعة، وأخرج سكيناً لامعة، قبل أن أتمكّنَ من النّهوض، لأتّجه إلى باب الغرفة الموصد، ولكنه سدَّ عليّ الطّريق، وأمسكني:
– اخلع ملابسك وإلّا قتلتك.
تراجعت.. الذّعر سيطر على قلبي
وعيناه تقدحان شرراً، والسّكين في يده حادّة فظيعة:
– اتركني.. أرجوك.. أنا في عرضك.
– قلت لك تعرَّى.. وإلاّ…
– يا عم (سمعو) أبوس رجليك.
وانقضّ على شعري، يشدّه بعنف وبلا رحمة، لفَّ عنقي نحوه، ثمَّ وضع السّكين حوله، وصرخ:
– هل ستتعرَّى.. أم أذبحك ؟!.
كانت عيناي تراقبان السّكين، من خلال الدّموع، إنّها قريبة من عنقي، بل هي تلامسه.. فقلت باستسلام مرير:
– اتركني.. سأفعل ماتريد.
تركت يده المتوحّشة شعري، لكنّه ظلَّ ممسكاً بي، وهو يزعق:
– اخلع بنطالك.
خلعت بنطالي وأنا بين يديه مثل فرخ دجاج، سقط البنطال على الأرض، وأخذ (سمعو) يجسَّ لحم ساقي بقوّة… تملّكني شعور عارم بالخجل، فأنا عار من الأسفل تماماً، طوال عمري لم أتعرَّ أمام أحد، أمّي تعجز بي أن تدخل الحمام عليَّ حتّى تفرك لي ظهري، وأنا أرفض… تذكٌرت (سامح) ابن عمي، وماحدث له في (مقطع الزّاغ) مع المجرم (جمعة الكبّاج) ورفاقه يوم هرّبته من المدرسة، وكيف تعرّض للإغتصاب، وكاد أن يموت، لولا محاولة إنقاذه، التي كانت متأخرة.. ولكن هنا أنا من سيخلّصني وينقذني من هذا المجرم المتوحٌش؟!.. كيف سأواجه أبي وأهلي، وأولاد الحارة، الذين يسخرون من سامح حتى اليوم.
دفعني نحو الفراش ، فامتثلت خانعاً، وأمرني أن أخلع سترتي:
– ياعم (سمعو) أبوس (قندرتك) اتركني.
– اخلع سترتك وإلاّ ذبحتك، ورميت جثّتك في بئر الدّار.
وجدت نفسي عارياً تماماً، أرتجف وأبكي، عاجزاً عن فعل أيّ شيء… ألقى بالسكين من يده، وأخذ على عجل يخلع عنه(كلابيته) وحين تغطّى رأسه، ولم يعد يبصرني، وجدتها فرصة.
وانقضضت.. ولا أدري من أين جاءتني الجرأة وأخذت السّكين، وبسرعة، وقبل أن تظهر عينا (سمعو)، كانت السّكين قد انغرزت في بطنه، فصرخ يجأر كالذئب:
– آه ياكلب.. قتلتني.
عاودت طعنه من جديد، مرّة، ومرّتين، و.. لا أدري كيف كنت أفعل ذلك؟!.. كان كلّ ما أراه هو الدّم.. الدّم متدفّقاً من بطنه وصدره، يتخلّل شعر صدره الغزير، وأنا أنهال عليه بالطعنات بلا توقف، أو رحمة.. وهو يتراجع أمامي.. ثمّ هربت إلى باحة الدار، توجّهتُ إلى الباب، ولكنّ الباب لا يفتح.. إنّه.. إنّه مقفل، والمفتاح مع (سمعو)، نظرت إلى باب الغرفة، فهالني منظر (سمعو) واقفاً بدمائه، يريد أن يمسكني بيده اليسرى، بينما كانت يمناه تدفع أحشاءه المتدلّية إلى بطنه.
ركضت في باحة الدّار مبتعداً عنه وأنا أصرخ، وكان يلاحقني… وعدتُ إليه من جديد وطعنته، فاستطاع أن يمسكني، بلّلني بدمه، فصرختُ بقوّة، كانت عزيمته قد خارت، فحاولت التّملص من بين يديه، نزعت نفسي وجريت.. تناهت أصوات النّاس خارج الدّار، يطرقون الباب علينا، وصراخي لا ينقطع، والباب مقفل لا يفتح، والباحة
التّرابية امتلأت بقعاً حمراء من الدّم الدّاكن، و(سمعو) لم يشأ أن يسقط ميّتاً، ظلّ يطاردني، وها أنا أعود لطعنه من جديد، بسبب خوفي ورعبي، وعيوني تراقب الباب وهو يدفع بقوة و..
وإنكسر الباب أخيراً. وتدفق من خلفه الرّجال والأطفال، هرعت نحوهم وأنا أصرخ .. ناسياً عري.
كل ما أذكره أنّهم هرّبوني عارياً إلى بيت عمي المرحوم، والد (سامح) الذي تزوج والدي أمّه، حيث كان البيت قريبا من دار (سمعو)، وكان أبي هناك.. جميعهم استقبلوني بفزع ودهشة.. أرتميت أمامهم عارياً والسّكين بيدي تقطر دم العم (سمعو).
مصطفى الحاج حسين.
إسطنبول


















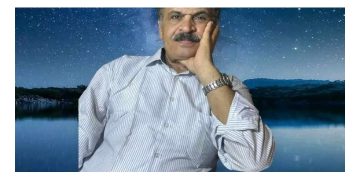






















Discussion about this post