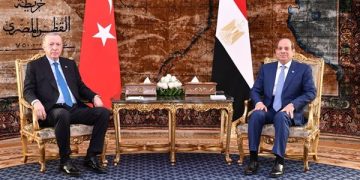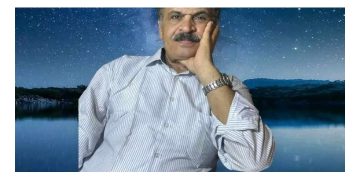انطلاقًا من مبدأ “لا تحجُبْ نورَ مِشعلِكَ عن أماكنِ الظّلمةِ”
“اللًهمّ ارحمْ فلانًا أو فلانة وارحمِ الموتى المسلمين”
حين نُضيّقُ الرّحمةَ نُنكرُ الأصلَ ونخالفُ الميثاقَ..
ليس أخطرَ على الإنسانِ من أن ينسى من أين أتى، فيتوهّمُ أنّهُ خُلِقَ وحدَهُ، أو أنَّ دمَهُ أصفى من دمِ غيرِهِ، أو أنَّ اللهَ اصطفاهُ وأقصى سواهُ.
فالإنسانُ، مهما اختلفَ اسمُه، لغتُه، لونُه، أو معتقدُه، لم ينحدرْ من أصولٍ متنازِعةٍ، بل تناسلَ جميعُ البشرِ من أبٍ واحدٍ وأمٍّ واحدةٍ: آدمَ وحواءَ.
تلكَ الحقيقةُ التّأسيسيّةُ الّتي كان يُفترضُ أنْ تكونَ حجرَ الأساسِ في الإخُوَّةِ الإنسانيّةِ، فإذا بها تُهمَلُ، ويُستعاضُ عنها بهُوِّيّاتٍ ضيِّقةٍ صنعَتْها السّياسةُ، وعمَّقَتْها الجغرافيا، ورسّخَتْها قراءاتٌ متصلِّبةٌ للعقائدِ.
إنَّ كُلَّ ما يُفرِّقُ البشرَ اليومَ هو أمرٌ طارئٌ لا جوهريٌّ:
حدودٌ رُسِمَتْ بالقوّةِ،
انتماءاتٌ غذّتْها المصالحُ،
تصنيفاتٌ ولَّدَها الخوفُ،
وعقائدُ فُهِمَتْ أحيانًا بمنطقِ الإقصاءِ لا بمنطقِ الحكمةِ.
أمّا الأصلُ، فواحدٌ،
والكرامةُ الإنسانيّةُ واحدةٌ،
والضَّعفُ الإنسانيُّ واحدٌ،
والموتُ مصيرٌ جامعٌ لا يسألُ عن هُوّيّةٍ ولا يقفُ عندَ مذهبٍ، ولا يعترفُ بجوازِ سفرٍ.
وليس هٰذا الفَهمُ وليدَ العاطفةِ وحدَها، بل تُؤكِّدُهُ الوثائقُ الأخلاقيّةُ الكبرى الّتي تَوَافَقَ عليها ضميرُ البشريّةِ.
فالإعلانُ العالَميُّ لحقوقِ الإنسانِ انطلقَ من مبدأٍ بسيطٍ وعميقٍ: أنَّ جميعَ النّاسِ يولدون أحرارًا وهم متساوون في الكرامةِ والحقوقِ.
وهٰذا ليس طرحًا سياسيًّا فحَسْب، بلِ اعترافٌ أخلاقيٌّ بأنَّ الاختلافَ لا يُلغي المساواةَ، وأنَّ التّنوُّعَ لا يَنفي الإخُوّةَ.
كما أنَّ المواثيقَ الإنسانيّةَ، القديمةَ والحديثةَ، شدَّدَتْ على أنَّ قيمةَ الإنسانِ نابعةٌ من كونِهِ إنسانًا، لا مِنِ انتمائِهِ، ولا من مُعتَقَدِهِ، ولا من جغرافيّتِهِ.
وهٰذا المعنى نفسُهُ تجِدُهُ حاضرًا في جوهرِ الرِّسالاتِ السّماويّةِ، حين جعلَتِ العدلَ والرَّحمةَ، وصونَ النًفسِ، وحِفظَ الكرامةِ، مقاصدَ عُليا لا تُجزَّأُ ولا تُحتكرُ.
من هنا، يُصبحُ تضييقُ الرّحمةِ — حتّى في أبسطِ صورِها كالدُّعاءِ — انحرافًا ذِهنيًّا قبلَ أنْ يكونَ خِلافًا فكريًّا.
فالرّحمةُ حين تُقيَّدُ بالأقواسِ، تُفرَّغُ من معناها، وتتحوّلُ من قيمةٍ جامعةٍ إلى أداةِ فرزٍ.
وكأنّنا، مِنْ حيثُ لا نشعرُ، نُصادرُ حقَّ اللهِ في الرّحمةِ، ونمنحُ أنفُسَنا سلطةَ تقريرِ مَنْ يستحِقُّها ومَن يُحرَمُ منها، فنُنَصِّبُ أنفُسَنا أوصياءَ على السّماء.
النّقدُ هنا لا يستهدفُ الإيمانَ، بل يستهدفُ التَّعصُّبَ الّذي يُشوِّهُ الإيمانَ،
ولا يخاصمُ العقيدةَ، بل يخاصمُ التّعصُّبَ الّّذي يُفَرِّغُ العقيدةَ من بُعدِها الإنسانيّ.
فالعقيدةُ الّتي لا تُهذِّبُ السّلوكَ، ولا تُوسِّعُ القلبَ، ولا تُنصفُ الإنسانَ المختلِفَ، ولا تُهذّبُ النّظرةَ إلى الإنسانِ، تتحوّلُ من نورٍ هادٍ إلى جدارٍ فاصلٍ.
لقد علّمَتنا التّجربةُ الإنسانيّةُ، كما علَّمَتْنا الحروبُ، أنَّ أخطرَ الانقساماتِ ليسَتْ تلك الّتي تفرِضُها الخرائطُ، بل تلك الّتي تُزرعُ في العقولِ، حين يُربّى الإنسانُ على أنَّ الآخرَ تهديدٌ، لا شريكُ وُجُودٍ،
وعلى أنَّ الاختلافَ نجاسةٌ، لا سُنَّةٌ كَونيّةٌ،
وعلى أنَّ الرّحمةَ امتيازٌ، لا واجبٌ أخلاقيٌّ، يكونُ المجتمعُ قد وضعَ بُذورَ العُنفِ، ولو لبِسَ ثوبَ التَّدَيُّنِ أوِ الوطنيّةِ.
نحنُ إخوةٌ في أقاصي الأرضِ،
نتقاسمُ الحُزنَ ذاتَهُ حين نفقدُ أحبابَنا،
والرّجاءَ ذاتَهُ حين نبحثُ عنِ الأمانِ،
والوجعَ ذاتَهُ حين نُخذَلُ.
فأيَّ تربيةٍ نمنحُها لأطفالِنا حين نُعلِّمُهُم لُغةَ التّفريقِ والتّمييزِ؟ وأنَّ الرّحمةَ “لنا” فقط.
وأيَّ وعيٍ نزرعُهُ حين نربِطُ الأخلاقَ بالانتماءِ لا بالإنسانِ؟
وأيَّ مستقبلٍ نرجوهُ لِعَالَمٍ يُقسَّمُ فيه البشرُ إلى “نحن” و“هُم” حتّى في الدّعاءِ؟
إنَّ التّربيةَ الحقيقيّةَ لا تبدأُ بتلقينِ الأحكامِ، بل بتشكيلِ الضّميرِ،
ولا تقومُ على تضخيمِ الهُوّياتِ، بل على ترسيخِ القِيمِ المشترَكةِ.
عَلِّموا أبناءَكُم أنَّ الرّحمةَ لا تُنقِصُ الإيمانَ بل تُزَكّيهِ،
وأنَّ العدلَ لا يُهدّدُ العقيدةَ بل يحميها،
وأنَّ اللهَ لم يخلُقِ البشرَ ليكونوا نُسَخًا متطابقةَ، بل إخوةً مختلفين.
ربُّوا فيهم إنسانيَّتَهُم قبل اصطفافاتِهِم،
وَوَسِّعُوا قلوبَهُم قبلَ حدودِهِم،
وذكِّروهم بأنَّ مَنْ ضاقَ بالإنسانِ، ضاقَ بالحقيقةِ نفسِها.
فَلْنكُنْ دُعاةَ رحمةٍ لا حُرَّاسَ أبوابِها، وَلْنترُكْ لِلهِ ما هو للهِ…
فهو الأعلمُ بالقلوبِ، والأعدلُ بين عبادِهِ،
والأرحمُ حين تعجزُ رحمتُنا نحن عنِ الاتّساعِ.
فواعجبًا كيف تتحوّلُ الرّحمةُ، وهي القيمةُ الكونيّةُ والمقصدُ الرّوحيُّ الجامعُ، إلى ممارسةٍ انتقائيّةٍ تُمنَحُ وِفقَ الانتماءِ، وتُسحَبُ عند الاختلاف؟
وهل يكمُنُ الخللُ في جوهرِ العقائدِ ذاتِها، أمْ في القراءاتِ البشريّةِ الّتي حَمَّلَتِ الإيمانَ أعباءَ الهُوِّيّةِ والصّراعَ، وفصلَتْهُ عن مقاصِدِهِ الأخلاقيّةِ، حتى غدا التّضييقُ في الرّحمةِ أمرًا مُبرَّرًا في الوعيِ الجَمعيّ؟
فكيف يُمكنُ إعادةَ وصلِ ما انقطعَ بين الإيمانِ والإنسانِ، بين العقيدةِ والرّحمةِ دون الوقوعِ في زعزعةِ القِيَمِ أو مصادرةِ الخُصوصيّات؟
إنّها إشكاليّةٌ تضعُنا أمام امتحانِ الضّميرِ:
هل نريدُ إيمانًا يحرُسُ الحدودَ… أم إيمانًا يوسّعُ القلب؟
عايدة قزحيّا
من “مقالاتي”