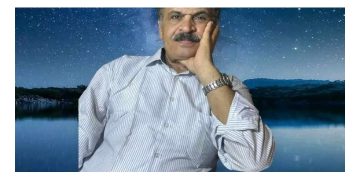بقلم الكاتبه … سامية البابا
قصة: “الأسير الحرّ”
في أحد أحياء المدينة القديمة، كان هناك هاتف منزلي قديم، مُعلق على الحائط في صالة البيت. لم يكن يتحرّك، ولم يكن أحد يفكر فيه كثيرًا. يُرنّ حين يحتاج أحدهم أنّ يتواصل، ثم يعُود إلى سكونه. في ذلك الزّمن، كان النّاس يجلسون معًا، يضحكون، يروون القصص، ولا ينظرون إلى أيديهم إلا إذا حملوا فنجان قهوة أو كتابًا.
كان الطّفل سامي يحب اللّعب في الحارة. يركض، يتسخ، يقع ويقوم. لا شيء يشده إلى البيت سوى نداء أمّه أو صوت الآذان. لم يكن الهاتف جزءًا من يومه، بل كان مجرد آلة للكبار.
مرت السّنوات. كبر سامي، وكبر الهاتف… تحوّل من جهاز ثابت في البيت ، إلى رفيق لا يُفارق الجيب. صار الهاتف يَرنّ، يَهتز، يُضيء، يَسرق اللّحظات من بين الأيدي، يَخطف الأحاديثَ من منتصفها، ويجعل الجلسات صامتة.
أصبح الهاتف النّقال عالماً بين الأيدي ، بديل عن شاشة التّلفاز ، والكاميرا ، بديل عن الهاتف الثّابت وبريد الرّسائل، أصبحت الرّسالة تصل بثواني معدودة ، والخبر ينقل مباشرة .
سامي الآن شاب، يمشي في الطّرقات وعيناه على الشّاشة. لا يرفع رأسه ليرى الشّجرة الّتي كانت ملعب طفولته ، ولا يسلم على الجارة الّتي كانت تعطيه الحلوىٰ. يبتسم لصور، ويحزن لمقاطع، ويغضب من تغريدات… كلّ من ذلك والهاتف لا يحمل سلكًا، لكنّه يسحبه من الحياة بخيط لا يُرى.
وذات مساء، جلس سامي وحده في غرفته، يتصفح بلا هدف. شعر بفراغ غريب. تذكّر صوته حين كان يصرخ في الحارة، وتذكّر ضحكته الحقيقية، لا تلك التي يرسلها عبر “رمز تعبيري”. نظر إلى الهاتف وقال في نفسه:
“كيف تحررتَ أنت من سلكك، وقيدتني أنا بكلّ هذا الخيوط؟”
فكر أن يطفئه، أن يبتعد قليلاً، أن يستعيد نفسه. مدّ يده ليرمي الهاتف بعيدًا عنه… لكنّه توقف.
رنّ إشعار.
رسالة جديدة.
فضول. رغبة. تعلق.
أمسك الهاتف مجددًا، وسحب الشّاشة نحو الأعلى.
ثم نحو الأعلى… ثم الأعلى…
نسي السّؤال.
نسي الشّعور.
نسي أنّه كان يفكر في التّحرر.
عاد يَسجن نفسه بصمت، بإرادته، دون قيد ظاهر.
وفي الظّل، على الطّاولة الخشبية بجانب سريره، كان الهاتف القديم – ذلك المربوط بالسّلك – يراقب المشهد ساخرًا، وكأنّه يقول:
“أنا كُنتُ مُقيدًا بالجدار، أما أنتم ،،، فصارت الجدران في داخلكم ، كبيركم و صغيركم.”
بقلم الكاتبه … سامية البابا
فلسطين