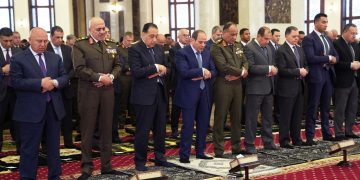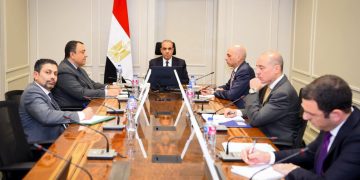الحُبُّ الأبويُّ
لم يكنِ الرّجلُ ممّن يرسمون حياتَهُم بخطٍّ مستقيم، بل كان أقربَ إلى نهرٍ تُغيّرُ المنعطفاتُُ مجراه، ولا تغيّرُ ماءَه.
خرجَ من وطنِهِ شابًّا يحملُ حقيبةً صغيرةً، وحنينًا أكبرَ من المدنِ الّتي سيعبرُها، يسافرُ لا طلبًا للمغامرةِ بل طلبًا لعيشٍ كريمٍ، كطائرٍ يتركُ عُشَّهُ لأنَّ الشّتاءَ لا يُساوِمُ ولا يُهادنُ.
في بلادِ الغَربِ طالَ به المقامُ حتّى صارَ الغيابُ وطنًا موقّتًا.
هناك تعرّفَ إلى امرأةٍ تُشبهُ صباحاتِ تلك البلاد، هادئةً، استعارَتِ الشّمسَ لونًا لشعرِها حين يلامسُهُ الضّوءُ، وعينين استوطنَتِ السّماءُ فيهما.
لم يكنِ الزّواجُ نزوةً عابرةً، بل رِفقةً تحمي قلبَهُ من التصلّبِ، ودِفئًا يمنعُ عنه الوحدةَ.
ثم نقلَتهُ ظروفُ الحياةِ إلى بلدٍ إفريقيٍّ، حيث الشّمسُ أقربُ إلى الكتفَين، والأرضُ أوسعُ صدرًا، وهناك التقى بامرأةٍ ارتاحَ اللّيلُ الدّافئُ فوقَ سُحنتِها، قلبُها واسعٌ كسهلٍ بعد المطر. تزوّجَها لأنَّ الغريبَ حين يمرَضُ يحتاجُ يدًا تمسحُ جبينَهُ، لا خريطةً تعيدُهُ إلى وطنِه.
وبعدَ أعوامٍ أخرى، استقرَّ عملُهُ في بلدٍ آسيويٍّ، حيثُ المعابدُ تهمسُ بالسّكينةِ، والزُّهورِ تُعلَّقُ على النّوافذِ كأدعيةٍ صامتةٍ، هناكَ تزوّجَ امرأةً هندوسيّةً، رقيقةً كزهرةِ لوتسَ فوقَ سكونِ الماءِ، تتأمّلُ أكثرَ ممّا تتكلَمُ، كأنّها تحفظُ العالمَ في صمتِها.
وأخيرًا… عادَ إلى وطنِهِ.
عادَ وقد صارَ عمرُهُ خرائطَ، وقلبُهُ محطّاتٍ. تزوّج ابنةَ أرضِهِ، لا ليبدأَ من جديدٍ، بل ليضعَ حقائبَهُ أخيرًا، ويشعرَ أنّهُ لم يعُدْ زائِرًا.
لم يكنْ في قصّتِهِ خيانةٌ، بلِ استسلامٌٌ لضروراتِ الحياة، كما يستسلمُ المسافرُ لِلَيلٍ يفرضُ عليه المبيتَ في مدينةٍ لم يختَرْها.
كبُر البيت… أو لعلَّهُ اتّسعَ حتّى تَعَولَمَ فصارَ قارّةً كونيَّةً صغيرةً، حيث كانَ الأطفالُ ثمرةَ تلكَ الرِّحلاتِ كُلِّها:
واحدٌ بشرتُهُ داكنةٌ كالتُّربةِ بعدَ المطر،
وآخرُ أشقرُ كخيطِ شمسٍ سقطَ على كتفَيه،
وثالثٌ قمحيٌّ كحقولِ أيلولَ،
ورابعٌ بلونِ الغيمِ حين يميلُ إلى الفضّةِ،
وخامسٌ عيناه واسعتان كليلٍ إفريقيٍّ بلا قمر.
كانوا يركضون في السّاحةِ فتختلطُ الألوانُ كقوسِ قُزَحٍ، دونَ أنَ يتخاصَمَ لونٌ مع آخر.
ضحكاتُهُم واحدةٌ، وأنفاسُهُم واحدةٌ، وخصوماتُهُم قصيرةٌ كغيمةٍ صيفيّةٍ عابرةٍ، سرعانَ ما تزولُ.
ذاتَ مساءٍ، وقفَ جارُهُ يتأمّلُ المشهدَ من وراءِ السُّورِ.
اقتربَ وقالَ بنبرةٍ يغلبُها الفضول:
— يا أبا داني سامِحني إنْ كان سؤالي ثقيلًا، لكنّي أتساءَلُ دائمًا:
هل يميلُ قلبُكَ أكثرَ إلى أبناءِ زوجتِكَ الأجنبيةِ
أمْ إلى أبناءِ الإفريقيّةِ
أمْ إلى أبناءِ الهندوسيّةِ
أمْ إلى أبناءِ بنتِ البلد؟
لم يكُنِ السّؤالُ اتّهامًا، بل دهشةَ إنسانٍٍ يرى اختلافًا في الظّاهرِ ويبحثُ عن ميزانٍ في الدّاخلِ.
ابتسمَ أبو داني، ولم يُجِبْ فورًا.
وفجأةً، تعثَّرَ أحدُ الأبناءِ وسقطَ..
وقبلَ أنْ يصلَ الأبُ إليه، كانتِ الأيدي الصّغيرةُ قد سبقَتْهُ؛
هٰذا يمُدُّ يدَهُ، وذاك ينفضُ الغبارَ عن ثيابِهِ، وثالثٌ يكادُ يبكي أكثرَ منهُ، ورابعٌ يحتضنُهُ كأنّهُ يخشى أنْ ينكسرَ.
اجتمعوا حولَهُ كأغصانٍ تحيطُ بجذعٍ واحدٍ.
أشارَ الأبُ إلى المشهدِ وقال:
— أرأيتَ؟
ثم تابعَ بهدوءٍ:
— هل سألتَ الآن مِن أيِّ أُمٍّ هٰذا الّذي سقطَ؟
وهل سألَ إخوتُهُ قبلَ أنْ يركُضوا إليهِ مِن أيِّ أرضٍ جاءَ؟
سكَتَ الجارُ.
فقالَ الأبُ:
— الاختلافُ يا صديقي فوقَ الجِلدِ…
أمّا تحتَ الجلدِ، فالنّبضُ واحدٌ.
فوقَ الجِلدِ لونٌ وحكايةُ سَفَرٍ،
وتحتَ الجِلدِ دمٌ لا يعرفُ القارّاتِ.
اقتربَ خُطوةً وأكملَ:
— حينَ يبكي أحدُهُم، لا أرى بشرَتَهُ، بل أرى الغيمةَ الّتي تُثقِلُ قلبَهُ.
وحينَ يضحكُ أحدُهُم، لا أسمعُ لُغةَ أمِّهِ، بل أسمعُ الرّبيعَ نفسَهُ.
هم لا يدخلونَ إلى قلبي بألوانِهِم… بل بأنفاسِهِم.
ثم أعادَ رَميَ كرةٍ تدحرجَتْ نحوهُ، فعادتِ الضّحِكاتُ تتطايرُ في الهواءِ كعصافيرَ أُفلِتَتْ من قفصٍ.
رفعَ بصرَهُ إلى السّماءِ الّتي بدأَتْ تلبَسُ زُرقةَ المساءِ:
— أخبِرني يا جاري…
هل تسألُ الشّمسُ الأرضَ مِن أينَ جِئتِ قبلَ أنْ تُدفِئَها؟
هل يَختارُ المطرُ حقلًا دونَ آخرَ لأنَّهُ يُشبِهُهُ؟
هل يرفضُ الهواءُ صدرًا لأنَّهُ يختلفُ عن صدرٍ آخرَ؟
وهلِ النّهرُ يُفرِّقُ بين روافدِهِ حينَ تعودُ إليهِ؟
قالَ الجارُ بصوتٍ خافتٍ: لا.
ابتسمَ الأبُ ابتسامةً فيها تعبُ السّنين وسلامُها معًا:
— كذٰلك قلبي لوِ انحازَ لانكسرَ.
ولو قَسَّمَ نفسَهُ، لم يعُدْ قلبًا.
ولوِ انقسمَ قلبي بعددِهم، لَبَقيَ كُلُّ جُزءٍ فيه كاملًا.
نظرَ إلى الأطفالِ الّذين عادوا يركضون معًا، وقد نسيَ الّذي سقطَ ألمُهُ، لأنَّ الأيدي الّتي رفعَتْهُ كانَتْ أكثرَ من وجعِهِ، فَبَلْسَمَتْ روحَهُ.
ثم قالَ:
— هُمْ لا يعرفونَ بعدُ كيف ينقسمُ النّاسُ…
لم يتعلّموا أسماءَ الحدودِ ولا عقائدَ الاختلافِ، ولا شرائعَ الأرضِ، ولا قوانينَ الملكيّةِ والإرثِ، ولا آدابَ المجتمعِ، واحترامَ كبارِ المناصبِ،
فالتّمييزُ يُزرعُ متأخِّرًا… أمّا المحبّةُ فتُولَدُ معَ النَّفَسِ الأوّلِ.
سكَتَ قليلًا، ثمّ أضافَ كَمَن يبوحُ بسرٍّ عميقٍ:
— في كُلِّ بلدٍ ظنَنتُ أنّني أبحثُ عن حياةٍ…
لكنّني كنتُ في الحقيقةِ أجمعُ قلوبًا لأضعَها هنا.
وهؤلاء ليسوا أبناءَ تلكَ البُلدان…
إنَّهُم أبناءُ الرّحمةِ الّتي لم تتركْني وحيدًا في أيِّ سَفَرٍ.
وفي تلكَ اللّحظةِ، ركضوا نحوَهُ جميعًا، كأنّهم موجةٌ صغيرةٌ تعودُ إلى شاطئِها، وتعلّقوا به، فاختلطَتِ الألوانُ في حضنِهِ كما تختلطُ الزُّهورُ في باقةٍ واحدةٍ، لا يسألُ فيها أحدٌ من أينَ قُطِفَتْ كُلُّ زهرةٍ.
نظرَ الجارُ إليهم متأمِّلًا، فاغرورِقَتْ عيناهُ بالدّموعِ، ثم قال همسًا:
—هلْ تصدّقُ يا أبا داني أنّي تمثّلْتُ اللهَ في هٰذا المشهدِ؟!
تخيّلتُ اللهَ الّذي خلَقَنا بجميعِ ألوانِنا كيف يُعانقُنا، ويرعانا بمحبّته وعنايتِه، وكم تؤلمُهُ خصوماتُنا، وتعنيفُ بعضِنا لبعضٍ، وكَم نؤذي مشاعرَ أُبُوّتِهِ عندما نتخاصمُ ونتشاجرُ، فكيفَ بنا ونحنُ نُدمي قلبَهُ بقتلِ بعضِنا بعضًا؟!
لم يُجِبْ أبو داني، بل رفعَ بصرَهُ إلى السّماءِ الممتدَّةِ فوق البيوتِ كُلِّها، ثم قالَ بصوتٍ كأنّهُ يخرجُ من مكانٍ بعيدٍ:
— أنا أبٌ… لا أفرّقُ بين أبنائي الّذينَ وُلِدوا بإرادةِ اللهِ، فهلِ اللهُ يُفرّقُ بين أبنائِهِ البشر الّذين خلَقَهُم؟
وبقيَ السّؤالُ مُعَلَّقًا في المساءِ، كنجمةٍ لم تسقُطْ بعدُ.
أمّا الأولادُ، فظلّوا يضحكونَ ويلتصقونَ به، لا يعرفون أنّهم يُجيبونَ بطريقتِهِم الخاصّة:
نختلفُ فوقَ الجلد…
لكنّنا، تحت الجلدِ،
قلبٌ واحدٌ في قلبِ الله.
عايدة قزحيّا
من “مجموعتي القصصيّة”