عنترة والردف الصوري والمنهج الفلسفي
…
مقطع من كتابي الموسوعة ” الشعر فلسفة العرب”
لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعلو بِهِ الرُتَبُ * وَلا يَنالُ العُلا مَن طَبعُهُ الغَضَبُ
وَمَن يِكُن عَبدَ قَومٍ لا يُخالِفُهُم * إِذا جَفوهُ وَيَستَرضي إِذا عَتَبوا
قَد كُنتُ فيما مَضى أَرعى جِمالَهُمُ * وَاليَومَ أَحمي حِماهُم كُلَّما نُكِبوا
لِلَّهِ دَرُّ بَني عَبسٍ لَقَد نَسَلوا * مِنَ الأَكارِمِ ما قَد تَنسُلُ العَرَبُ
لَئِن يَعيبوا سَوادي فَهوَ لي نَسَبٌ * يَومَ النِزالِ إِذا ما فاتَني النَسَبُ
إِن كُنتَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَنَّ يَدي * قَصيرَةٌ عَنكَ فَالأَيّامُ تَنقَلِبُ
اليَومَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَيَّ فَتىً * يَلقى أَخاكَ الَّذي قَد غَرَّهُ العُصَبُ
إِنَّ الأَفاعي وَإِن لانَت مَلامِسُها * عِندَ التَقَلُّبِ في أَنيابِها العَطَبُ
فَتىً يَخوضُ غِمارَ الحَربِ مُبتَسِماً * وَيَنثَني وَسِنانُ الرُمحِ مُختَضِبُ
إِن سَلَّ صارِمَهُ سالَت مَضارِبُهُ *وَأَشرَقَ الجَوُّ وَاِنشَقَّت لَهُ الحُجُبُ
وَالخَيلُ تَشهَدُ لي أَنّي أُكَفْكِفُهَا * وَالطَعنُ مِثلُ شَرارِ النارِ يَلتَهِبُ
إِذا اِلتَقَيتَ الأَعادي يَومَ مَعرَكَةٍ *تَرَكتُ جَمعَهُمُ المَغرورَ يُنتَهَبُ
لِيَ النُفوسُ وَلِلطَيرِ اللُحومُ *وَلِلوَحشِ العِظامُ وَلِلخَيّالَةِ السَلَبُ
لا أَبعَدَ اللَهُ عَن عَيني غَطارِفَةً *إِنساً إِذا نَزَلوا جِنّاً إِذا رَكِبوا
أُسودُ غابٍ وَلَكِن لا نُيوبَ لَهُم *إِلّا الأَسِنَّةُ وَالهِندِيَّةُ القُضُبُ
تَحدو بِهِم أَعوَجِيّاتٌ مُضَمَّرَةٌ *مِثلُ السَراحينِ في أَعناقِها القَبَبُ
ما زِلتُ أَلقى صُدورَ الخَيلِ مُندَفِق * بِالطَعنِ حَتّى يَضِجَّ السَرجُ وَاللَبَبُ
فَالعُميُ لَو كانَ في أَجفانِهِم نَظَروا * وَالخُرسُ لَو كانَ في أَفواهِهِم خَطَبوا
وَالنَقعُ يَومَ طِرادَ الخَيلِ يَشهَدُ لي * وَالضَربُ وَالطَعنُ وَالأَقلامُ وَالكُتُبُ
…
القصيدة تمثل تجليًا حيويًا للبطولة الفردية، وتُجسّد مفهوم الذات الشاعرية المتعالية على الغضب والحقد، والمنتصرة في الحرب بفضل المبدأ لا الانتقام. سيميائيًا، تتشكل بنية القصيدة من تتابع صور شعرية تتردف بعضها على بعض، وهو ما يسمى عند الفكمازيين ب ” الردف الصوري” كأن كل صورة مشهد يفسر المشهد السابق ويوسّعه.
تبدأ الصورة الأولى بنفي الحقد عن أصحاب المراتب العليا، وهي صورة أخلاقية، تتلوها صورة تتحدث عن الغضب كمانع من نيل العلا. ينتقل المعنى تدريجيًا من الأخلاق إلى الموقف الاجتماعي: صورة العبد الذي لا يخالف قومه، ثم إلى صورة الراعي الذي تحوّل إلى الحامي، مما يدل على تطور الشخصية من الضعف إلى القوة.
الصورة المركزية في النص هي صورة الذات البطولية، التي تتجلى في أبهى صورها حين يقول: لئن يعيبوا سوادي فهو لي نسب. هنا يُحوّل السواد –الذي يُعتبر عيبًا عند بعض العرب– إلى مصدر للفخر، في مشهد سيميائي يعيد تأويل العلامة الاجتماعية (السواد) ويمنحها شرفًا في الميدان.
في القسم الثاني من القصيدة، تبدأ سلسلة الصور القتالية: الأفعى الناعمة في الملمس، القاتلة عند التقلّب، ترمز إلى الشاعر كمقاتل مخادع في التكتيك لكنه قاتل عند الهجوم. تليها صورة الفارس المبتسم في وجه الحرب، صورة تُذكرنا بابتسامة المحاربين النبلاء، لكنها تحمل دلالة التحدي والموت المرِح.
الرمح المختضب، الخيل الشاهدة، الطعن كشرر النار، كل هذه الصور تتراكم لتصنع فضاءً بصريًا متسلسلًا، فالصورة لا تتوقف عند لحظة، بل تسيل إلى التالية. حتى الطير والوحش لهما نصيب من الغنيمة، مما يجعل مشهد المعركة عامًا وشاملًا لكل مفردات الطبيعة.
وتتوج هذه الردائف الصورية بمشهد ملحمي: الخيل في اندفاعها، الضرب والطعن، الغبار الكثيف، وأخيرًا، الحبر الذي يسجل كل شيء. فكأن المعركة ليست فقط في الميدان، بل في التاريخ، في الأقلام، في الكتب.
هذه البنية البصرية المتتالية تخلق إيقاعًا خاصًا، ليس فقط سمعيًا، بل صوريًا، حيث تستدعي كل صورة سابقتها وتحملها معها إلى التالية، في تتابع دلالي يترسخ في ذهن المتلقي. هنا يكمن الردف الصوري: سلاسل من الصور المترابطة تفسر بعضها البعض، وتبني هوية الشاعر كما تبني عالمه.
…..
حين يُقال إن الفلسفة تبدأ بالدهشة، فإن الشاعر الجاهلي كان أول من دهش أمام الوجود، وتمرد على قيود الواقع، وصاغ رؤاه بلغة تسبق الفلسفة ذاتها. لم يكن الشعر الجاهلي مجرّد تصوير للبيئة أو تغنٍ بالمفاخر القبلية فحسب، بل كان، في عمقه، بحثًا عن إجابات لأسئلة الإنسان الأولى: من أنا؟ ما مصيري؟ ما معنى الكرامة؟ ولماذا الموت؟
تُمثّل قصيدة عنترة بن شداد التي بين أيدينا نموذجًا راقيًا لمستوى الفلسفة الضمني في الشعر الجاهلي، حيث تبرز قضايا الهوية، الحرية، الشجاعة، الوجود، والخلود. في هذه القراءة، سنسعى إلى تأويل النص تأويلاً فلسفيًا يعيد للشعر الجاهلي مكانته كمرآة فكرية للوجود الإنساني قبل أن تكتب الفلسفة العربية نصوصها الكبرى.
أولاً: الهوية والوجود – من الرفض إلى التأسيس
> “لَئِن يَعيبوا سَوادي فَهوَ لي نَسَبٌ / يَومَ النِزالِ إِذا ما فاتَني النَسَبُ”
في هذا البيت يعرض عنترة أزمة الهوية، وهي من أبرز الإشكالات الوجودية التي شغلت الفلاسفة. فهو عبد اللون، لا عبد القيمة، ويعلم أن وجوده لا يتحقق إلا بالفعل، لا بالدم. بهذا المعنى، يعيد عنترة تأسيس الهوية لا على النسب الوراثي، بل على النسب الأخلاقي والشجاعي، تمامًا كما سيقول سارتر لاحقًا: “الوجود يسبق الماهية”
ثانيًا: فلسفة الألم والسمو – ابتسامة الفارس أمام الموت
> “فَتىً يَخوضُ غِمارَ الحَربِ مُبتَسِماً / وَيَنثَني وَسِنانُ الرُمحِ مُختَضِبُ”
الابتسامة في هذا السياق لا تنبع من خفة، بل من إدراك عميق لمعنى الألم. عنترة هنا يبتسم لأنه قد أدرك سرّ البطولة: أن تحيا صادقًا ولو في قلب الهلاك. يقترب من الفكر الرواقي، بل يسبقه، حين يجعل من الحرب فرصة لسمو الذات، لا لمجرد الانتقام. الألم، إذًا، ليس شرًا خالصًا، بل مسلكًا نحو المجد، وهو ما يجعل الفارس شاعرًا وفيلسوفًا في آنٍ معًا.
ثالثًا: عنترة والحرية – تجاوز العبودية
> “وَمَن يِكُن عَبدَ قَومٍ لا يُخالِفُهُم / إِذا جَفوهُ وَيَستَرضي إِذا عَتَبوا”
عنترة ينتقد العبودية الطوعية، والتي تُعدّ أشد من عبودية اللون أو النسب. هو عبد اللون، نعم، لكنه حرّ الإرادة والكرامة. وهذا التمييز بين “الحر والعبد” من حيث السلوك لا من حيث النسب، يمثّل أساسًا من أسس الفكر الوجودي الحر. فليس العبد من وُلد عبدًا، بل من عاش خانعًا، مسترضيًا للذل.
رابعًا: الحرب والخلود – الشعر بوصفه شاهدًا
> “وَالنَقعُ يَومَ طِرادَ الخَيلِ يَشهَدُ لي / وَالضَربُ وَالطَعنُ وَالأَقلامُ وَالكُتُبُ”
يمرّ الفعل البطولي ليُدوَّن، ومن ثم يتحول إلى جزء من ذاكرة البشرية. عنترة هنا يُدرك أن الخلود لا يتحقق في الجسد، بل في الأثر، في الشهادة المكتوبة. كأن الشعر هنا ينهض بدور التأريخ الفلسفي لفعل الإنسان. كل سيف يُرفع لا يُكمل دورَه دون قصيدة توثّق، فتصبح المعركة بداية الخلود لا نهايته.
خامسًا: الحقد والغضب – أخلاق القوة لا الانتقام
> “لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعلو بِهِ الرُتَبُ / وَلا يَنالُ العُلا مَن طَبعُهُ الغَضَبُ”
هنا يُعلن عنترة، رغم كل الألم والعنصرية التي عاشها، أنه لا يحمل الحقد، لأن سمو النفس لا يجتمع مع الانحدار الأخلاقي. هذه فلسفة قائمة على التسامي، تنفي الغضب كقيمة وتحيله إلى ضعف. الفارس ليس فقط من يقتل عدوه، بل من يقتل في نفسه الغضب إذا ما بلغ المعالي. وهذه دعوة نادرة في الشعر الجاهلي إلى ضبط النفس، بل سامية أخلاقيًا كما في فلسفة أفلاطون وأرسطو.
سادسًا: عنترة والقدر – تأمل في تقلّب الأيام
> “إِن كُنتَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَنَّ يَدي / قَصيرَةٌ عَنكَ فَالأَيّامُ تَنقَلِبُ”
إدراك عنترة لتقلّب الدهر ليس استسلامًا، بل تحريضٌ على التهيّؤ للانقلاب. الزمن ليس مستقيمًا، بل دائري، تتبدل فيه المواقع. هذا الإدراك يجعل الإنسان متوازنًا بين الكبرياء والتواضع، ويجعله حذرًا من الثبات. وهو وعي يسبق نظرية “الدوائر التاريخية” التي تحدث عنها ابن خلدون، بل وحتى مفهوم التغيير الدائم في فلسفة هيراقليطس.
من خلال قراءة فلسفية لنص عنترة، يتضح أن الشعر الجاهلي لم يكن مجرد نظمٍ تقليدي أو وصفٍ سطحي، بل كان خطابًا فلسفيًا في قالب شعري، يؤسس لمعانٍ وجودية وإنسانية عميقة.
عنترة بن شداد – رغم قيد العبودية – كان حُرًا في نظرته للكون، فَرَسًا جامحًا نحو المجد، وفيلسوفًا لا تُدَوِّن أفكاره بالحبر فقط، بل بالرمح، وبالحكمة، وبالقصيدة.
وهكذا، نستطيع أن نقرأ الشعر الجاهلي لا بوصفه تراثًا، بل كفكرٍ حي، فيه من الحكمة ما يُغني عن كثير من الفلسفات
علاوة على احاءات رمزية، آليات التشوير والدلالة البيانية التي تخص البيت الذي جاء فيه
إن الأفاعي وإن لانت ملامسها * عند التقلب في أنيابها العطب
الاستعارة وآليات التشوير في بيت عنترة بن شداد
البيت الشعري:
*”إن الأفاعي وإن لانت ملامسُها *عند التقلّبِ في أنيابِها العَطَبُ”
يُعدّ هذا البيت نموذجًا بلاغيًا غنيًا، يبرز قدرة اللغة العربية على التعبير عن التوتر الدلالي بين الظاهر والباطن من خلال آليات الاستعارة والتشوير. وقد استطاع عنترة بن شداد في هذا البيت أن يُكثّف رؤية فلسفية ذات بعد إنساني وأخلاقي، تُحذّر من الانخداع بالمظاهر الخادعة.
أولًا: الاستعارة ودلالتها الرمزية
يُجسّد الشاعر في هذا السياق استعارة مكنية، إذ يشبّه الإنسان الغادر بالأفعى، من غير أن يصرّح بلفظ “الإنسان”، وإنما يكتفي بالإيحاء. فـ”الأفعى” ترمز إلى الكائن الذي يُظهر نعومة في الملامس ووداعة في السلوك، لكنها تخفي سمًّا قاتلًا بين أنيابها. هذه الاستعارة لا تكتفي بالتصوير، بل تؤسس لبنية رمزية متقنة تكشف عن الفجوة بين المظهر والجوهر.
ثانيًا: التشوير البلاغي وتوجيه المعنى
يعتمد البيت على بنية لغوية تستثمر مجموعة من الأدوات التي تُفعّل آليات التشوير، أي توجيه المتلقي إلى دلالة خفية تُستشف من ظاهر القول:
1 “إن” و”وإن”:
هما أداتان شرطيتان تُؤسسان لبنية استدراكية تنبه المتلقي إلى التناقض بين اللين الظاهري والضرر الكامن، مما يعزز البعد التحذيري في النص.
2 “لانت” و”ملامسها”:
تُوحيان بنعومة الحس وتُحرّكان الإدراك الحسي لدى المتلقي، لكن هذا الإدراك سرعان ما يُخادع، لأن النعومة هنا ليست سوى قناع يُخفي ما هو أدهى.
3 “عند التقلّب في أنيابها العطب”:
“التقلّب” يُشير إلى حالة من التقرّب أو الانغماس في التعامل، بينما “الأنياب” تُستثمر كرمز للشر المتربص. أما “العَطَب”، فهي الكلمة الفاصلة التي تُظهر النتيجة الحتمية لهذا الانخداع، ممّا يجعل الجملة بكاملها بُنية تشويرية قائمة على الصدمة والإفاقة.
ثالثًا: تقابل الظاهر والباطن كآلية دلالية
ينبني البيت على ثنائية بلاغية دقيقة:
ظاهر ناعم: (لانت ملامسها)
باطن قاتل: (أنيابها العطب)
هذا التقابل يُفَعّل آلية تشويرية رمزية تتجاوز المعنى الحرفي إلى البعد الرمزي، وتؤسس لما يمكن تسميته بـ”بلاغة التحذير” أو “الخطاب التنبيهي”، الذي يُحيل المتلقي إلى ضرورة الحذر من الأحكام السطحية.
إن بيت عنترة بن شداد يُعدّ مثالًا متقدمًا على التوظيف الفعّال للاستعارة ضمن نظام تشويري معقّد، حيث تتلاقى اللغة الحسية بالرمزية، والمباشر بالإيحائي، ليُنتج معنى يتجاوز حدود العبارة. وهكذا يتأكد أن البلاغة العربية ليست مجرد زخرفة لفظية، بل جهاز دلالي مرن قادر على إنتاج المعنى المركب، والتوجيه الرمزي، واستنهاض وعي المتلقي.
حميد بركي


















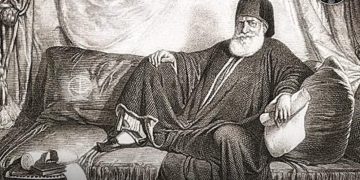




















Discussion about this post