منطق الشعر
منطق الشعر هو منطق لامنطق حين ينطلق المحسوس لا ملموس من قيود المادة، كما الروح التي لا تعترف بحدود الجاذبية، أو قوانين الفيزياء، إنه منطق الإدراك حين ينقلب في عين البصيرة، فلا يكون للأعلى معنى، ولا للأسفل حد لأن الرؤية هنا ليست حبيسة الجسد بل متحررة من قيود المكان والزمان حيث يصير الأفق نقطة نسبية لا يمكن تحديدها بثبات وحيث تصير الحقيقة انعكاسا للحسّ الوجداني لا للموقع الهندسي.
فمن يقف عند القطب يرى العالم مقلوبا ليس لأن الأرض تغيرت ولكن لأن زاوية الرؤية تجعله يدرك الأمور بمنطق يختلف عما اعتادته الأغلبية هنا يكون الشّعر امتدادا لهذا الوعي المتغير حيث لا يبقى الواقع كما هو بل يصير قابلا لإعادة التشكيل وفق المشاعر والانطباعات هنا تتجلى الصورة الشّعرية كفضاء تتحرك فيه الأفكار بحرّية كما تتحرك الكواكب في مداراتها دون أن تسقط رغم الجاذبية لأن كل شيء هنا يحكمه التوازن الدقيق بين الشعور والفكر بين التجربة والتعبير.
فإذا كان الواقع يقول إنّ الجاذبية تحكمنا فإن الشعر يقول إن الرّوح تسبح فوق الجاذبية وإذا كان العقل يقول إن للأعلى دلالة محددة فإن الإحساس يقول إن كل الاتجاهات سيان حين ننظر إليها من زاوية القلب فالشاعر حين يكتب لا يصف الأشياء كما هي بل كما يحس بها كما يراها بمنطقه الخاص الذي لا يخضع إلا لقوانين الإحساس والوجدان لهذا يكون منطق الشعر دائما مناقضا لمنطق الفيزياء حيث لا تسقط الأشياء نحو الأسفل بل ترتفع نحو المعنى حيث لا تخضع الكلمات للثقل بل تحلق بخفة المشاعر فتتجاوز حدود اللغة والمنطق.
ومن هنا نفهم كيف أن الشعر هو الوجه الآخر للحقيقة ذلك الوجه الذي لا تراه العين المجردة لكنه حاضر في كل تفاصيل الحياة لأن الحقيقة ليست في المعادلات الجامدة ولا في الحقائق المطلقة بل في ذلك الانعكاس الذي يراه الإنسان حين يفتح قلبه للممكن حين يتجاوز الرؤية النمطية ليحلّق في فضاء التأمل والخيال وحين يدرك أنّ الجاذبية قد تمسك الجسد لكنها لا تستطيع أن تمسك الفكرة لأن الفكرة حين تتحول إلى شعر تصير خفيفة كضوء النجوم حرة كالموجة التي لا يحدّها الشاطئ، وهو السّر الذي تحمله الرّوح، لكنها لا تكتفي بأن تكون مجرد وعاء محايد، بل تصبح هي الأخرى جزءًا من التّشكيل، تتحول إلى كائن حي ينبض مع الإحساس، يتلوّن بانفعالات الشاعر، يتمدد مع المعنى وينكمش معه، يفيض بالصور حين يشتّد الوجدان، ويتكثّف في الإيجاز حين يصبح الشّعور برقًا خاطفًا،
إنها ليست رموزا منطوقة أو مكتوبة، كما هي الأفق الذي تتحرك فيه العواطف، وهي الجسر الذي يعبر عليه الإحساس نحو الآخر. لهذا فإن اللغة الشعرية لا تشبه اللغة العادية، فهي ليست وسيلة لنقل المعلومات بقدر ما هي أداة لإعادة تشكيل الواقع، حيث يصبح للكلمات ملمس، وللمعاني أبعاد، وللصور طاقة تتجاوز حدود المنطق الجاف،
وفي هذا الامتزاج بين اللغة والإحساس، بين الرؤية الذاتية والتعبير، يصبح الشعر تلك القوة التي تستطيع أن تقلب المألوف رأسًا على عقب، كما تفعل الجاذبية حين تجعل القطبين نقيضين في الرؤية، لكنه في الحقيقة توحيدٌ للأضداد، إذ لا تناقض بين الأعلى والأسفل إلا في عين الناظر، ولا فرق بين الضوء والظل إلا بما يسمح به الحدس والوجدان، هكذا ، حيث تتحرر الكلمة من أسر التعريفات القاموسية، وتتحرر الفكرة من قيود الواقع المباشر، وتتحرر الروح من ضغط المادة والجاذبية، ليصبح كل شيء قابلاً للطيران في فضاء المعنى، حيث لا حدود ولا قيود، بل امتداد مستمر نحو أفق لا يُدرك إلا بالإحساس.
فن الشعر لأرسطو هو من النصوص التي أثرت في الفكر الأدبي والنقدي عبر العصور لكنه عندما دخل إلى الثقافة العربية عبر الترجمة العباسية لم يكن تأثيره مطابقا لما كان عليه في الأصل إذ إن أرسطو في كتابه لم يكن يقصد بالشعر ما نقصده نحن العرب بل كان حديثه أقرب إلى المسرح والتراجيديا والكوميديا وذلك يجعل التصور الذي بنى عليه نظريته مختلفا عن التصور العربي للشعر فالشعر عند العرب لم يكن مجرد محاكاة للواقع كما رأى أرسطو بل كان تعبيرا فلسفيا وجدانيا يضرب في عمق التجربة الإنسانية من خلال اللغة والإيقاع والصورة ولذا كان من الصعب إسقاط مفاهيم أرسطو على الشعر العربي دون تعديل أو إعادة تفسير
الترجمة التي قام بها أبو بشر متىّ ومن تلاه مثل الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد لم تكن مجرد نقل حرفي بل كانت محاولة لاستيعاب هذا الفكر وإعادة إنتاجه بما يتناسب مع الرؤية العربية إلا أنّ الإشكال ظل قائما لأن الشّعر العربي ليس مجرد تركيب كلامي بل هو كيان مستقل يعبر عن ذاته ولا يخضع لمنطق المسرح أو الحبكة الدرامية كما أراد أرسطو لهذا فإن القارئ العربي عندما يستقرئ كتاب فنّ الشعر يجد نفسه أمام رؤية غريبة على الذائقة العربية إذ أنّ أرسطو كان يؤسس للمحاكاة بوصفها جوهر الفن بينما الشعر العربي لم يكن يوما مجرد محاكاة بل كان خلقا وإبداعا وتأملا.
هذا الفارق بين المدرستين هو الذي يجعلنا نرى الشعر العربي أعمق من أن يكون جدلا لفظيا كما هو الحال عند بعض الثقافات الأخرى فهو لا يسعى إلى مجرد تجميل اللغة أو خلق معادلات منطقية بقدر ما هو تجربة إنسانية تعبر عن القضايا الكبرى للوجود ولعل ذلك ما جعل الشعر عند العرب يأخذ مكانة النبوة أحيانا حيث كان الشاعر لسان قومه والمعبّر عن وجدانهم وليس مجرد راوٍ لحكايات درامية كما في المسرح اليوناني.
إن هذا الاختلاف الجوهري يجعلنا نفهم لماذا لم يكن النقد العربي القديم متأثرا كثيرا بنظرية أرسطو حول الشعر إلا في جوانب محدودة لأن الذّائقة العربية استمدت فلسفتها الجمالية من طبيعة اللّغة والإيقاع والمعنى وليس من الحبكة المسرحية وهذا يفسر أيضا لماذا بقي الشعر العربي محافظا على جوهره عبر العصور ولم يتغير كثيرا رغم تأثره ببعض المدارس الغربية لاحقا لأن روحه تكمن في كونه تجربة ذاتية عميقة تتصل بالوجدان لا بمسرحة الأحداث كما أراد أرسطو.
وعندما نعيد النظر في هذا التمايز ندرك أن الشعر العربي ليس مجرد فن كلامي بل هو فلسفة كاملة تتجاوز فكرة المحاكاة الأرسطية إلى فكرة الخلق والإبداع التي تجعل الكلمة ذات معنى أبدي غير مرتبط بلحظة درامية أو سياق محدد وهذا ما يجعله مستمرا في التأثير في وجدان الناس حتى اليوم.
حميد بركي


















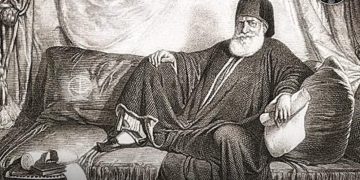


















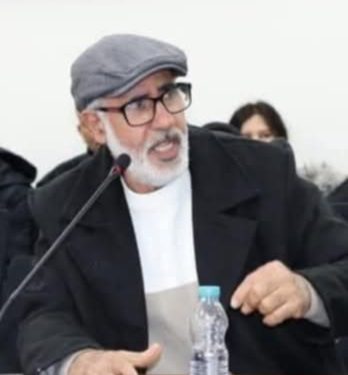

Discussion about this post