بقلم د. عبد العزيز يوسف آغا.
من الواضح أن حيزا كبيرا من الفشل الذي تتعرض له العلاقات الإنسانية يكون بسبب الكذب، ذلك أن هذه العلاقات بقدر ما تتأسس على الوضوح والصراحة، تزداد إمكانية نجاحها، لكن عندما تصبح هذه العلاقات مبنية على كذب مباشر وغير مباشر، فإن الفشل هو المصير الذي ستؤول إليه عاجلا أو آجلا، والحق أننا ومن كثرة ما ابتلينا بالكذب أصبح طبيعيا أن نستخدمه في سلوكاتنا وتعابيرنا وعلاقاتنا، والأسوأ من ذلك أن مشاعرنا بدورها طغى عليها الكذب، فبتنا أمام ما يسمى بلعبة الحب، حيث نتلاعب بمشاعر الآخرين، وبدورهم يفعلون ذلك، فنوهم أنفسنا بمشاعر مزيفة، الأمر الذي يعجل بنهايتنا في هذه اللعبة، لأن لعبة المشاعر أخطر من أن نتلاعب بها، ولأن المشاعر وُجدت لكي تكون صادقة، فكان أمر إدخال الكذب عليها بمثابة جريمة لا تغتفر، ونرتكبها دون أن نأخذ بعين الاعتبار ضميرنا -هذا إذا كان حيا- الذي سيعاقبنا لو فزنا باللعبة بطريقة خاطئة، وهي الطريقة التي سنخسر من خلالها الشخص، ما دمنا لا نبادله مشاعر حقيقية، فيكون الخسران والخيبة حليفا لنا في معركتنا المشاعرية.
إننا نمارس الكذب بدون حدود، نمارسه في حياتنا بشكل بشع، ونستخدمه لأغراضنا بشكل لا يليق، نكذب من أجل مصالحنا، نكذب من أجل تبرئة أنفسنا، ونكذب من أجل تبرئة المقربين إلينا، ونكذب من أجل تحقيق نزواتنا، ونكذب في مشاعرنا، ونكذب في صداقاتنا، وفي علاقاتنا، نكذب مع الأقرباء ومع الأصدقاء، ومع الغرباء أكثر، نكذب بكل ما ملكنا من خبث، نكذب ونحن نعلم جيدا بأن الكذب لا يليق، ونؤمن أنه يجب علينا قول الحقيقة، لكننا نتوانى خلف ضميرنا وأخلاقنا لكي نعطي عن ذواتنا وعن حقائقنا مغالطات تبيح المحرم وتحرم المباح، وتجيز الباطل وتبطل الحق، وفي النهاية نحن من يتضرر أكثر من وراء ما قلناه ومارسناه، ونحن من يصاب بالحسرة لما اعتقدنا أننا سنخسر الآخرين إذا صارحناهم، وبالتالي يستحسن أن نكذب من أجل أن نربحهم، لكننا بذلك نؤجل موعدنا مع هذا الخسران، ونربي ذواتنا على اعتناق خوف وانفصام ونفاق لا ولن يليق بشخصياتنا، ولعلنا أكبر الخاسرين عندما نقدم على الكذب.
لقد اجتمعت الأديان على تحريم الكذب باعتباره فعلا لا أخلاقيا، ولكن نظرا لما يحققه من نتائج على المدى القريب والبعيد، فإن البشر لم يكترثوا لهذا التحريم، بل لم يأخذوه على محمل الاعتبار، وجعلوا تعاملهم مع الكذب يظل طبيعيا في مجمله، لأنهم لا يعيشون تحت أجهزة كشف الكذب، وفي غياب هذه الرقابة، فإن البشرية لن تتوانى عن إتيان الأفعال غير الأخلاقية، والكذب بشكل كبير، رغم ادعاء الأخلاق كلية، ولعل هذا الأمر هو ما حاول المفكرين معالجته فلسفيا، لمعرفة الدافع الذي يجعل الناس يكذبون، ومدى وجود جانب أخلاقي لهذا الفعل الغير أخلاقي، وأنه إذا كان يمكن أن نكذب من أجل أن نحقق مصلحة عامة، أو أن نكذب من أجل أن ندافع عن قضية أو شخص يستحق هذا الدفاع ويستحق التبرئة، وهذا هو الذي يضعنا أمام إشكالية الجانب الأخلاقي للكذب، والحق أن هذا الفعل يظل فعلا لا أخلاقيا، ولا يمكن أن نأخذه من ناحية أخلاقية كيفما كان الحال، وبذلك يظل الكذب مرفوضا في جميع الأحوال.
يبدو واضحا أن فعل الكذب مرفوض تماما، لكننا لطالما اعتبرنا بأن الممنوع مرغوب، وأن الأمور الممنوعة تبقى لا أخلاقية، وكان أساس هذا المنع هو أن ما يتم تحقيقه بهذه الأمور لا يليق بالإنسان، فإن الإنسان نظرا لما ينطوي عليه من شر، لا يتوانى عن إتيان الممنوع، وذلك لما يمكن أن يحققه من وراءه من لذة أو مصلحة، هذه النتيجة أو هذا الهدف يجعل الإنسان لا يكترث للممنوع، وتصبح بذلك الغاية مبررا للوسيلة، وتصبح المحظورات مباحة للضرورة، فإذا كانت غاية الإنسان هي تحقيق مصلحته، فيمكن أن يستخدم لهذا الغرض وسيلة الكذب، وإذا كان مضطرا لإتيان أمر ما، فإن المحظورات والكذب واحد منها يجعل الإنسان قادرا على استخدام المحظورات من أجل تحقيق مصلحته. لكن كيفما كان هذا الكذب الذي يمارسه الإنسان مع الآخرين، لن يكون أسوأ من الكذب على الذات، فأن تكذب على ذاتك، فهذا الأمر بمثابة إعلان حداد على شخصيتك.
على طريق النور نسير،،،،
وعلى المحبة نلتقي،،،،




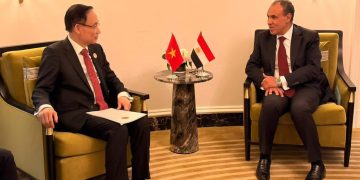

































Discussion about this post