
بقلم محمد العميسي
____________________________
الساعة تشير إلى الرابعة والنصف بعد العصر بتوقيت مستشفى كرى، في الساعة الواحد ظهراً عدت من سوق القات صوب النادي بغيّة أن أخزّن، شرعت بالدخول وانتبذت المكان وبدا كلّ شيء يمضي بروتينه المعتاد، تناهى إلى سمعي أذان صلاة العصر من المسجد المجاور، انتظرت المؤذن حتّى يقيم الصلاة وأقوم أصلي. تزامن قيام الصلاة بوقت دخول الساعة الرابعة؛ الساعة الرابعة التي تعلن انتهاء وقتي بالجلوس في النادي وتشير إليَّ أن أذهب إلى السكن لمتابعة فلماً وثائقيًا يتحدث عن إمكانية السفر عبر الزمن وتجرد الإحساس بطبيعة المكان. دلفت إلى السكن، صليت، جلست في الزاوية وفتحت شبكاك الكرفافة، ما إن فتحته حتّى بدت لي السماء غائمة، سماء محمّلة بالمطر تلبد السماء. الشمس مازالت مشرقة رغم بوادر انهمار المطر، ورغم انسحاب الوقت إلى الغروب في الخامسة عصراً، بدا المطر ينهمر على مضض، ورغم أنّه قليل لكن سقف الكرفانة المسيّج بالزنك والحديد، يعمل على تضخيم الأصوات الّتي ترتطم به.
جو المطر شاعري ويدفع المرء لممارسة طقوسه المحببّة، سواءًا دعاء وطلب المغفرة، قراءة أو كتابة، أو أيَّا من تفضيلات المرء.. قبل الحرب وقبل الكارثة، وفي زمن الطفولة الوادعة وانتفاء المخاوف والضياع؛ كنت طفلاّ صغير يلهو بحبات الحصى في ريف حجّة الجميل، يطارد الفراشات في الحقول والسهوب، يأخذ قنينة الماء ويذهب بها ركضاً إلى عمه الّذي يحرس القات ظهيرة كلّ يوم.
تستيقظ قريتنا على أصوات الديكة، وتستيقظ الحياة على جدتي الّتي تفلق الصباح بالصلاة وتذهب بعدها مباشرة إلى حظيرة البقرة والأغنام، تقدم لهم العلف والماء وتحلب البقرة وتعود بالحليب وتضعه وسط جرة خشبية نسميها بلهجتنا المحلية” الدبية” وتبدا تهز الجرة يمنة ويسرى حتى ينضج الحليب. كنت أتساءل عن جدوى ماتقوم به. كما كانت حياتنا بسيطة وجميلة!
بمجرد ما إن تشرق الشمس حتّى تطبع أولى قُبُلاتها على بيتنا، في أيام الإجازة من المدرسة تعودت أن أعبر الجرب، لأتبع خطوات جدتي. لم أكن أدرك لماذا تنبت الأشجار الصغيرة من تحت قدميها كلما سارت في الجرب؟! لا أدري لما كنت ألحق جدتي دائماً وأعرف بسرعة خطواتها وأين سارت. كانت تسير والحبل مربوط حزاماً حول خصرها، وعلى رأسها لفافة كنا نسميه خمار أسود وفي طرفه خيط أحمر، أحذيتها من النوع القديم وكنا نسميه” أبو أصبع” وله لونين أبيض وأزرق غامض.
في ذلك اليوم الّذي لحقت جدتي، تساقط فيه المطر في مشهد بكائي جنائزي لم تعرف القرية مطر مثله في تأريخها، السماء كانت تبكي بغزارة..كنت أسمع صوت الرعد والبرق والريح التي تعبث بالشجر وتصرع الشبابيك المفتوحة ويصيبني الذعر، فأحظن جدتي واختبي خلفها، طيقان بيتنا كانت تنقل لنا مشهد بكاء السماء، البرق يلمع خلف الزجاج فيرسم حبات من المطر تتهاوى كأنها تقبل الأرض بشوق جارف، على سطح الزجاج كان المطر يرسم خطوط متعرجة..كانت جدتي تحثني على النوم مبكراً كم يمتص النوم مخاوفي التي كانت تزداد كلما لمع البرق وتبعه هدير الرعد المرعب. لم يكن الرعد الذي كان يرعبني، بل كانت هناك أصوات قرقعة التنكات الفارغة التي لعبت بها الريح وطوحتها من مكان لآخر. وكانت هناك أصوات المزاريب وهي تصب الماء المتدفق من أسطح المنازل، وصوت الشجر الذي كان يتكسر أمام سياط الريح الشديدة.
تغطيت بالبطانية التي وضعتها جدتي فوقي، وغطيت بها رأسي كأنني أهرب من شيءٍ ما، وبالصميل والغصب حاولت النوم. حانت مني التفاتة خاطفة إلى أختي الصغرى أمل، كانت تغط في نوم عميق، حسدتها على ذلك وتمنيت لو أستطيع أن أسرق منها ملاك النوم، ولا مبالاتها القاتلة؛ أختي أصغر مني بخمس سنوات، وأشجع منّي بقرن!!
أربعة أيام متواصلة والسماء لاتكف عن البكاء، امتلأت شعاب القرية بالسيول، وجرفت هذه السيول في طريقها كل شيء، حملت أغنام جدتي التي نسيت أن تغلق باب الحظيرة.



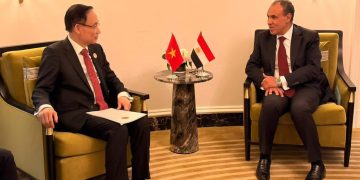



































Discussion about this post