بقلم : ا. د حسين علي الحاج حسن
كان صباحا مثلجا، والصقيع يمخر عباب الخبايا، عندما تلفح ذاك الصغير بثيابه الصوفية، وانطلق ساعياً إلى اللامكان، خرج من بيته المشلوح في سهل واسع، لا يعرف مقصده، أو اتجاه مسيره،.. فكل ما كان يريده في ذلك الطقس البارد، الحصول على مادة المازوت المفقودة من بيته،.. لأنه لا يملك ثمنها.
هو راع صغير لعائلته،.. ما خبر الحياة سابقاً، فسنه صغيرة..، لم يتجاوز الثانية عشر من عمره، .. فقد كان كل همه آنذاك،.. أن يحصل لإخوته الصغار على تلك المادة النفطية التي تشعرهم بدفئهم المفقود.
خرج من بيته، أو الأصح من غرفته المشلوحة في اللامكان والتي طواها النسيان، وبيده غالوناً فارغة،.. يحملها بيده ويرفعها إلى الأعلى كي لا تلامس الأرض،.. فاطوالهما كانت متشابهة.
انطلق الصغير وسط تلك العاصفة على غير هدى،.. بخطوات متسارعة إلى الطريق العام،.. البعيد عن بيته.. منتظراً السيارة الأولى القادمة إليه..، التي تحدد سير اتجاهه،.. فاقرب محطة للمحروقات كانت تبعد عن بيته اكثر من خمسة عشر كيلومترا..، وليس من المؤكد ما إذا كانت مفتوحة في ذاك الطقس العاصف.
أنتظر الصغير على مفرق بلدته قرابة الساعة،.. إذ لعل هنالك من يأتي قاصدا جهة ما،.. ولكن دون جدوى، ودون ان يأخذ بالحسبان كيف سيكون أمر عودته، .. حتى لو قدر له الذهاب إلى مبتغاه، فلا أمل كان يرتجى له بعودته إلى مكانه مادامت الثلوج تتساقط… إنما هو كان قد خرج من أجل أفراد عائلته التي اجتمعت حول موقد بارد … بعد أن أوهم إخوته الصغار بأنه مشتعل،.. كانوا ينظرون إلى الموقد .. يحدقون في ثقوبه مليا ويخبرونه أنه لا نار في داخله.
أنتظر ذلك الصغير على قارعة الطريق طويلا.. لكن دون جدوى،.. فعاد إلى بيته مبللاً، ينفض عنه تراكم الثلوج المتساقطة، وفي قلبه غصة حارقة،.. كان يدرك في قرارة نفسه ان الله يراه، كما هو يراه في أحلامه المكبوتة بصمته الغارق في سكون الليل والنهار… فحكايته كانت شبيهة بقيثارة الليل،.. ومحاكية لنفسه بقوله الساكن صمتا،..أنا لا أريد أن أتحدث في شيء لا أحصل منه على جواب واضح،.. ولا أريد أن اوهم نفسي بما بات من الماضي، ولا اعرف إلى أين أبغي الوصول،.. أو فيما تسوقه هذه الكلمات التي أسبكها تباعاً، إذ هالني من الأحكام الجائرة ما أنا فيه، فبدأت ارتاب بكل شيء، حتى بدأت أحاكم وجودي، بحنق مطلقاً لرأي عنانه، .. فأنا قد تحملت مسؤولية في الحياة رغماً عني،وبشيء لم أفعله، بل ومحاسبا نفسي بصمت، أخافه كثيرا… ومع هذا.. لم اتردد يومآ من الابتسام في وجه من رماني بالأسى،.. والاستماع اليه.. دون ان استرضيه..، لأن هذه طبيعتي. بل
كنت أدرك أن أحداثنا وحياتنا باتت شبيهة بحياة طيور الحبارى، التي تتميز برقصتها،.. المتمايلة حول بعضها البعض بحركات تعبيرية، لا يمكن تفسيرها،.. جراء تنقلها من مكان إلى آخر، كأنها على صفحة واسعة من الجليد، تحاكي غيرها من أبناء جلدتها، إذ يخيل لمن يراها أنها في قمة السعادة والفرح، فيما هي تسعى لأن تلتقط حركات رفاقها لتتكامل معهم… إذ ان الحقيقة تبين أن رقصة الحبارى، تكشف عن الحزن الدفين دون أن يعلم الرائي أن أعماقها قد كوتها أحزانها المتراكمة.







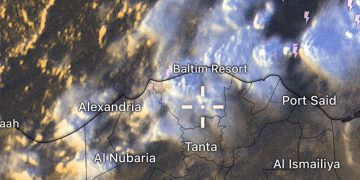










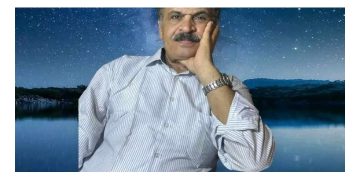






















Discussion about this post