مبارك صديقي الحبيب علي أحمد.
تقديم
منح اللهُ الشعراءَ من صفاء الشعور ما لم يمنحه غيرهم من البشر، يجيدون التعبير عن مكنونات النفوس، ويجد المتلقي في شعرهم واحًة لأفراحه وأتراحه بجانب المتعة الروحية والجمالية، ويظل الشعر – وحده – ملاذًا وحصنًا منيعًا يلوذ به الشاعر فارّاً إليه من هجير الحياة؛ فليس له غيره، يكتفى به عمَّا سواه.
“والشعر – كما يرى المازني – في أصله فن ذاتي يحاول الشاعرُ أن يرضي نفسَه به، ويتعللَ ويتلهى، إلا أن هذه الحال التي ليس للشعر فيها إلا غرض ذاتي، ولا غاية إلا الترفيه عن أعصاب الشاعر وإراحته من ثقل الفكرة التي تتحول إلى عاطفة – هذه الحال لا وجود لها إلا في العصور الأولى من تاريخ الإنسان، أيام كان يأوي إلى الكهوف والغيران، وينقش على جدرانها صور الحيوان الماثلة في الذهن المتشبثة بأهداب الذاكرة والوجدان؛ أولئك المستوحشون الذين كانوا يزينون كهوفهم بصور الحيوان والأعداء والنساء، ويوقظون الصدى في مخارم الجبال ومنعطفات الأودية بأنغامهم الشاكية الهافية، ويطفئون وقدة الوجد بالرقص في ليالي الربيع على ضوء القمر، ويترجمون عن إحساسهم بظواهر الكون في أغانيهم وأساطيرهم، هؤلاء هم أول — وآخر — من عالج فنًّا لذاته.” فلما عرفوا الشعر أصبح ترجمانا لتلك المشاعر وبيانا لمكنونات النفوس.
بين يدي حضرات السادة القراء ديوانٌ لشاعر أقل ما يوصف به أنه من جيل العظماء المحافظين على الشعر الخليليّ العريق، ولا يُفهَمُ من كلامنا أنه كلاسيكي بالمعنى المعروف الذي أُطلِق على اتجاه المحافظين من أنصار المدرسة الاتباعية في عصرنا الحديث، وكان من أخص ما يميزه محاكاة القدماء في معانيهم وأخيلتهم بل ذهب الأمر بهم إلى أبعد من ذلك فنسجوا قصائدهم كما فعل القدماء وكأنهم يعيشون في بادية العرب؛ بل إنه – وهو صنونا في المنهج – كافرٌ بكل ما يطلق عليه شعرًا خلاف شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد يصيح معترض: كيف وبين دُفَّتَي ديوانه الذي تخطّ مقدمته نموذج مما كفرتم به؟!
وجوابنا على هذا الاعتراض الوجيه: كتب شاعرنا ما كتبه على طريقتهم؛ ليبرهن لهؤلاء أنه يستطيع القول مثلهم وعلى طريقتهم؛ سخريًة وقدحًا في أذواقهم، كما يدل على ذلك ما ذكره بين يدي هذا النص: ” نحن من الذين لا يرون الشعر إلا ما كُتِب موافقًا قواعد الشعر العربي وأصوله، أما ما عداه فهو ضرب من النثر ما بينه وبين الشعر بون شاسع، يقول شاعرنا بين يدي أحد نصوصه:
وهأنذا أكتب هذه التفعيلة ولا أسميها شعرًا بل ردًا عليهم
ولذلك أسميتها (عبث التفعيلة ولص القوافي )”، تراه يسخر من هذا الضرب من القول:
هذا يقول: بأنني
أنجزتُ ألف قصيدةٍ
وتقول:
ما خطت يداي مجافيًا
صرح القريض
ولا يشاركه الصلةْ؟
أوليس في دنيا القريض
سِواكمُ
أم أن أوزان الكلام
بغير أحمدَ مائلةْ
لكنه يقدم لهم رؤيته بالسخرية نفسها:
من قال إن روايًة أو قصًة
أو نفثًة أو دونها شعرٌ بغير قوالب
غير الذي عجزت قواه
قواعد الشعر الرصين
وجاء ينفث لوثة
سماه بالشعر الجديد
نقول: إن على أحمد شاعر من طراز الكبار المحافظين على الشكل الخليليّ؛ بيد أن له نفَسًا شعريًا مميزًا، ولغًة شديدةَ الخصوصية، وهي التي أطلق عليها شيخنا العقاد اللغة الشاعرة ” إنما نريد باللغة الشاعرة أنها لغة بنيت على نسق الشعر في أصوله الفنية والموسيقية، فهي في جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات، لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه، ولو لم يكن من كلام الشعراء.
وهذه الخاصة في اللغة العربية ظاهرة من تركيب حروفها على حدة، إلى تركيب مفرداتها على حدة، إلى تركيب قواعدها وعباراتها، إلى تركيب أعاريضها وتفعيلاتها في بنية القصيد.”
لا ينظر شاعرُنا لبنية البيت وحده منفصلًا عن بقية أبيات القصيدة كما يفعل كثير ممن يظنون أنفسهم حمَلةَ لواء الشعر والمدافعين عنه، يعتقدون أن الله خصهم بهذا الفن دون سائر خلقه، فطفقوا يستعرضون مواهبهم في غزو المعاجم والمواقع الالكترونية التي تقدم لهم وجبًة دسمًة من الألفاظ دون وعي أو فكر فيجئ نظمهم آية في الإلغاز؛ إذ لا يجمع بين القصيدة إلا نغمة بحرٍ واحدٍ وإيقاعِ رويٍّ موحد، وحسب الناظم منهم أن يلفق في قصيدته تلك التلفيقات، فإذا تم له ذلك فهو شاعر الشعراء وحامل اللواء وتبًا للموهبة، وعفاءً بعد ذلك على الأذواق، وهل للناس عقول؟!
تقرأ لهؤلاء نصًا محاولًا إيجاد ما يربط بين أبياته – غير النغمات التي تتردد بانتظام – فلا تجد، وليس هذا بشعر الخلود، فليعلم هؤلاء النظّامون ومَن على شاكلتهم أن ” القصيدة الشعرية – كما ذكر العقاد – كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته، ولا يُغْني عنه غيره في موضعه إلا كما تُغْني الأذُنُ عن العين، أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة. أو هي كالبيت المقسَّم، لكل حجرة منه مكانها وفائدتها وهندستها، ولا قِوام لفن بغير ذلك، حتى فنون الهمَج المتأدبين، فإنك تراهم يلائمون بين ألوان الخرز وأقداره في تنسيق عقودهم وحليهم ولا ينظمونه جزافًا، إلا حيث تنزل بهم عماية الوحشية إلى حضيضها الأدنى، وليس دون ذلك غاية في الجهالة ودمامة الفطرة. ومتى طلبت هذه الوحدة المعنوية في الشعر فلم تجدها؛ فاعلم أنه ألفاظ لا تنطوي على خاطر مطرد أو شعور كامل الحياة، بل هو كأمشاج الجنين المخدج بعضها شبيه ببعض، أو كأجزاء الخلايا الحيوية الدنيئة لا يتميز لها عضو ولا تنقسم فيها وظائف وأجهزة، وكلما استقل الشيء في مرتبة الخلق صعب التمييز بين أجزائه؛ فالجماد كل ذرة منه شبيهة بأخواتها في اللون والتركيب، صالحة لأن تحل في أي مكان من البنية التي هي فيها، فإذا ارتقيت إلى النبات ألفيت للورق شكلًا خلافَ شكل الجذوع، وللألياف وظيفة غير وظيفة النوار، وهكذا حتى يبلغ التباين أتمه في أشرف المخلوقات وأحسنها تركيبًا وتقويمًا، وهي سُنة تتمشى في أجناس الناس كما تتمشى في أنواع المخلوقات، ومصداق ذلك ما نشاهده من تقارب الأقوام المتأخرة في السحنة والملامح، حتى لتكاد تشتبه وجوههم جميعًا على الناظر، وهي حقيقة فطنت إليها قبائل البدو بالبداهة”
على أحمد شاعرٌ مطبوعٌ يدرك أن ثمّ فرقًا بين الشاعر بوصفه ترجمان المشاعر؛ بل هو من يرصد أخص المشاعر الإنسانية وأعمقها وبين البنّاء والمقاول الذي يحسن رصّ الحجارة وتصميم البيوت، فإذا لم يكن فرقٌ بين الشاعر والبنّاء فلَعمري إنها طامة كبرى وجريرة لم يَجْنها على فن العربية الأول إلا زغل النظّامين وأنصاف الشعراء.
يُعنى صديقنا برصد ما يشعر به ويعتمل في نفسه من أحاسيس ومشاعر، في وحده فنية محكمة، يترجم ذلك كله في صورة بديعة لغًة وموسيقًى وخيالًا، وتنظر في شعره فيبهرك ذلك الرابط النفسي والشعوري الذي يجمع بين القصيدة في لغة سلسة وموسيقى طروب، فتأتي قصائده لوحاتٍ فنيًة تنطق بهذا الجمال، فيها ماء الشعر ورونقه وجلاله وبهاؤه.
يؤمن شاعرُنا برسالة الشعر ودور الشاعر في الحياة إيمانًا من شأنه أن يعمِّقَ إحساسه بالمسئولية التي يحملها، يلخِّص ذلك في قصيدته (الشاعر):
إنني رُوحٌ وطيفٌ قد سرى
في رحاب الكون نورًا مُبْهرًا
إنني وحي نبيٍّ لم يزل
يزرع الإيمانَ في قلب الورى
ينبت الآمال والحب الذي
إنْ نما بالليل أضحى مُسْفِرا
ينزِع الأحقادَ من نفسٍ هوَتْ
في ظلال الشك أو تحت الثرى
فالشعر عند صديقنا رسالةٌ ساميةٌ، يسعى لها ويحارب لأجلها.
وتتنوع قصائدُ الشاعر في هذا الديوان، وتتنوع معها بحورُه الشعرية، ومن الملاحَظ أنه يختارُ بحورًا ذواتِ موسيقى طروب مثل البسيط والرمل والخفيف ..
وذلك راجعٌ لأسباب نفسية لدى علي أحمد؛ فطبيعته – كما نعرفها – ترنو للجمال والرشاقة؛ فهو دومًا ذو نفسٍ مرحة وإن كان يحمل بقلبه حزنًا دفينًا، ولعل ذلك كان السبب في إحيائه لفن الموشحات، ذلك الفن الذي نشأ في الأندلس لأسباب اجتماعية وفنية تعود في جملتها إلى الميل للموسيقى، ومهما كان من الآراء حول نشأة الموشحات، فإن ما يعنينا هنا هو أن صديقنا قد استهوته موسيقى الموشح التي تناسب روحه التي تميل كل الميل لتلك الموسيقي، يقول علي أحمد في موشحه (يا قاتلي):
يا قاتــــلي، عجبــــــــــًــا، مما جرىٰ
قد كنتَ لي ، سببـــــًا ، دون الورىٰ
أضنيتَني ظالمي فصرت كالمعدَمِ
قد كنتَ لي عالَمي حتى أرقت دمي
سرىٰ بلا عاصم فى لجة المغرَمِ
شكوتُ من آثمِ و هجرِه المؤلمِ
أتحبني؟! كذبـــــــــــــــًـا، ما يُفترىٰ
أسقيتَني نَصَبـــــــــــــــــــًـــا مدمـِّــــرا
رفقا بنا واهتدي. يا جنة المطلبِ
فأنت يا مقصدي. فى الشرق والمغربِ
روحي وما ترتدي فكيف بالمهربِ؟!
أراك لا تعتدي إلا على المعجِبِ
تلومني ، غضبــــــــــــًـا، مزمجــــــــرا
تظنني ، مذنبـــــــــــًـا ، مستهتـــــــــرا
ولعل القارئ الكريم يلحظ في ديوان صديقنا سمًة يمتاز بها، وهي سمة أصلية جُبل عليها، ونعني بها الاعتداد بالنفس في غير تكبر؛ فليس هو ذلك المنتفخ كالطاووس زهوًا بنفسه وإعجابا؛ إنما هو شديد الاعتداد بنفسه وفنه – حتى في حبه – وقد يرى بعضُ الناس أن المحب لا يعرف تلك السمة من الاعتداد بالنفس؛ ” فالناس إذن خليقون أن يهتموا للشاعر أو الكاتب الشديد الاعتزاز والاعتداد بنفسه. وقد يهتمون له أكثر من اهتمامهم لشاعر أو كاتب آخر أقل اعتداد بالنفس وأكثر هبات عقلية ونفسية، فليس اهتمام الناس للشاعر أو الكاتب إذاً على قدر هباته العقلية وحدها كما يظن المعجبون به الذين يستهويهم اعتداده بنفسه”
تبرز تلك السمة في قصيدته (ما عاد في سفني مكان):
ما عاد في سفني لمثلك موضعُ
فدع البكاءَ فليس بعد الآن يغني
حتى بكاء المحبوب لا يجدي مع عاشقنا فثمّ اعتداد شديد بالنفس يمنع صاحبنا من الانخداع بتلك الدموع.
وتزداد تلك النغمة وتتحول تحديًا للجراح والمتاعب؛ فلا يعبأ بما يمرّ به من صعاب ومحن فيتحدى كل ذلك متفائلًا كما في قصيدته (فوق الجراح):
تبسم فالحياة بك ابتسامُ
وإن تعبسْ فليس بها مقام
دعِ الأقدارَ تجري كيف شاءتْ
فمن مَلَك الرضا وُهِبَ السلامُ
وإن كانت همومُ المرءِ شُمَّا
وموجُ الحزنِ يعلوه الغَمامُ
ففي فيضِ الكريمِ لها سفينٌ
إلى شطِّ النجاةِ ، فمن يُضامُ؟
وفي شعر صاحبنا تعبيرٌ صادقٌ عن عصره؛ فليس الأدب بمعزَل عن الحياة ” والشعر العصري كهذا الشعر في أنه شعر الطبع، وأنه أثر من آثار روح العصر في نفوس أبنائه، فمن كان يعيش بفكره ونفسه في غير هذا العصر، فما هو من أبنائه، وليس خواطر نفسه من خواطره.
تمر على صفحة الزمن عصور خابية، لا تسمع لها حسًّا، ولا تختلج العين من جانبها بقبس، ويكاد يكون الفلك قد قذف بها من جوفه ميتة، فهي من لحدها في مهد، ومن مهدها في لحد.”
وبعد -أيها القارئ الكريم- فأنتَ واجدٌ في هذا الديوان الجدةَ والطرافةَ والمتعةَ الفنية، وتجد تنوعًا في الموضوعات والموسيقى، كما تجد معجمًا شعريًا خاصًا مميزًا، وكلها تنتمى للشعر الذاتي إن لم يكن الشعر في عمومه فنًا ذاتيًا، وكذلك يجب أن يكون.
عمرو الزيات
القاهرة 6 / 11 / 2020



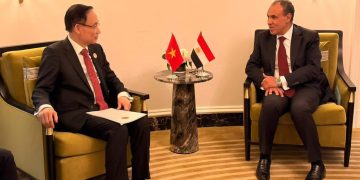



































Discussion about this post