ليلة القبض على الغياب:
بعد القبض عليه بتهمة الإجهاد وقتها، حيث قضى أياما نال فيها ما ناله من صمت مطبق في مطرح منعزل، خيل إليه أن ليس في هذا العالم سواه، فأسلم ذهنه للتكفل بقلق السؤال حول ربط الموت بالليل والسجن والضياع، حيث يحضر الجسد وتغيب الروح، وحيث تشخص الأفعال وتغيب القيم، وحيث تبدو الرومانسية وتغيب السياسة.
فبالنظر إلى الإنسان، من حيث ما ينبغي أن يكون عليه وعلى النقيض مما هو عليه، أيعقل أن يكون مستمرا في التأرجح بين الحضور والغياب بعلة ما أنتجه من أساطير ويحمله من فلسفات شاملة وعلوم دقيقة، أم أن للألفة والغرابة والقرب والبعد دخل في الموضوع؟
اقتيد بعدها إلى حيث يمكن للشرود أن يتكفل بكسر روحه، وحيث ينال حظه من أمراض لم تطل غيره ولم تجد من مأوى سوى كهوف نفسه المظلمة، وحيث ينطلق في سبر أغوار التنقل بين الهشاشة والقداسة والشر كعناوين لإفقاد الأمل والكف عن الحياة.
تافهة هي الحياة وعبثية وغامضة، لا تستحق الحرص وملاحقة السراب، في ظل عدم التخلص من الجرائم والحسابات الضيقة والحروب المدمرة. وكثيرة هي الأخبار الموجعة المقرونة باتساع مساحات الجشع وكبر حجم مراكمة الثروات وكثرة تواجد قناصي الفرص. وعالية هي أصوات المطالبة بمنع التفكير لعدم الإساءة إلى المتنفعين.
أولم يسعف الواقع والمعيش اليومي في امتلاك البصيرة والقدرة على التأمل، وتحديد الغرض من انبثاق مفهوم جديد للإنسان؟ أم أنهما لم يقويا سوى على شنق الوجود بمقصلة التسلط واستخدام النفوذ؟ أم أن البحث عن الأحسن والأفضل لا زال معاقا بعدم القدرة على صناعة الاكتمال؟ وكأنه ما صار للحضور بصمة ولا للغياب عنوان.
كان بالإمكان للأمكنة أن تتحدث بذاتها بدلا من أن يتحدث الإنسان، فقد تكون عيناها شاهدتان على ما لم يسجله من حضور كسمة مرئية، وترقبه من مظاهر غياب كظلال كثيفة عميقة وغائرة قابلة للتحسس والاستشعار.
وقبيل تنفيذ حكم الخصي، وحيث القيد سلاسل من التفكير في الهشاشة والفقر وخرق كل المواثيق، وحيث التكبيل بأصفاد التعاليم والأعراف والعادات والمستحدثات، وحيث اللجم بخذلان الصحبة ورفقة الدرب في العبور إلى الضفاف الوارفة، انتفض للتساؤل من جديد.
ألا يستحق البشر الخروج من حالته البدائية التي لا تميزه عن الحيوان في العيش والتكيف والألفة، وتجعله يحدس لحظته وتميزه بحضور الذهن والتطلعات وباتساع العالم أكثر مما تصوره بكثير، لولا صعوبات النظم والعلاقات؟
ما أحوج إنسان الحاضر إلى التناسب بين التطور والحركية المطلوبة، والتناغم بين حضور وغياب الحاجة وغريزة حب البقاء، من أجل الحصول على خرافته السحرية المفارقة للواقع، والكشف عن رغباته المكبوتة وتطلعه للكمال المفقود في المعرفة والحكم، وزرع أفكاره وأوهامه في اللاحق ممن سيحضر بعده.
وما أحوجه لحضور صورته في الحس المشترك، وعدم الاحتفاظ ببقائه كصورة متخيلة مستعصية على الاستيعاب إلا من خلال الغياب. وليت تطهيره صار ممكنا لتجسيد الاهتمام بالأرض قبل السماء، وليت الفضيلة وفكرة الخير لذاته أنبتت رؤى وتصورات لمعرفة الذات والخروج من الهوامش وتخوم الأحداث وإنتاج ما يساعد على القطع مع الشر والحماية من الفساد وتحقيق الآمال.
وعلى ما يبدو، تلك سمات ولادة الحقيقة الكامنة في استحضار الغائب حين يعلن الحضور انطلاقه في الراهن والعابر، وحين تخرج الذاكرة عن دائرة النص لتكشف عن جمالية ما وراء الحاضر. فما عادت العين تبصر سوى ذاك الواقع المنتظمة فصوله إلا الربيع، ولا تتبصر غير الموت القادم من خريف لا يلفه غير الجليد.
ألا ليت الحياة تخرج من كمونها في صلب الموت، وليت الغياب يعجز عن جذب ما تبقى من حضور، كي لا يتراءى نسق الحياة وهو ينحل بتعدد الصور وباستدعاء الحياة لعالم آخر، حيث يفترض أن لا مجال لرؤية القسوة والظلم.
وبعد الحسم الذي خيب الأمل في تحقق المراد، تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم قابلية القانون للتحلي بذرة من الإنسانية فبالأحرى أن يسند حلم الإنماء، وأن الدعم ستتواصل مسيرة استدامته لشنق الأبرياء، وأن الإعدام لن يكون مخصصا سوى للفقراء والعقلاء فاقدي الوزن والقوة.
فكرة الانقراض ستبقى محور الأخذ والرد بين ما هو قائم بين الكراهية والأخلاق من مفارقات في الممارسة، بالرغم مما يمكن للكلمات بناؤه من جسور للوصول إلى مناطق مجهولة وما يمكنها أن توقظه من إدراك ووعي، لولا كونها لا تجد دوما سوى من يتغافل لأغراض ما عادت تخفى على الجميع.
لم يعد يرى إلا أشياء هنا وهناك، فيتساءل هذه المرة بدون قلق عما يحدث بالفعل. وينتبه إلى أن القليل من يعرف بعض ما يجري ولو بدون تفاصيل ويسعى إلى التفرد والتصرف وكأنه أمام تحولات معزولة لا تشكل مصدر إلهام لفعل جماعي.
فتوسيع نطاق العطالة وتكديسها بالمقاهي، والتراجع عن تقديم الخدمات، وتوقيف المساعدات، وعدم إيواء غير المستظلين، والاتجار بالتنشئة والمرض والعجز، ومص طاقة العمل وعرق الجبين، ونشر التفاهة والرعب في الشوارع والأزقة، ما عاد يثير قلقا ولا رغبة في التفاعل بما يليق.
قد نفتقد إطلالاتنا الجميلة والساحرة على محيطات العيش بعد انتقالنا إلى مستقرات جديدة، فندرك بشكل متأخر أن الحياة يحكمها منطق التغير والتبدل، ويزكيها فعل التحرك والتدخل. وقبلها، قد نتوصل إلى حقيقة أن الشعور بالفخر والاعتزاز وما قد يبثه من حيوية وحماس يمكنه أن يكون سبب اختفائنا في ظروف غامضة، ودون أن يلوح لنا أحد بيده لحظة الوداع.
نغرق حينها في التحقق من فرضيات العلاقة بالاختفاء، والتحقيق في شأن الوصول إلى مكان وزمان حصول الجرائم وملابسات وقوعها، التي لا تخرج طبعا عن نطاق وحشية النزعات الشريرة والخبيثة، العاجة بالحقد والضغينة وغير القابلة للضبط والكبح والقهر.
مخز هو ذاك الإحساس بالأسف تجاه غير المبالين بفرح الآخرين، ومقرف هو غياب الاعتناء والرعاية المتبادلين. لكن الأشد خزيا وقرفا هو تسلط إرادة التحطيم فيما هو سائد من علاقات.
أن تكون محاصرا بين من يجتهد ليراك من الداخل بغية قطع طريقك أو إجلائك، وبين من لا يبذل أي جهد ليراك بالأساس، فذاك ما بإمكانه دفعك إلى اختصار مفهوم الموت في التخلص من دفع فواتير السكن والطاقة وتعليم الأولاد وأداء كل ضرائب التخلف المتعارف عليها وغير المصرح بها.
فما كانت السعادة يوما إلا تعبيرا عن الرضى والاكتفاء المتميز بتلك المشاعر المرغوبة لا غير. وبهذا المعنى البسيط وغير المعقد تمنى الإنسان لو أنها تنتقل بالعدوى داخل الأماكن والفضاءات بين الأزواج وأفراد الأسرة والجيران وزملاء العمل والأصدقاء، وأن تستمر لفترات طويلة وتتجدد باستمرار، لتعم إلى الأبد.
بل ما كان للإنسان من تعلق سوى بالشعور بقيمته في الوجود وبمعنى لحياته وبامتلاك مقومات عيشه وتحقيق اكتفائه وتحصيل متعته وراحته عن طريق كده وسعيه والاستمتاع بعلاقاته في تقبل وسلام وانسجام.
فما الذي ألقى به في بحر لا وجود فيه لعوائق إلا ذاته؟ وما الذي أجبره على الغرق في معادلة ترك نفسه بين ما يحبه الآخرون وما يكرهون؟ أليست هذه سمات التلاشي ومواصفات من أصبح بلا ملامح؟
هل أحس البشر يوما بتلك السعادة التي يشكلها حسب رغبته وكما يحب؟ هذا هو السؤال. حيث يتضح أنه ما كان ليضفي على السعادة تلك الخصائص السلبية في تمنعها على الناس إلا الأحاسيس والمشاعر السلبية للإنسان الذي يتجاهلها كما يتجاهل الصحة في حال التمتع بها كاملة ويتعامل معها بسلبية إلى أن يصاب بالألم ويغرق في البؤس، وكما يتجاهل الحرية في حال عدم القبض عليه.
ليت الجميع يجرب تجنب الألم قدر الإمكان، ويحس بالإشباع والملذات والمسرات والصفاء والتجدد، ويلتزم سبل التمتع وتقدير الخيرات والنيل من حظوة الحياة دون أن يكون ذلك على حساب الآخرين ودفعهم إلى الشعور بالجوع والعطش والمضاضة والهم والملل.
ألهذا الحد صار الإنسان يتلذذ بإحساس لدغ الآلام ويهجر الشعور بإمتاع الذات؟ أيعقل أن تكون هذه المدركات هي علل التوجه بالشكر لله؟
ما كان الخلاص يوما ولا قهر المخاوف التي تشل الحياة يحلق عاليا اعتقادا أو فكرا، وما كان إبعاد الخوف من الموت وطرد تفاهة اليومي دوما خارج مدار العيش الذي ما عاد مشتركا في كل المناحي وعلى مختلف الواجهات.
وما الحياة في كل لحظات عيشها مجرد تأمل أو استغراق في التفكير لرؤية العالم وتفسيره، بل هي شديدة الارتباط بالاتفاق على مجابهة الفناء منذ بدء الوجود، حيث يكمن المعنى والمآل المقترنين بالإنسان كمنبع ومصب للتجربة والحكمة وكمناط للتحكيم.
فلا الإيمان الأعمى ولا عقائد الخلاص الكبرى تقرب إلى الحكمة وفن العيش وتوفق بين الوضوح والعمق في قضايا إلغاء اختيار قهر الخوف من الموت والقدرة على التآلف مع الكينونة وتقديس الآخر، ولا هي مندورة لتفادي خلود كائنات الحياة الفاشلة.


















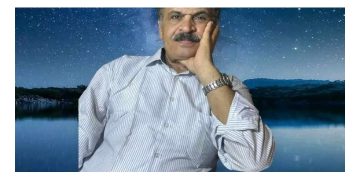


















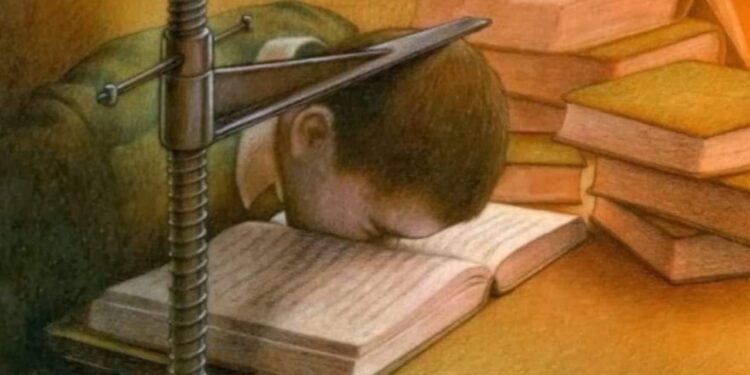



Discussion about this post