بقلم دكتور …
عاطف معتمد
قرأت هذا الاسم أول مرة في عام 1988، في دروسي الجامعية قبل التخرج، حين كنا نطالع خريطة سيناء ومواقع التعدين فيها.
حيرني الاسم ولم يهدني البحث إلى معنى مقنع. وزاد من حيرتي أنني في طفولتي كنت قد سمعت سبابا لأحد سكان شارعنا يصفه أحدهم بـ “أبو زنيمة”.
لم تفلح زيارتي الأولى إلى سيناء في عام 1995 في أن تمنحني شيئا عن حقيقة المكان، ولم ألمس صخوره وأجلس على حصباء شاطئه متدبرا في المعنى والمغزى، لقد كانت رحلة سريعة مرت بكل مكان في سيناء من عيون موسى إلى الطور وشرم الشيخ وصولا إلى طابا وذكريات “أم الرشراش”.
ثم جاءت الفرصة في عام 2007 حين وقعتُ في هوى المكان وصار جزء من حياتي، بل إنني أستطيع القول إنني لم أعد أشبه ذلك الباحث قبل ذلك التاريخ.
لما لا؟ أنت لا تعرف ماذا تفعل سيناء من سحر في الناس، في العابرين، والمرتحلين، والمقيمين…. والغزاة ؟!!
أبو زنيمة ميناء لتصدير سبيكة الفيرومنجنيز أي المنجنيز المطعم بالحديد. بدأ التعدين منذ زمن الاحتلال البريطاني نهاية القرن 19 ومطلع القرن العشرين.
الإنجليز الذين جاءوا لاحتلال مصر اهتموا باعتبار بلادنا جسرا إلى الهند.
لا تصدق ما يقوله البعض من أنهم احتلوا مصر لأن مصر عبقرية، عبقرية مصر هنا هي “عبقرية المحطة” للوصول إلى الهند.
اهتم الإنجليز بسلب ثرواتها المعدنية التي يجهلها المصريون، ولا سيما خامات المنجنيز من جبال غرب سيناء.
كان علم الآثار هو الهادي لعلم الجيولوجيا الاقتصادية، فحين توصلت الأبحاث الأثرية إلى مواقع التعدين المصري القديم منذ الأسرات الأولى في سيناء اهتم الاستعمار الأوروبي بالبحث عن مزيد من الثروات للصناعة.
في تلك الفترة كان الجيولوجي والجغرافي الإنجليزي الشهير “جون بول” قد سافر إلى سيناء وأعد دراسة وافية عن غرب وسط الإقليم تمهيدا للاستثمار الصناعي.
حين وصلت أبو زنيمة وتوغلت في وديانها رأيت بعضا من روافع التليفريك المعلق في السماء من آثار 100 سنة مضت. لقد جلب الإنجليز معهم تليفريك يأخذ الخامات من رأس الجبل وينزل بها إلى ساحل خليج السويس في نقلة تكنولوجية مبكرة في العالم.
خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 صارت أبو زنيمة قبلتي ونسيت معنى الاسم وسط زحمة الصخور والصناعة القديمة والوديان والمنحدرات الوعرة وحبات التركواز المتناثرة منذ الحضارات القديمة.
وذات يوم، وبينما أعود من هضبة سرابيط الخادم – حيث معبد حتحور الشهير المجاور لاستخراج النحاس منذ عهد قدماء المصريين – نزلت إلى البلدة القديمة على البحر حيث أبيت كل ليلة.
كانت الشمس تنغمس في هدوء في مياه خليج السويس مؤذنة بنهاية اليوم وواعدة باللقاء في صباح الغد من الجبهة الأخرى من فوق سرابيط الخادم.
كانت الرياح تحمل أدخنة المصنع وتلقي بها على بقايا مقام ومسجد قديم، فإذا بالدليل البدوي – عم سلمان سلامة – يتمتم في نفسه قائلا:
“والله لم ينزل عليكم الخراب إلا بلعنات أبو زنيمة”
نظرت إلى سلامة مندهشا…وانتبهت كما لو كان “أبو زنيمة” حي يرزق.
يفسر الشيخ البدوي تراجع إنتاج المصنع وتدهور التنقيب على الخامات إلى ذنب أبو زنيمة !
مضى سلامة يخبرني أن البلدة وقبل أن يأتي الإنجليز بزمن بعيد وقبل أن يبدأ التعدين فيها، اتخذت اسمها منذ القدم تيمنا باسم الشيخ أبو زنيمة.
عوادم المصنع التي نزلت على مقام ومسجد أبو زنيمة وأضرت به جعلت المكان غارقا في الرماد والسخام والغبار ولم يعد أحد يسأل عنه ولا يهتم به.
“نزلت لعنات الولي الصالح على المصنع فتوقف عن الإنتاج”.
هكذا بكل بساطة وجد سلامة تفسيرا حاسما وإجابة نهائية للموقف الجيولوجي والصناعي في المنطقة.
في صبيحة اليوم التالي انطلقنا بسيارته المتهالكة نحو الشمال، كان الرجل يقود السيارة التيوتا وكأنه يركب ناقة، يساعدها في الصعود بأن يهز مقود السيارة، أو يحدثها بكلمات مشجعة، أو ينزل عليها غضبه في مواقف التعثر الأخرى.
وبينما أراقب الرجل الخمسيني وهو يكلم سيارته كما كان يكلم الناقة في مطلع شبابه تذكرت خلال عملي بدولة عربية شقيقة كيف استفاد الناس من عائدات النفط واشتروا “الأوبل” بدلا من “الإبل”.
في طريق صعودنا للجبل بعد أن ودعنا أبو زنيمة مررنا بمقام لشيخ اسمه “أبو جعدة”.
مضى سلامة يحدثني عن ذلك الشيخ الذي كان يمشى على الماء في خليج السويس فقلت له إن هذه القصة نفسها سمعتها في مومباي عن الشيخ “حجي على بابا” الذي زرت ضريحه فرأيت آلافا من المريدين من الهندوس والمسلمين على السواء.
لم يصدقني سلامة واستخف بكلامي وقالي لي ” بل إن أبو جعدة وأبو زنيمة هما الأصل وكل ما في الهند والسند نسخة مكررة من عندنا”.
أكملت السيارة المتهالكة رحلتنا ووصلنا إلى جبل “وطا” وهو كتف ممهد خفيض في هضبة عالية تفضي إلى صحراء التيه فقال لي سلامة مفتخرا “لقد انحنى الجبل لسيدنا موسى وانخفض ليعبره وقومه بعد هروبهم من مصر، ومن هنا جاء اسمه “وطا”.
مع شمس المغيب، عدنا أدراجنا إلى أبو زنيمة، مرت الأيام خلف الأيام، والرحلات بعد الرحلات، وبقيت أبو زنيمة اسما ملغزا، يدفعنا إلى التفكير في كل شيء عن الحجر والبشر في سيناء.
سيناء التي لم نأخذ منها إلا كما يأخذ المخيط حين يغمس في ماء البحر.


















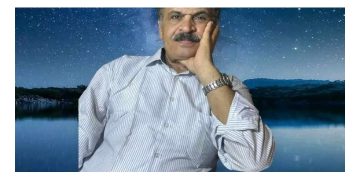























Discussion about this post