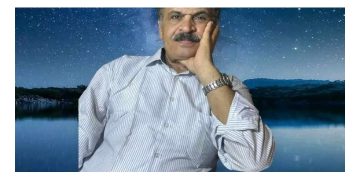تحاوره : سلمى صوفاناتي
في حضرة الجمال، حيث تُضاء الروح بوميض حلم لا يخبو، تتخلّق اللحظة من طين الزمن الطريّ لتغدو صفحة موسيقية تلمع بعتيقٍ لا يصدأ. هناك، في النقطة التي يلتقي فيها الصمتُ بقدرِ النغمة، وُلد لحنٌ صغير يشبه طفلاً خجولاً، ما اكتمل جبينه إلا بذلك النداء السرمدي الذي يشق طبقات السكون ويوقظ القلب كما توقظ النسمةُ غصنَ الورد.
خلف هذا المجرى الصوتي المهيب، يقف رجل صنع لنفسه قداسةً خاصة؛ فنانٌ لم يتخذ الفن مطيّةً عابرة أو تجارةً رخيصة، بل نذراً أبدياً يُؤدّيه كما يؤدي المُصلّي صلاته. رجلٌ لم يدخل إلى سوق المساومات، ولم يرضَ أن يُقايض جوهره النفيس برياحٍ تهبّ وتخبو، فظلّ صامداً في وجه تبدلات الزمن، متمسّكاً بتلك الأبجدية الطاهرة التي كتب بها أولى نوتاته.
هو الملحن والمطرب الذي لم يكتفِ بارتشاف المعرفة رشفةً يتيمة؛ بل غاص إلى الأعماق، وسكب سنوات عمره زيتاً يشعل مصابيح البحث في أسرار الصوت والإيقاع. حمل فجر طموحه ورحل إلى القاهرة، ممسكاً بخريطة تبحث عن الوتر الأعمق، عن سرّ الموسيقى الذي لا يُقال بل يُكتشف. هناك تهيَّب العلم، وتزيّن به، ثم عاد إلى الشام… إلى مهد النغم الأول، عائداً بتاجٍ موسيقي يليق بملحمةٍ لا تُكتب كل يوم.
غدا جسراً من ذهب لا يصدأ، يصل بين جلال الغناء المتجذّر في الذاكرة وإتقان التلحين الشاهق وفتنة الموسيقى التصويرية الآسرة. ينتمي إلى مدرسةٍ فنية ترى في الفن شرفاً لا يُمسّ، وفي التراث هويةً لا تُباع، وفي الجذور وعداً لا يجوز التخلّي عنه مهما تبدّلت الأزمنة
س: لنبدأ من البدايات… من تلك اللحظة الأولى التي وضعتكَ على طريق الفن، كيف تكوّنت البذرة الأولى لمسيرتك؟
_ذهبتُ إلى مصر وأنا في الخامسة عشرة من عمري. درستُ في معهد موسيقي إيطالي فنَّ العزف على البيانو، كما التحقتُ بالمعهد الشرقي، معهد الفؤاد، لدراسة العود الشرقي.
كان للمعهد حديقة واسعة تجمع نخبة مطربي وملحّني مصر وكبار كتّابها. كنت أجالسهم، يسمعونني وأسمعهم، وكانوا يغنّون في تلك الجلسات ويعزفون ألحاناً عالمية. كنت أعزف العود وأغنّي، وقد نال صوتي وإيقاعي إعجاب الجميع. ومنحني الملحن الكبير بليغ حمدي كنيته لما لقيه في صوتي وشخصيتي من إرهاصات تنبىء بولادة نجم كبير.
أقمتُ أولاً عند بعض أقربائي، ثم أكرمني الله واستأجرتُ بيتاً مستقلاً لأتابع دراستي. في ليالي القاهرة كنّا نعود إلى تلك الحديقة في معهد الفؤاد، فنلتقي بالنجوم والكتّاب والملحنين. كانت أشبه بـنقابة فنية غير معلنة. بعض المقرّبين كانوا يأخذوننا إلى الإذاعة لمقابلة المطربين الكبار، إذ كانت الإذاعة تفتح أبوابها لاكتشاف الأصوات الجديدة. كذلك كان هناك معهد يشرف عليه الراحل محمد الموجي، يجتمع فيه الشباب أصحاب الأصوات الواعدة ليختبر قدراتهم.
غنّيتُ حينها كورساً خلف أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، شادية ومحمد فوزي. بالتوازي كنت أهوى الأغاني الهندية، وكنت أذهب إلى السينما أربع مرات في اليوم. وهناك تعرّفت على شخص يدرس اللغتين الهندية والباكستانية، وساعدني على تعلم عدة لغات وكان هذا اللون الغنائي أحد الألوان المفضلة لدي .
س: وهل كان للفنانين الكبار دور في اكتشافك؟
نعم. سمعني الفنان عبد العزيز محمود، فقال لي بلهجته المصرية: “دِنت مصيبة… دِنت فنان!” واصطحبني إلى مكان لا يدخله إلا كبار الدبلوماسيين. كنت مختلفاً عن باقي المطربين: حركاتي الاستعراضية، لباسي، أدائي… كلها منحتني نكهة خاصة. وهناك حصلتُ على أول سهرة فنية خاصة.
في تلك الفترة كنت أبحث عن كلمات يكتبها كبار الشعراء المصريين: محمد حلاوة، عبد الوهاب محمد، محمد حمزة رحمهم الله جميعاً. وبدأتُ التلحين للنصوص المصرية. كما لحّنت فيما بعد لنجيب السراج، وعدنان فاضل صادق، وغيرهم من الفنانين السوريين الذين جاؤوا إلى مصر حاملين نصوصاً لإذاعة صوت الغد.
كنت أقدّم ألحاني لكبار الملحنين دون أن أخبرهم أنها من تلحيني، لأسمع رأيهم الحقيقي بعيداً عن المجاملة، ولأرى ردود فعلهم الصادقة. كنت أكتب النوتة الموسيقية، وقدّمت أعمالاً لإذاعة صوت العرب، واشتهرت في المسرح والإذاعة والتلفزيون. ثم بدأتُ أغني منفرداً دون أن أكون كورساً خلف أحد.
وتعرّفت على أهم موزّع في الشرق الأوسط، أندريه رايدر، الذي وزّع لعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد الأطرش. كان إنساناً رائعاً، وقد اكتشفني عندما وزّع ألحاني. وزّع لي الكثير من الأغاني، وعرّفني على المهرجانات الدولية، وكانت تلك بداية الشهرة الواسعة.
س: وماذا عن مشاركاتك في المسابقات والمهرجانات الدولية؟
_كانت تُقام مسابقات للغناء والتلحين، ورحمه الله أندريه رايدر هو من ساعدني للدخول إلى مهرجانات دولية في اليونان مرتين، ومرة في إيطاليا، وأخرى في القاهرة. ثم عدتُ إلى سوريا وعملتُ أناشيد قومية للجيش وللوطن. كنا نسجّل في سينما الحمرا بمشاركة معظم المطربين. قدّمت عدداً من الأغاني التي انتشرت على نطاق واسع.
وفيما بعد أُعلنت مسابقة لتلحين نشيد الدورة العربية الخامسة عام 1976، العام الذي عمّرت فيه الملاعب في المحافظات السورية قبل أن تُقام الدورة في اللاذقية لاحقاً. قدّم الشاعر سليمان العيسى النصّ، وتنافس على تلحينه سبعة عشر ملحناً من كبار سوريا ولبنان والعالم العربي. وقد اختاروا لحني كأفضل لحن.
ظهرتُ حينها في لقاء تلفزيوني أداره الراحل عدنان بوظو، وقال جملته الشهيرة:
“يقولون إن مزمار الحي لا يطرب، لكنه أطربنا، وقد فاز في تشييد الدورة العربية الخامسة… إنه الفنان الشاب نعيم حمدي.”
ثم جاءت الدورة العسكرية العالمية التي كان ختامها في سوريا، وحضرها رؤساء الدول المشاركة: إسبانيا، إنكلترا، فرنسا، اليونان، سوريا، العراق، والكويت، إضافة إلى لبنان. قدّم الجميع أغاني الختام، أما أنا فقدّمت أغنية بثلاث لغات: الإنجليزية والعربية والفرنسية. كتب كلماتها بالعربية شاكر بريخان،
فازت الأغنية على أكثر من خمسٍ وعشرين أغنية، وعندما أعلنوا اسمي، رحّبت بالحضور بلغاتهم، بل وبالإيطالية والألمانية أيضاً.
س: ويبدو أنّ التجربة مع كوريا تركت أثراً عميقاً لديك…
_نعم، وصلت رسالة إلى سوريا ترشحني للمشاركة في مهرجان كوريا عام 1992. راجعت السفارة الكورية وذهبت إلى النقابة، وغنيت أغنية وطنية. كان الملحق الثقافي يجيد العربية، فخطرت لي فكرة أن أكتب الأغنية بالعربية ثم أترجمها للكورية، وأضع لحنها وتوزيعها. ذهبت إلى المهرجان وغنيت باللغتين العربية والكورية، فكان الإعجاب أكبر مما توقعت. أرسلوا كتاباً إلى الخارجية السورية يطلبون ترشيحي مرة أخرى.
مثلتُ سوريا في ثمانية مهرجانات دولية، وكرّمني الزعيم الكوري الراحل كي بي تسون، جدّ الزعيم الحالي، كما كرّمتني الخارجية الكورية. سلّمني السفير الدرع، فقلت له إنّه يجب أن يُرسل إلى وزارة الخارجية في سوريا ليقدموه لي رسمياً. وبالفعل، أرسلوا التكريم إلى الدكتور فيصل المقداد، ومنه إلى وزارة الثقافة، فكرّمت في مهرجان الوزارة. وحصلت على جوائز عالمية عديدة.
س: يُقال إنك كنت من أوائل من قدّموا الفيديو كليب عربياً…
_نعم، كان لي شرف أن أكون أول فنان عربي يصوّر فيديو كليب لأغنية “ياما رحنا ومشينا”، وكذلك “طعميتك بإيدي عسل ولوز”، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأغاني. لدي أرشيف ضخم من اللقاءات المسموعة والمقروءة والمرئية في العالم العربي وأوروبا. وأقربها إلى قلبي لقائي في برنامج ضي القناديل إعداداً وتقديماً للإعلامية هيام منور ومن إخراج المبدع عدنان أبو سريّة.
_عودٌ “على ظهر الخزانة” :
يسترجع الفنان القدير نعيم حمدي شريط ذكرياته الأولى، حيث يقول: “لم تكن بدايتي مجرد صدفة، بل كانت قدراً يتربص بي فوق ظهر خزانة بيتنا؛ هناك كان يستقر عودُ عمي الراحل، ومن ذلك المكان بدأت محاولاتي الأولى لشق طريقي الموسيقي. التحقت بمعهد (تيسير عقيل)، وتعلمت أولاً كيف أضبط إيقاع الأوتار (الدوزان)، ثم درست النوتة الموسيقية حتى تمكنت من فك رموزها وإدارتها ببراعة فاقت التوقعات، حتى أن أساتذتي كانوا يبدون دهشتهم من سرعتي في التعلم.”
ويتابع حمدي: “في الثالثة عشرة من عمري، تزامناً مع سنوات الوحدة بين سوريا ومصر، غنيت (يا حلو صبح) لمحمد قنديل، وهناك التقطت أذنا الراحل نجاة قصاب حسن (مدير الثقافة والمسارح آنذاك) موهبتي، فصرف لي راتباً شهرياً قدره مئة وخمسون ليرة. ورغم معارضة أهلي لكوننا عائلة محافظة، كانت جدتي الراحلة هي بوصلتي وسندي، تأخذ بيدي إلى وزارة الثقافة لنتلقى الدروس على يد عمالقة مثل صلح الوادي، وعدنان أبو شامة، والمدرس المصري عبد الرحمن الخطيب (والد النجمة فايزة كامل)، الذي تنبأ لي بمستقبل باهر وعرض علي السفر لمصر.”
_ شرارة الشهرة.. “ياما رحنا ومشينا” :
عن نقطة التحول الكبرى، يقول حمدي: “في سن الخامسة عشرة، بدأت هواجس التلحين تراودني. وحين حصدت جوائز دولية باسم سوريا، أدخلني نجاة قصاب حسن إلى كورال وزارة الثقافة، حيث زاملت الراحلين مصطفى نصري وسعيد قطب. لكن الانطلاقة الحقيقية التي جعلت اسمي على كل لسان كانت أغنية (ياما رحنا ومشينا)؛ لقد تنبأ الكاتب جورج عشي بأنها ستصبح من كلاسيكيات التراث السوري، وطلب مني الكثيرون نوتتها الموسيقية لغنائها، ومن بينهم الفنانة نانسي زعبلاوي.”
_ ثورة في الاستعراض.. وشهادة “العندليب” :
لم يكن نعيم حمدي مجرد مطرب كلاسيكي، بل كان صاحب رؤية بصرية مختلفة: “بينما كان المطربون يلتزمون بالوقوف الرسمي على المسرح، كنتُ مسحوراً بالاستعراض العالمي (الأمريكي والهندي)، فابتكرتُ (ستايل) خاصاً بي من ملابس استعراضية فصلتها بنفسي. كنتُ أصل الميكرفون بسلك طوله عشرون متراً لأتحرك بحرية بين الجمهور وأتفاعل معهم، ليلمسوا أن اللحن ينبض بالحياة (فيه شويا). هذا التجديد جلب لي محبة الجمهور وإعجاب الكبار، حتى أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حضر لي حفلتين وقال لي بتقدير: (إحنا معندناش مطربين استعراضيين زيك).”
_ سورية الحضارة.. والرسالة الإنسانية :
حول تجربته الغنائية باللغات الأجنبية، يوضح حمدي: “كلفني وزير الإعلام الأسبق عمران الزعبي بعمل يخاطب الضمير الإنساني قائلاً: (نريد أن نكون ملة واحدة)، فقدمت فكرة (سورية الحضارة والتاريخ) وغنيت بالإنجليزية والإسبانية، تماماً كما غنيت لعمالقة الطرب مثل أم كلثوم، وعبد الوهاب، واللحوف، والسنباطي، وصباح فخري.”
وعن لقب “موسيقار”، يضيف بتواضع العلماء: “كنتُ أرفض اللقب، فالموسيقار الحقيقي هو من يكتب السيمفونيات لثلاثين آلة، ويثير الرعب أو الضحك أو البكاء في نفس المستمع؛ الموسيقار هو من يُحدث فرقاً في الحياة.”
دراما الحياة والألحان.. _”المحكوم” و”عودة غوار” :
ترك حمدي بصمة لا تُنسى في الموسيقى التصويرية: “وضعتُ ألحان 16 مسلسلاً، كان أولها (المحكوم) للراحلين رياض سفلو وفردوس الأتاسي، والذي حقق نجاحاً كبيراً في القاهرة. كما عملت مع بسام الملا في (أعلام العرب)، ولحنت 33 شارة مسلسل. ولاحقاً في مسلسل (عودة غوار) مع الكبير دريد لحام، وضعت 16 مقطوعة موسيقية، وكان من دواعي سروري أن يختارني (الأستاذ دريد) خصيصاً لهذه المهمة.”
_لقاء “كوكب الشرق” وكلمات “غاندي”:
من المحطات العالمية في مسيرته، يروي حمدي: “في المئوية لميلاد المهاتما غاندي بالقاهرة، غنيتُ أغنية هندية في حفل شاركت فيه كوكب الشرق أم كلثوم. كانت الأغنية تدعو للإنسانية والمساواة، فترجمتُ فكرتها للعربية بعبارة: (الإنسان بيضل إنسان بكل زمان). لقد عاصرتُ زمناً كانت الألحان فيه خالدة، زمن أم كلثوم التي كانت تجري مئة بروفة مأجورة قبل تسجيل أي عمل، وقد شرفتُ بالغناء أمامها وحضورها لبعض حفلاتي.”
_وفاءً للتراث.. وكلمة أخيرة
يختتم الموسيقار نعيم حمدي حواره بالتأكيد على أمانة التلحين وانتقاده لـ “التلطيش” الفني الحالي، مستذكراً نبشه في التراث العربي وغنائه لتونس وليبيا والعراق، وعمله على النشيد الوطني لإريتريا بالتعاون مع الشاعر سليمان العيسى عام 1981.
ويقول بوفاء: “التقيت بعمالقة الزمن الجميل كفريد الأطرش وبليغ حمدي، ولحنت للراحلة (كروان) أغنية (علواه) التي أبكتها فرحاً. وفي الختام، أوجه تحية إجلال لمصر (أم الدنيا)، وللقائمين على هذا الحوار وخاصة الدكتور الإعلامي أشرف كمال : رئيس تحرير صحيفة الرواد نيوز الدولية ، وللإعلامية الغالية سلمى صوفاناتي التي أتاحت لي فرصة استرجاع هذه الذكريات.”