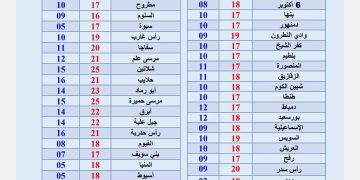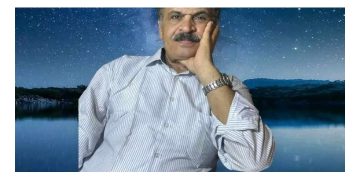خليل حمادة: بين هدير الفرات وصمت المدن… رحلة الكاتب الذي يمشي بين الشعر والنثر ..
بقلم : سلمى صوفاناتي
على ضفافِ الفراتِ، حيثُ يلتقي هديرُ الموجِ بصمتِ الريفِ ونبضِ المدينةِ، وُلدَ خليلُ حمادةٍ، كاتبٌ فراتيٌّ حملَ معهُ نهرَهُ في قلبِهِ وأحلامَهُ على الورقِ. أربعَ عشرةَ سنةٍ عاشَها في لبنانِ، بينَ أمسياتِ الأدبِ وندواتهِ وصالوناتِ الشعرِ، فصقلتهُ الريحُ والمطرُ على حدٍّ سواءٍ، وجعلتْهُ يرى العالمَ بعينِ الشاعرِ والفكرِ، لا بعينِ التاجرِ أو العابرِ.
حمادةُ كاتبٌ لا يعرفُ قيودَ الجغرافيا، يمشي بينَ الشعرِ الفصيحِ والنثرِ، ويغني بالكلمةِ الشعبيةِ والفراتيةِ والنبطيةِ، كمن يفتحُ أبوابًا سريةً في مدينةٍ غامضةٍ، يكتبُ الروايةَ والقصةَ والأغنيةَ، ويخوضُ مغامراتِ السيناريو والحوارِ كما يغامرُ الرحالةُ باجتيازِ صحراءَ بحثًا عن وميضٍ أبديٍّ.
صدرتْ لهُ أربعةُ كتبٍ مطبوعةٍ: روايةُ «بناتٌ تسرقها الريحُ»، وروايةُ «فرقدٌ وقرينهُ الملحدُ»، ومجموعةٌ قصصيةٌ «حرامي البيضِ»، وديوانٌ شعريٌّ «شهگة ضوا». ومؤخرًا، كرّمتهُ وزارةُ الثقافةِ الإماراتيةِ بالإقامةِ الذهبيةِ للمبدعينَ، كإشارةٍ إلى أن الرحيلَ لا يمحو الوطنَ، بل يضاعف حدودهُ في القلبِ والروحِ.
س1:
خرجتَ من ضفةِ الفراتِ محمولًا على هديرِ الموجِ – كما تصفُ نفسكَ – كيف أثرَ المكانُ الأولُ في تكوينكَ الإبداعيّ؟
ج:
هو ذاكرةٌ ممتدةٌ بينَ حوافِ الريفِ ونبضِ المدينةِ، أربعونَ عامًا كانت أشبهَ بمستودعٍ صامتٍ يترصّدني من الداخلِ. وحين اكتملتِ الدائرةُ، وجدتُني أفيضُ بما ادّخرتهُ على الورقِ، كأنني أحرّرُ النهرَ من معاناتهُ، وأعيدُ لدرّتهِ المفقودةِ صوتَهُ الذي انكسرَ.
س2:
عشتَ أربعةَ عشرَ عامًا في لبنانِ، إلى أي مدى أسهمتْ هذهِ المرحلةُ في بلورةِ شخصيتكَ الأدبيةِ؟
ج:
تأخّرَ المخاضُ حتى السابعةِ من عمري الثاني. هناكَ، في لبنانِ الذي فتحَ لي أبوابَ الغيمِ والريحانِ، وسمحَ لي أن أكتبَ باسمهِ واسمِ الأمِ والروحِ، وُلدتُ كاتبًا. لم تكنِ الولادةُ من رحمٍ، بل من نافذةٍ تطلّ على المطرِ.
س3:
تكتبُ الشعرَ العموديّ، والنثرَ، والشعبيّ والفراتيّ والنبطيّ، بل وتمشي بينَ الأجناسِ الأدبيةِ بسهولةٍ. كيف تتعايشُ كلُّ هذهِ الأصواتِ داخلكَ؟
ج:
هي كحديقةٍ غنّاء، كلُّ وردةٍ فيها تحملُ سرَّ عطرٍ مختلفٍ، أقتربُ منها كما يقتربُ الندى من الضوءِ، لا ليأخذَ، بل ليذوبَ في سرِّ التلاقي بين العابرِ والفاني.
س4:
أيُّ جنسٍ أدبيٍّ يمنحكَ شعورًا بأنك في بيتكَ أكثرَ: الروايةُ، الشعرُ، القصةُ، أم الأغنيةُ؟
ج:
الروايةُ هي القبةُ الكبرى، تحتها تستطيعُ أن تخبّئَ الشعرَ كهمسٍ بين السطورِ، والقصةَ كظلالٍ في المسافةِ. إنها الحقلُ الذي تتوالدُ فيه الأجناسُ الأدبيةُ كما تتوالدُ السنابلُ من حبةٍ واحدةٍ.
س5:
روايتكَ “بناتٌ تسرقها الريحُ” حملت عنوانًا مثيرًا، ما الحكايةُ وراءَ هذا العنوانِ؟
ج:
العنوانُ ليس لافتةً، بل فخٌّ أسئلةٍ. أريدهُ أن يجرّ القارئَ كما تجرّ النارُ فراشةً إلى اللهبِ. ما يُكتبُ في العنوانِ ليس هو المقصودُ، بل ما يُحجبُ عنهُ. أتركُ ثغرةً للقارئِ كي يدخلَ منها ويستكشفَ المعنى الآخرَ الذي لا ينطفئُ.
س6:
في “فرقدٌ وقرينهُ الملحدُ” تقتربُ من ثنائيةِ الإيمانِ والشكِّ. ماذا أردتَ أن تقولَ في هذهِ الروايةِ؟
ج:
أردتُ أن أقولَ لصديقي الملحدِ إنَّ اللهَ ليس وهماً، بل هو المعنى الذي لا يحتملُ النكرانَ. كتبتُ لهُ روايةً تضعهُ في مواجهةِ نفسهِ، بلغةٍ فلسفيةٍ عاليةٍ وأحداثٍ حقيقيةٍ تضيءُ لهُ الطريقَ. كنتُ أريدُ أن يقرأها حتى آخرها، كأنها مرآةٌ تُقطّع الشكَّ حتى ينفجرَ اليقينُ.
س7:
“حرامي البيضِ” مجموعةٌ قصصيةٌ ذات عنوانٍ شعبيٍّ ساخرٍ. هل تسعى عمداً إلى استدعاءِ البساطةِ الشعبيةِ في أدبكَ؟
ج:
“حرامي البيضِ” كانت مرايا ساخرةً، قصصًا من المضحكِ المبكيِّ. أردتُ أن أُخبرَ الناسَ عن معاناتهم بلسانٍ يضحكُ ويبكي في آنٍ، سردٌ مبسّطٌ لكنه كالماءِ يلمسُ الجميع ويفهمهُ الجميع، يحملُ التوعيةَ في جيبٍ من طرافةٍ.
س8:
كيف وُلدَ ديوانُ “شهكةُ ضوا” وما الذي يميزهُ عن صوتكَ النثريّ؟
ج:
وُلدَ الديوانُ على عجلٍ، بعد أن جمعتُ خمسَ سنواتٍ من الشعرِ الشعبيِّ في كتابٍ واحدٍ. سمّيته أولًا “شفگةُ ضوا”، لكن الأديبة الفراتيةُ فوزيةُ مرعي ـ رحمها الله ـ همست لي أن أسميه “شهقةُ ضوا”. كان افتتاحه بحروفٍ أهداني إياها شاعرٌ شعبيٌّ كبيرٌ، شواخُ الأحمدِ، كأنه يضعُ شعلةً في يدي لأكملَ الطريقَ.
س9:
تقول إن الرحيلَ لا يلغي الوطنَ بل يضاعف حدودهُ. كيف يتجلى هذا في كتاباتكَ؟
ج:
في لبنانِ، تبدّلَ مساري من تاجرٍ يبيعُ التحفَ إلى كاتبٍ يبيعُ الحلمَ. كتبتُ الشعرَ والروايةَ والأغانيَ والقصةَ والسيناريو، أدركتُ أن السفرَ ليس فراقًا، بل مفتاحٌ خفيٌّ للخيرِ. من يغادرْ أرضَهُ يكتشفُ أرضًا في داخلهِ لم يكن يراها.
س10:
منحتكَ وزارةُ الثقافةِ الإماراتيةِ الإقامةَ الذهبيةَ للمبدعينَ. ماذا تعني لك هذه الخطوةُ؟
ج:
أن تُمنحَ إقامةً كمبدعٍ في بلدٍ يحترمُ الثقافةَ، فذلك يشبه أن يضعَ أحدهم على صدركَ وسامًا من ضوءٍ. كنتُ من الأوائلِ في مدينتِي الذين نالوا هذا التقديرَ، وكان الشعورُ كأن نافذةً جديدةً قد فُتحت في روحي.
س11:
لو خيرتَ أن تعرفَ نفسكَ بكلمةٍ واحدةٍ أمام قارئٍ لا يعرفكَ، ماذا ستقولُ؟
ج:
أكرهُ أن يقال عني شاعرٌ أو روائيٌّ أو قاصٌّ، فكلُّ صفةٍ تُقصي الأخرى كأنها قفصٌ. يكفيني أن أُسمّى “كاتب”، فالكاتبُ يكتبُ كلَّ شيءٍ، يفتحُ كلَّ الأبوابِ دون أن يعلّقَ على صدرهُ لافتةً.