#قصة_قصيرة
صيام على حافة الاغتراب (6)
الضياع بين الظلال
مضى يوسف يسير بخطى ثقيلة، كأن الأرض تحت قدميه تحولت إلى مستنقع من الذكريات اللزجة التي تعيق تقدمه. لم يكن يدري إلى أين يقوده التيه، لكنه كان يشعر أن المدينة كلها تتحول إلى متاهة من المرايا، تعكس وجوها لم يعد يعرف أيها له.
كلما توغل في الشوارع، ازدادت العتمة داخله، حتى شعر أن قلبه لم يعد ينبض، بل يتردد صداه كفراغ مجوف. كان الليل في بروكسل قاسيا، باردا بطريقة لا علاقة لها بدرجة الحرارة، بل بذلك البرود الذي يتسلل إلى الأرواح المتعبة، يجعلها أكثر هشاشة، أكثر استعدادا للانكسار.
توقف عند جسر حجري قديم، أسند مرفقيه إلى الحاجز ونظر إلى الماء الذي يجري تحته، كانت أمواج النهر تعكس أضواء المدينة، لكنها بدت له ككلمات غير مفهومة، كرسائل ضائعة لم تجد بعد من يقرأها.
هناك، في تلك اللحظة، شعر بثقل الغربة يطبق على صدره، ليس فقط الغربة عن الوطن، بل عن نفسه. كانت الأسئلة تتلاطم في رأسه كالموج: من يكون الآن؟ هل هو الرجل الذي رحل بحثا عن حياة أفضل، أم ذاك الذي ترك روحه هناك، عند أول محطة وداع؟
— “هذه المدينة تأكلك ببطء، أليس كذلك؟”
انتفض يوسف والتفت، ليجد امرأة تقف بجانبه، كانت ترتدي معطفا داكنا، شعرها الأسود يتطاير مع الريح، وعيناها تحملان نفس التعب الذي رآه في المرآة قبل قليل.
— “أنتِ؟” سأل بدهشة، كأنه يعرفها لكنه عاجز عن التذكر.
ابتسمت، لكنها لم تجب، فقط أخرجت سيجارة، أشعلتها ببطء، ثم زفرت الدخان وهي تحدق في الماء تحتهما.
— “كل الذين يقفون هنا يحملون الحكاية نفسها، وإن اختلفت التفاصيل.”
كان في صوتها نبرة تشبه صوت الرجل الذي التقاه قبل قليل، ذلك الصوت الذي يحمل نكهة أولئك الذين عرفوا معنى الضياع لكنهم لم يستسلموا له تماما.
— “ولماذا أنتِ هنا؟”
لم ترد فورا، كأنها تبحث عن إجابة لم تكن واثقة من صحتها. ثم، وبعد صمت طويل، قالت:
— “ربما أنتظر أن تخبرني لماذا أنت هنا.”
أحس يوسف أن الجملة ليست مجرد رد، بل مرآة أخرى، تعكس السؤال الذي ظل يطارده منذ أن غادر الوطن. لماذا هو هنا؟
— “أنا فقط… أبحث عن شيء، لكنني لم أعد متأكدا مما هو.”
ضحكت، لكن ضحكتها كانت باردة، مثل ضحكة شخص فقد إيمانه بكل الإجابات.
— “كلنا كذلك. نمضي العمر نبحث عن شيء لا نعرف اسمه، وحين نظن أننا وجدناه، نكتشف أنه كان سرابا.”
شعر يوسف أن كلماتها تنزف من مكان عميق، كأنها مرت بكل الطرق التي يخشى أن يسلكها. نظر إليها مجددا، محاولا أن يفهم، لكنه أدرك فجأة أن بعض الوجوه ليست بحاجة إلى تفسير، بل إلى إنصات صامت.
— “إلى أين تذهبين الآن؟”
— “إلى حيث لا تنتظرني الذكريات.”
ثم استدارت ومضت، تاركة خلفها رائحة التبغ والليل. أما يوسف، فبقي هناك، ينظر إلى الماء، إلى أضواء المدينة التي تترنح فوق السطح المضطرب.
هل يمكن للمرء أن يهرب من نفسه؟ أم أن الغربة ليست في المكان، بل في الروح التي لم تعد تجد وطنا؟
أدرك أن الليل لم يكن سوى انعكاس لما بداخله، وأن التيه لم يكن في الطرق، بل في داخله…
بقي يوسف مسندا مرفقيه إلى الحاجز الحجري، يحدق في النهر كما لو كان يبحث عن وجهه الغائب بين التموجات. كان البرد يلسع أصابعه، لكن جموده الداخلي كان أشد قسوة. شعر أن الليلة تطول بلا نهاية، كأن الزمن توقف عند نقطة ما بين الماضي والحاضر، بين ما كان وما يجب أن يكون.
تحرك أخيرا، ببطء كأنما يجر جسده جَرّا. خطواته كانت أثقل مما تحتمل الأرض، وكأن المدينة صارت حقل ألغام من الذكريات، وكل زاوية تنفجر بصورة قديمة، بصوت مألوف، بلحظة يود لو نسيها أو عاد ليعيشها من جديد.
عبر شارعا جانبيا، حيث المصابيح تضيء بالكاد، ملقية ظلالا طويلة على الرصيف، مثل أشباح تسير بمحاذاته. هناك، لمح مقهى صغيرا، معزولا عن ضجيج المدينة، كأن الزمن داخله لا ينتمي للحاضر. تردد قليلا، لكنه في النهاية دَفَعَ الباب، ليدخل إلى عالم آخر.
كان المكان يشبه ذاكرة عالقة في منتصف القرن الماضي؛ طاولات خشبية قديمة، كراس متآكلة الأطراف، وجدران تصطف عليها صور باهتة لأماكن لا أسماء لها. كان روّاد المكان مزيجا غريبا؛ وجوه شاحبة متعبة، أعين زائغة تبحث عن شيء مفقود.
جلس يوسف في زاوية معتمة، أسند رأسه إلى الجدار وهو يراقب بصمت. لا شيء هنا ينبض بالحياة، كل شيء يبدو مستهلكا، حتى الزمن نفسه.
تقدم النادل، رجل خمسيني بملامح تشبه جدران المقهى: متشققة، مرهقة، لكنها تحمل بقايا ابتسامة خافتة.
— “ماذا تشرب؟”
رفع يوسف رأسه، نظر إليه لحظة قبل أن يجيب:
— “قهوة سوداء… بدون سكر.”
أومأ النادل وعاد بخطوات بطيئة، كأن الزمن لم يعد يعنيه. يوسف تابع التحديق في المكان، حتى استقر نظره على رجل يجلس غير بعيد، رأسه مطأطئ فوق كوب من النبيذ، كأنه يقرأ فيه مصيره. كان وجهه يحمل ندوب الزمن، لكن عينيه هما ما لفت انتباه يوسف… كان فيهما ذلك البريق الذي تراه في عيون أولئك الذين عاشوا أكثر مما يجب.
— “تبدو جديدا هنا.”
رفع يوسف رأسه، فوجئ بأن الرجل يخاطبه دون أن يرفع عينيه عن كأسه.
— “ربما.”
ضحك الرجل ضحكة قصيرة، لأن الجواب لم يفاجئه. ثم شرد قليلا، قبل أن يقول بصوت خافت:
— “هذا المقهى ليس للغرباء، لكنه ممتلئ بهم.”
— “وماذا عنك؟ هل أنت غريب هنا؟”
رفع الرجل رأسه أخيرا، نظر إلى يوسف نظرة طويلة قبل أن يبتسم بسخرية:
— “أنا غريب… في كل مكان.”
كان في صوته شيء جعل يوسف يشعر وكأنه ينظر إلى مرآة أخرى، لكنها تعكس مستقبلا لا يريد رؤيته. كم مضى على هذا الرجل وهو يجلس هنا، يحتسي النبيذ ويحدث الغرباء؟ كم من يوسف آخر مر من هذا المكان، سأل السؤال نفسه، وحصل على الجواب نفسه؟
شعر يوسف أن الهواء يضيق عليه… المكان صار زنزانة غير مرئية. نهض فجأة، ألقى ببضعة الفرنكات على الطاولة، ومضى نحو الباب. كان بحاجة إلى أن يتنفس، أن يهرب من تلك الدائرة التي بدأت تضيق حوله.
خرج إلى الهواء البارد، تنفس بعمق، لكنه لم يشعر بأي راحة. كانت المدينة لا تزال كما تركها، لكنها لم تعد كما كانت. شيء ما تغير، ربما فيه، وربما في الطريقة التي يرى بها كل شيء.
أعاد نظره إلى الجسر الذي وقف عليه قبل قليل، وتذكر المرأة التي التقاها هناك. هل كانت حقيقية؟ أم أنها كانت جزءا من هذيانه الليلي؟ هل حقا قالت تلك الكلمات، أم أنه تخيلها؟
شعر فجأة أن كل شيء بدأ يتلاشى، أن الواقع أصبح أكثر هشاشة، وهو على وشك الانهيار.
وقف في منتصف الطريق، بين أن يستمر في السير، أو يعود إلى حيث كان. لكن السؤال الحقيقي لم يكن عن الاتجاه، بل عن المعنى:
إلى أين يمضي الإنسان، عندما لا يعود له مكان؟





































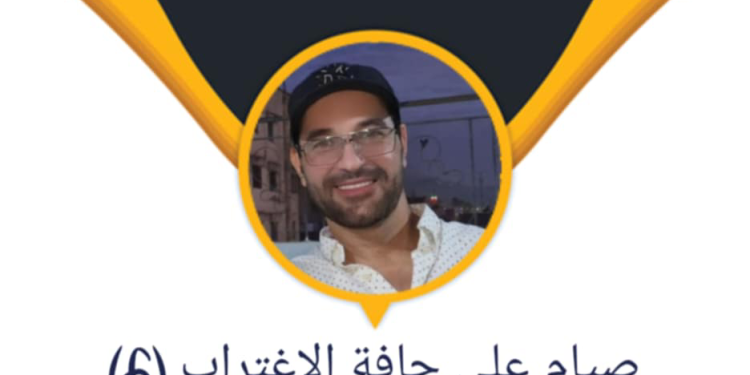

Discussion about this post