“لو يخجل الموت قليلا”.. لعبة الحياة والموت: تأملات في مواجهة الوجود
نورالدين طاهري
يتبدى كتاب “لو يخجل الموت قليلاً” للكاتب والإعلامي عبد العزيز كوكاس كفضاء دلالي مشحون بالأسئلة القلقة، حيث تنحل ثنائية الحياة والموت من شكلها التقليدي لتتخذ هيئة جدلية أعمق، تنأى عن الاختزال البيولوجي وتتشكل كمفهوم إشكالي مفتوح على التأويل. لا يتعامل النص مع الفناء كحقيقة نهائية بقدر ما يعيد صياغته كحالة مترددة، تتقهقر أمام عنفوان الحياة، وتنكشف ككيان مرتبك، يهاب مقاومة الوجود. حيث لا ينغلق الموت على ذاته، بل يتحول إلى قوة مضادة، تحث الكائن على إعادة إنتاج معناه في مواجهة حتمية التلاشي.
الكتابة هنا أداة للتعبير عن الذات والهروب من التناهي، أو ربما وسيلة لتحقيق الخلود في ذاكرة الزمن. من خلال الكتابة، يحاول الكاتب والمبدع بشكل عام أن يواجه واقع الفناء، ليظل له حضور في أذهان الناس رغم غيابه الجسدي. الكتابة بالنسبة لكوكاس هي محاولة لتحطيم قيود الزمن والموت، وتحقيق نوع من البقاء في ذاكرة الأجيال القادمة، كما لو أنه يبحث عن عشبة جلجامش.
يتجاوز الكاتب في مقاربته للموت الطرح الميتافيزيقي التقليدي، ليحيله إلى معترك رمزي تتشابك فيه الذات مع الظل، وتتصارع فيه الرغبة مع العدم. ليس الموت مجرد نهاية، بل طرف في صراع أبدي يقتضي استدعاء كل أدوات الإدراك والرفض، ويتماهى مع الخوف لكنه يستثير، في الوقت ذاته، جذوة الحياة. إنه حضور مراوغ، لا يفرض هيمنته المطلقة، بل يخجل، يتوارى، ويفقد صلابته أمام شراسة البقاء. هذا التوتر بين الامتداد والاضمحلال يمنح النص بعدا فلسفيا، ولا تُقرأ التجربة الإنسانية بوصفها خضوعا للمصير، بل كفعل مقاومة مستمر، يستنطق الموت ليعيد تعريف الحياة.
1. ألم الموت كتجربة وجودية
يرتكز الموضوع الأساسي في الكتاب على التوتر الوجودي المستمر بين الحياة والموت. لا يُنظر إلى الموت كحادثة جبرية أو نهاية محتومة فحسب، بل يتم إعادة تأطيره ككيان يستشعر الشفقة والخجل أمام قوة الحياة التي لا تقهر. هذه النظرة تحمل في طياتها رؤية تتحدى التصورات التقليدية التي تعتبر الموت نهاية لا مفر منها، فتضعه في سياق ديناميكي يتداخل مع جماليات الوجود وإصرار الإنسان على البقاء.
يُصوَّر كوكاس الموت في نص “لو يخجل الموت قليلا” ليس كعدو خارجي يقتحم عالم الحياة، بل ككيان يشهد على قوة الحياة نفسها؛ فهو، في مواجهة تلك القوة، يختبئ أو حتى يخجل. حيث يُطرح السؤال: هل يمكن للموت أن يكون ضعفا في حضرة الحياة القوية؟ هنا يتجسد التناقض المتأصل في التجربة الإنسانية، ويُنظر إلى الموت كجزء لا يتجزأ من دورة الحياة، ولكن هذه الدورة تُظهر أن الروح البشرية تمتلك القدرة على التمرد والإصرار على الاستمرار.
يقول: “ما معنى أن تبقى حيا بعد أن قُدتَ أقرب الناس إلى قلبك نحو خاتمتهم، وخلا زمانك منهم.. إنه ألم الأحياء لا الأموات الذين لم يعد يعني لهم الزمان شيئا، والمشكلة هي دوما مشكلة الأحياء لا الأموات الذين رحلوا وما عادوا قلقين على العودة أو على طرح سؤال كيف سنعيش؟ ما معنى أن تحيا؟
هو هذا السؤال الحارق الذي ظل يطاردني كلما واريتُ جثمان من أحب، مع فائض من الألم المصاحب لي كحارس لكل الغائبين، لم يعد للنسيان أي بهجة، وخيالات الصور التي ظللتُ أحفظها لكل من فقدْتُهم لم تعد لها تلك اللذة الإيروسية للامتلاء بالفرح، لقد خانني الصبر مثل انجراف نهر عن خط مجراه.. أريد أن أُعَرِّفَ موتي، فكل شيء يُعرّفُ يُضبط، يؤطر، يصبح خارج الحياد.. نعم، لا يقودنا التعريف نحو الخلود، أو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، لكنه على الأقل ينقذنا من العبث، يرسم المعنى حتى لو كان رحيلا أو عتمة، لكن ماذا بوسعي أن أفعل وقد امتلأ العالم من حولي بالغياب الذي أصبحت حارس بوّابته؟”
يمتد هذا التوتر بين الحياة والموت إلى تباين بين الألم والأمل، بين اليأس والرغبة الملحة في الخلود. فالألم الناتج عن مواجهة الموت ليس مجرد وجع جسدي أو نفسي، بل هو انعكاس لمعركة داخلية بين الاستسلام والتحدي. من جهة، يمثل الألم تجربة وجودية تُذكر الإنسان بحدوده البشرية؛ ومن جهة أخرى، يكون الأمل بمثابة الضوء الذي يُضيء معالم المقاومة والتمرد، محفزا على استثمار كل لحظة في الحياة رغم قسوتها.
من زاوية أخرى، يُعيد النص تأكيد فكرة أن الحياة ليست مجرد حالة مؤقتة، بل هي قوة معارضة تتحدى الموت بوجودها وإصرارها. في هذا السياق، يصبح الوجود الإنساني حوارا مستمرا مع الموت، حوارا يُظهر أن التمتع بلحظات الحياة، مهما كانت قصيرة أو مليئة بالتناقضات، يُعدّ انتصارا على فكرة الفناء المطلق. يتجلى هنا أن جماليات الحياة لا تكمن فقط في ملامحها السطحية، بل في القدرة على إشعال شعلة التمرد، التي تجعل من كل لحظة تحديا جديدا لقوانين الزمان والمصير.
ويهيئنا الكاتب للدخول إلى العالم الهاديسي للموت نكاية فيه: “عليّ أن أتصور موتي حالا قبل الأوان، أؤثّثه بعناية فائقة، أنا الذي أعرف أني سأموت ويجب أن أفكر في ذلك بعمق، ولي وحدي أن أفكر كيف سأموت.. عليّ أن أتألّم موتي وأتأمّله.. كما تأمله بول ريكور وهو يرى احتضار زوجته سيمون ويتساءل: “ماذا يمكنني أن أقول عن موتي؟ ولكن ما هذا الموت الأكثر واقعية من حياتي؟ لأن علاقتي بالموت غير منتهية الصلاحية بعد. هي علاقة مُحتجبة، مطموسة، مُضعَفة باستباق سؤال مصير الأموات الذين هم موتى قبلاً.. إنه ميت الغد، المستقبل القريب الذي أتخيّله، وصورة الميت التي سأكونها بالنسبة للآخرين، والتي تريد أن تحتل كلّ المكان”.
وأنا الذي رثيتُ الكثير من الأحبة، كنت كلما أودعْتُهم اللّحد أدفن جزءا مني، أعدّ جنازتي وأنا أدفنهم واحدة واحدا، وأهيئ كفني وقبري وأنا أُحييهم في كلماتي، فالموت مثل الحب يأتي بلا استئذان حتى ونحن نعرف أننا سنموت حتما.. أو كما قال أبيقور: “لا خوف من الموت، لأننا حينما نكون نحن، الموت لا تكون، وحينما تكون الموت نحن لا نكون”.
بإعادة تأطير الموت وتقديمه ككيان يتفاعل مع الحياة وليس مجرد نهاية مفروضة، يقدم النص رؤية معقدة تتحدى القارئ للتأمل في معاني الوجود والهوية. هذه الرؤية تُظهر أن حياة الإنسان، رغم هشاشتها ومحدوديتها، تحمل في طياتها قوة لا تُقهر قادرة على تحويل حتى ألم الفناء إلى مصدر إلهام ودافع للتجدد والاستمرار.
يتناول الكتاب أيضا موضوع الفقد والذاكرة من خلال استعراض مجموعة من الشخصيات الراحلة التي تركت بصمات واضحة في مجالاتها المختلفة. لا تقتصر هذه الشخصيات على بعد القرابة فحسب (الاب، الأم، الأخ)، بل تمتد لتشمل مفكرين وكتّابا وصحفيين، كل منهم كان له دور محوري في تشكيل البنية الثقافية والتطور الفكري الذي عاشه المجتمع. ووشم خاص في حياة الكاتب والإعلامي عبد العزيز كوكاس، يظهر الكتاب كيف أن رحيل هذه الشخصيات لم يترك أثرا في الحاضر فقط، بل أسهم في تشكيل الذاكرة الثقافية.
يتناول كتاب ” لو يخجل الموت قليلا” شخصيات مثل المفكر محمد سبيلا، الذي يُصوّر كرمزٍ للنضال الفكري في سعيه لنشر الحداثة في مجتمع غارق في التقليدية. ويُبرز التحديات التي واجهها سبيلا في مسيرته الفكرية. كذلك، يسلط الكتاب الضوء على إدريس الخوري، الذي كان تمرده على الأنماط الأدبية التقليدية أحد أسباب تميزه في الأدب المغربي.. إلى جانب هذه الشخصيات، يتناول الكتاب أيضا مجموعة من الأعلام الثقافية والإعلامية والحقوقية الأخرى مثل عبد الجبار السحيمي، نور الدين الصايل، عبد الحميد بن داوود، إدريس بن زكري، عبد الكبير العلوي الإسماعيلي، وفاضل العراقي… كل واحد من هؤلاء ترك تأثيرا واضحا في مجاله الفكري، ويميل الكتاب إلى إبراز كيف أن غيابهم خلق فراغا ثقافيا، لكن ذكراهم لا تزال حية في الوجدان الثقافي، وتستمر أفكارهم في التأثير على الأجيال القادمة.
من خلال تأملات الكتاب في الفقد والذاكرة، يظهر أن غياب هذه الشخصيات لم يقتصر على خلق فراغ فكري وثقافي، بل عمل على إحياء ذكرهم وتحويلهم إلى رموز حية تساهم في تشكيل الذاكرة الجماعية للأمة.. لا يرسم كوكاس بروفايلات لشخصيات وازنة رحلت عنا، بل من خلال الصحبة الأليفة، عبر ما أسماه “أغنية للغائبين”، يعمد إلى اللعب مع الموت والسخرية منه في أحايين كثيرة. ويتساءل بنفس تأملي:
“ما القاسي في الموت؟ الغياب، الرحيل، اللّيس والعدم، الفراق، الصمت، انهيار الكينونة، بلاغة الوداع…؟ كيف نؤثث للموت جغرافيا وتاريخا يليقان به؟ كيف نصنع له زمانا ومكانا يحيا فيه بعد موت ونُنقذه من الوصف المأساوي؟ للموت أيضا صورة الخلود، من خلّد من حتى بعد موت: نيرون أم روما المحترقة، سنيكا ولوكان وبترونيوس الذين مزقوا أوردة أيديهم وانتظروا الموت على ناصية الجرح أم الطاغية الذي جلس يتفرّج على نهاية هؤلاء المبدعين الرومان بنشوة المنتصرين؟
سأستحم في نهر الليثون لأنسى كل ما كنته، لعلي أبني ذاكرة هنا، بلا وجع الرحيل والفقد، وأتعلم كيف أرثيني بلا كلمات ولا وجع للحزن، أليس الرثاء مديح الميت؟”
2. الاستعارة كفضاء للخلود، المجاز كسخرية وجودية
يعتمد الكاتب في نص “لو يخجل الموت قليلاً” على توظيف مكثف للمجاز والاستعارة، مما يمنحه عمقا دلاليا يتجاوز المعنى المباشر للكلمات. لا يتعامل الكاتب مع اللغة بوصفها أداة للتعبير بل يجعل منها كيانا حيا يتنفس بين ثنايا النص، وتتحول المشاعر والأفكار إلى صور ملموسة، ويصبح المجاز وسيلة لتوسيع أفق المعنى وإثراء التجربة الوجدانية للقارئ.
المجاز في النص ليس مجرد تزيين لغوي، بل هو وسيلة لإعادة خلق العلاقة بين المفاهيم، بحيث لا يكون الموت مجرد نهاية بيولوجية، بل يصبح حالة نفسية تعيش في الذاكرة. يقول الكاتب: “نفضتُ عن روحي بعض الغبار لأستطيع أن أسمع همسي، لم يكن هناك غير الصدى، لملمتُ أحلامي، هدهدْتُها قليلا لتنام واستسلمت لعتمتي لأذهب إلى قبري بكامل اليقين، أحسني برغم ثقل السنين، طفلا نزقا،
حريتي دليلي
روحي مثل قبو تتكدس فيه الفوضى بانتظام مثل أدراج المباني القوطية
أنا من أعطى للطيني فيّ روحه وشكله
من سمّاه وأعلاه فوق الجمر نيّئا
أنا من منحه حزنه وفرحه
ضوءه وظله..
أنا من جعلت الطين فيّ يشبهني
ونفخت فيه من روحي حتى استوى
وسرقت له تأوّه الريح وغواية رقص الوردة
وكلما آوى إلى عتمته
دثّرتُه بدفء الأساطير الأولى، وأول الكلام علّمته..
ليكون له لسان للتأوه والحكي
وحين شاب وشاخ.. كان موت واحد ينتظرنا
موت لا يتسع لاثنين، إذ هما في غار الرهبة وآخر العمر
فديتُ الطين فيّ، وتركت له سماء يقطع بها شراب سكره
وأرضا يطويها ويتأبّطها مثل سجادة
ليُطل على صمت الظلال.. وقررت الرحيل”.
يتحول الموت من حدث لحظي إلى كائن ديناميكي يمارس فعل السرقة. هذا التجسيد المجازي يجعل الموت أشبه بكيان متربص، لا يكتفي بإنهاء الحياة مباشرة، بل يتسلل إليها تدريجيا عبر فقدان الذكرى وتآكل المشاعر.
يرتكز البناء اللغوي في النص على الاستعارة كأحد الأعمدة الأساسية في نسيج النص، تسمح بمنح المفاهيم المجردة بعدا حسيا يقرّبها من تجربة القارئ. تتخذ الاستعارة طابعا أكثر تعقيدا، وتتحول الذكرى إلى “رماد”، وكأنها شيء متفحم بفعل الزمن، لكنه لا يزال قابلا للاستثارة بفعل “ريح” تمر فجأة، فيحترق الماضي من جديد في الذاكرة. لا يكتفي النص بالاستعارة، بل يوظف التشبيه والكناية كوسيلتين لإضفاء مزيد من العمق على المعنى.
يتلاعب الكاتب بالمفاهيم الزمنية من خلال استخدام الاستعارة، مما يجعل الماضي أكثر حضورا من الحاضر. ويتم تفكيك الزمن التقليدي، فلا يعود الموت نقطة نهاية، بل مسارا بدأ منذ اللحظة الأولى للقاء. هذا الاستخدام الذكي للاستعارة الزمنية يجعل النص أكثر تعقيدا من الناحية الدلالية، وتصبح الذكرى نوعا من السفر العكسي في الزمن، وكأن الغياب قد بدأ منذ البداية وليس في لحظة الفقد فقط.
يستند النص إلى رؤية بلاغية تجعل من الفقد تجربة متعددة الأبعاد، ويتم تحويل المشاعر المجردة إلى استعارات حية، وإعادة تشكيل العلاقة بين الزمن والذاكرة والموت بطريقة جدلية، فلا يصبح الفقد غيابا مطلقا، بل تحوّلا، ولا يكون الموت نهاية، بل استمرارا وتحولا. يقول كوكاس: “في الاحتضار القاسي حين كنتُ على عتبة الموت، أحسست أن عليّ أن أختزل كل اللحظات، أن أسترجع ماضيّ على شكل وميض برق سريع الالتماع، وأنظر إلى حاضري بعين شرهة تحاول تأمل كل التفاصيل الدقيقة، إنها لحظة الحشرجة بين الحياة والموت، لحظة الحياة قبل الموت أو الحياة على وشك الموت، في لحظة الانحلال هاته، يبرز التأمل كتجلّ أسمى للخلود، مثل محكوم بالإعدام لحظة تنفيذ الحكم، عليك أن تسترجع اللحظات الطفولية الجميلة المتوهجة في حياتك لتُديم النظر في الوجه العزيز للحياة التي توشك على الانطفاء، وتأمل أن يحدث خلل ما في سير الوجود يُوقف سريان حكم تنفيذ الموت.. فالوقت القليل الذي تبقى لنا في الحياة، هذه الثواني القليلة، حتى ونحن نحتضر أهم من كل العقود والسنين التي انصرمت”.
يمكن اعتبار نص “لو يخجل الموت قليلاً” تجربة لغوية فريدة تستثمر إمكانيات المجاز والاستعارة لتوسيع أفق المعنى، إذ تتحول الذكرى إلى كيان حي، ويصبح الغياب أكثر حضورا من الواقع نفسه. يعتمد النص على توظيف دقيق للاستعارات الزمنية والحسية، مما يجعله ليس فقط تأملا في الموت، بل إعادة تشكيل لعلاقة الإنسان بزمنه، وبالذين رحلوا، وباللحظات التي تظل عالقة في الذاكرة كأشكال من الحياة المؤجلة.
3. النقد الأدبي واللغوي
يُقدّم الموت في نص “لو يخجل الموت قليلا”، كتحدٍ مستفز، يتجاوز كونه مجرد خاتمة محتومة ليُصبح محفزا لمشاعر الحنين والتمرد. وتتمثل الجرأة النقدية في رفض الكاتب للرؤية النمطية للموت كحدث نهائي، إذ يبرز فيه بعدا متمردا يعكس شكا عميقا في الأفكار الراسخة حول الفناء والخلود. من خلال استخدام لغة نقدية رصينة، يُضعف الكاتب من قوة التصورات التقليدية للموت، مظهرا أن الموت، بدلا من أن يكون نقطة النهاية، يمكن أن يكون محفزا للتجديد الداخلي والبحث عن معاني أعمق للوجود. هذه النظرة تُثير تساؤلات حول قيمة الحياة ومصير الإنسان، وتدعو القارئ لإعادة تقييم المعتقدات التي كانت تُعتبر بديهية لوقت طويل. نقرأ: “كيف سأعيد هنا خلق لغة لأتملّك كينونتي ولتصبح للأشياء ذاكرة، كيف لي أن أخلق لغة حية لكائنات ميتة، لأُخْرِج هذا العالم السفلي من وجوده الغُفل كما في مرويات الأساطير، ليكون له معنى، ويُنقذ ذاته من النسيان؟ لا أميل اللحظة إلى أي عدمية حيث “تفقد القيم الأكثر سموّا قيمتها”، بل أود الشعور بالانتماء ولم لا التملك، تملّك المكان والزمان لتكون لي هوية تُشعرني بالوجود حتى وأنا في قعر العدم… كيف بإرادتي الحرة يمكن أن أعطي معنى لمن فقد كل قيمة هنا وأن أُعيد تشكيل الأشياء بحرية وبحب.. أود أن أسمي الأشياء من حولي لأكون سيّد اللّيس، أليس الوجود – حتى لو كان عدما- حرب تسميات كما ألْهمنا نيتشه؟ كيف أسمي الحقيقة وأربّي الوهم وأرعاه لينهار السياق بين الأسطورة والتاريخ، بين الهُنا الذي كان يوما هناك، لينزاح قليلا ذلك الخيط الدقيق بين الوجود والعدم، بين الأولى والآخرة؟
يتحرر جسدي رويدا رويدا من المكان وأسر الزمان، يطير بعيدا مثل فراشة تتحرر من شرنقة دودة القز، لولا صرخة الألم والعيون الحزينة المتحلقة حول جثماني، لاعتقدْتُني في حلم، أيقنتُ أنني أسير نحو حتفي.. مثل صرخة الميلاد جاءتني الحشرجةُ الأخيرة، وَهَنُ جسدي يُضعف صرخة الألم في داخلي.. فللموت كثافة جليلة، لا تنفع معها محاولات مقاومة العزلة ولا ترويض الذاكرة على النسيان. وددت أن أخاطب الموت بلهجة ساخرة كما فعل شيشرون وهو يصرخ في طليقته ترنتيا: “اذهبي من هنا واحملي كل ما هو ملك لك”.
يمتاز أسلوب الكاتب بالجمع بين البساطة والعمق، ما يخلق توازنا فريدا بين الوضوح في التعبير والغموض الذي يُحفّز التفكير.. فاللغة المركبة تُتيح توصيل رسائل نقدية معقدة بأسلوب سلس. يُثير مشاعر الحنين في قلب القارئ، وهو يستحضر لحظات من الحياة التي يترابط فيها الإنسان مع وجوده رغم مواجهة الموت. وفي الوقت ذاته، ينمّي التمرد ضد الفناء، مُصورا الموت كعدو يتحدى روح الحياة. هذا التوتر بين الحنين إلى الماضي والتمرد على النهاية يجسد صراعا داخليا عميقا، ويُظهر أن الحياة، رغم تحدياتها، تحمل دائما بصيصا من الأمل الذي يمكنه مقاومة عتمة الفناء.
يمثل كتاب “لو يخجل الموت قليلاً” للمفكر عبد العزيز كوكاس، مرآة ثقافية تعكس صراع الإنسان مع مصيره المحتوم في عالم مليء بالتناقضات؛ عالم يمزج بين ألم الفراق وحلاوة الحياة. من خلال لغة نقدية متماسكة وأسلوب شعري مبدع، يدعو الكتاب القارئ إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للموت والحياة، ويقدم نقدا ثقافيا عميقا للمجتمع الذي يجد نفسه متأرجحا بين اليأس والأمل. بهذا يكون النص قد نجح في استنهاض مشاعر الإنسان واستحضار قدرته على المقاومة والبحث عن ضوء يُنير طريقه في عتمة الفناء.
———————
كتاب “لو يخجل الموت قليلا” أغنية للغائبين للكاتب المغربي عبد العزيز كوكاس (منشورات النورس) دار القلم، الطبعة الأولى يناير 2025


















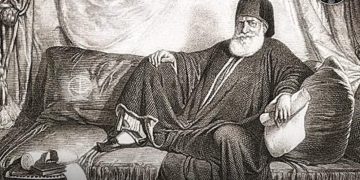




















Discussion about this post